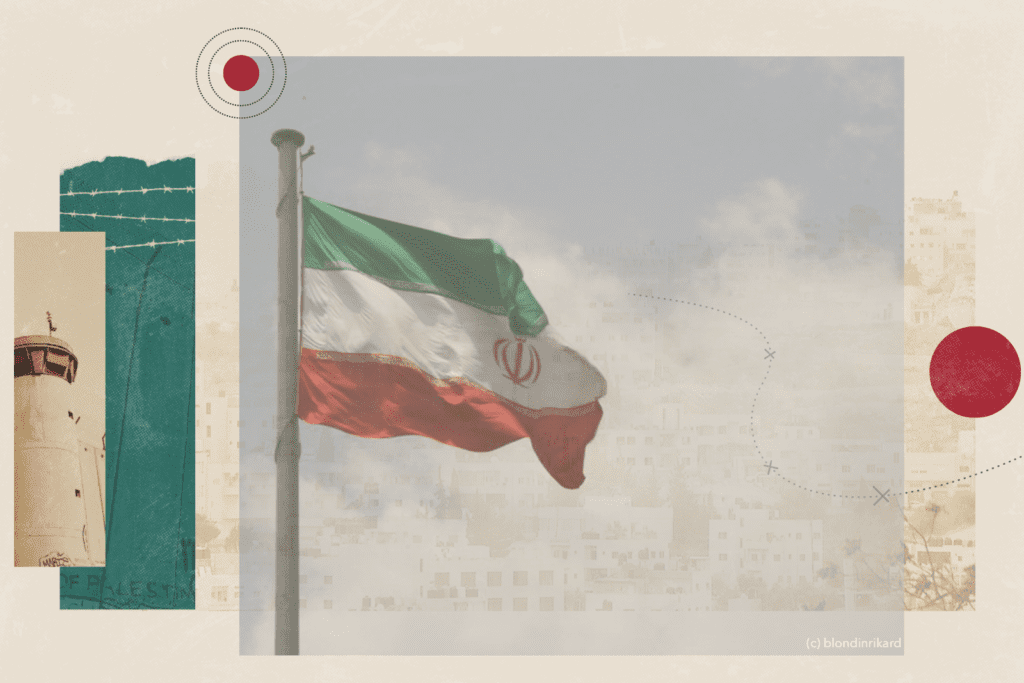لمحة عامة
يستدعي عدوان الواحد والخمسين يومًا على غزة جهودًا مضاعفة للتخلص من نظام السيطرة الذي وضعته إسرائيل بعناية لتتحكم بحياة الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة ولإحراز الحقوق الفلسطينية. وكخطوةٍ أولى ضرورية في هذا الاتجاه، لا بد من التصدي للجهود المدعومة من المانحين والرامية إلى خلق قوى أمنية فلسطينية تخدم في المقام الأول طموحات إسرائيل الاستعمارية. وهذه خطوةٌ تزداد إلحاحًا مع نية السلطة الفلسطينية العودة إلى غزة في أعقاب إبرام اتفاق الوحدة والمصالحة.1
يتناول مدير برامج الشبكة، علاء الترتير، والعضوة السياساتية في الشبكة، صابرين عمرو، هذه الأسئلة بالنظر في حالة قطاع الأمن الراهنة من حيث نشأته وغاياته، وفي السلطوية المتنامية باطراد والتي تحول فلسطين إلى “دولة” أمنية بوليسية. وفي حين يُعرِّج الكاتبان على القطاع الأمني في غزة، فإنهما يرّكزان في المقام الأول على تطوره في الضفة الغربية المحتلة. ويحثان على الطعن في أسس إصلاح القطاع الأمني الحالية كخطوة رئيسية نحو إعادة المسعى الفلسطيني من أجل الحرية والعدالة والمساواة وتقرير المصير إلى مساره الصحيح.
قطاع مزدهر
نمى قطاع الأمن في العقد الماضي أسرعَ من أي مكوِّن آخر في السلطة الفلسطينية، حيث بات القطاع الأمني يتصدر القطاعات الأخرى بعدد موظفيه العموميين بنسبة %44 من مجموع موظفي الخدمة المدنية البالغ 145,000، إضافةً إلى العدد المتزايد من المعاهد والبرامج الجامعية المتخصصة في “العلوم الأمنية،” بما فيها المركز الفلسطيني لدراسات القطاع الأمني في أريحا الذي يُعتبر “الأرقى” في الضفة الغربية، وآلاف الطلبة الفلسطينيين الذين يسافرون إلى الخارج لتلقي تدريبات أمنية “عالمية المستوى.”
يستأثر قطاع الأمن بحصة الأسد من موازنة السلطة الفلسطينية، بمليار دولار أمريكي تقريبًا أو %26 من موازنة عام 2013، مقارنة بنسب لا تتجاوز %16 للتعليم، و%9 للصحة، و%1 فقط لقطاع الزراعة الذي ظل تاريخيًا أحد أبواب الرزق الرئيسية للفلسطينيين. يتلقى قطاع الأمن أيضًا مساعدات دولية كبيرة، حيث ضخت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكندا في عام 2013 وحده ملايين الدولارات فيما يسمى مجازًا إصلاح قطاع الأمن. وفي الوقت الحاضر، بلغت نسبة عناصر الأمن لعدد السكان عنصرًا واحدًا لكل 52 فلسطينيًا مقارنةً بمدرِّس واحد لكل 75 فلسطينيًا. وكثيرًا ما تنشر الصحف اليومية إعلانات عطاءات لبناء سجون تابعة للسلطة الفلسطينية، حتى صارَ هناك 52 سجنًا جديدًا و8 مجمعات أمنية جديدة – فضلًا على معدات مكافحة الشغب.
ثمة مؤشرٌ آخر بارز يدل على الأهمية المتزايدة لقطاع الأمن ويتمثل في تعيين أفراد من الأمن في مناصب قيادية والبلديات والمحافظات والمراكز الحساسة سياسيًا. فعلى سبيل المثال، كان رئيس المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، عضوًا في فريق المفاوضين الفلسطينيين في المفاوضات الأخيرة مع إسرائيل. وبالرغم من أن رؤساء القوات الأمنية من أمثال جبريل الرجوب ومحمد دحلان كانوا أصحاب نفوذ في الماضي (وقد يعودون كذلك في المستقبل)، فإن الفرقَ هذه المرة يكمن في تصوير ذلك كجزءٍ من عملية بناء الدولة الحديثة.
ومن نافلة القول إن قطاع الأمن المتنامي بسرعة لا يوفر الأمن الفلسطيني، بل يعمل كما أرادت إسرائيل منذ البداية كأداةٍ للسيطرة على الفلسطينيين وترويضهم في المنطقة الخاضعة مباشرةً للسلطة الفلسطينية (المنطقة (أ) وفقًا لاتفاقات أوسلو) وفي المنطقة (ب) التي تسيطر عليها بالاشتراك مع إسرائيل. ففي هاتين المنطقتين، تكبح قوات الأمن الفلسطينية جماح المظاهرات وتعتقل الناشطين، وتنزع بالقوة سلاح الأجنحة المسلحة للأحزاب السياسية، وتعذِّب المسلحين والناشطين السياسيين. وفي الوقت نفسه، وصل التعاون الأمني مع إسرائيل إلى مستويات غير مسبوقة، كما سيأتي تفصيله أدناه، بينما تتصرف إسرائيل بمطلق الحرية في المنطقة (ج) الخاضعة لسيطرتها العسكرية والبالغة حوالي %60 من مساحة الضفة الغربية المحتلة.
تطور قطاع الأمن
تعود نشأة القطاع الأمني الحالي في السلطة الفلسطينية إلى إعلان مبادئ أوسلو لعام 1993 والذي تنص المادة الثامنة منه على استحداث “قوة شرطة قوية” للفلسطينيين بينما تكون إسرائيل مسؤولةً عن “التهديدات الخارجية” وضمان “الأمن الإجمالي للإسرائيليين.” ويرد ذلك بتفصيل أكثر في الملحق الأول من الاتفاق الانتقالي (أوسلو الثانية) لسنة 1995، حيث يوجد بروتوكول للعمليات الأمنية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة، وبيان للمواصفات الإسرائيلية من حيث حجم القوة وعدد أسلحتها ونوعها وآلية تسجيلها. وبعبارة أخرى، كان من المنتظر في اتفاقات أوسلو أن تلعب السلطة الفلسطينية دور المقاول الفرعي التابع لإسرائيل.
ومن المفارقات أن “قوة الشرطة القوية” كانت سببًا في اشتداد العنف إبان الانتفاضة الثانية وفي قيام إسرائيل بتضييق الخناق على الشرطة الفلسطينية ومؤسسات حكومية أخرى. ففي العام 2002، وفي ذروة الانتفاضة الثانية وإبان الاجتياح الإسرائيلي لمدنٍ فلسطينية، سلَّطَ الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل آرييل شارون الضوءَ على العناصر الأمنية في خريطة الطريق للسلام التي أطلقتها اللجنة الرباعية في وقت لاحق من العام 2003. وأعلن بوش في عام 2002 أن “الولايات المتحدة لن تدعم قيام دولة فلسطينية حتى يشن قادتها معركةً مستمرة ضد الإرهابيين ويفككوا بنيتهم التحتية. وهذا سوف يتطلب جهدًا تشرف عليه جهات خارجية لإعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية وإصلاحها.” وهكذا تحوَّل تقرير المصير للفلسطينيين من حق إلى امتياز يتعيَّن على السلطة أن تبرهن أنها تستحقه.
رسَّخت خارطة الطريق التحول في استراتيجية السلطة الفلسطينية المتبعة في إقامة الدولة من الكفاح لتقرير المصير إلى امتلاك قطاع أمني يخضع نظريًا “لمبادئ الحكم الديمقراطي وسيادة القانون” ولكنه في الواقع يخدم إسرائيل. طالبت المرحلة الأولى من خريطة الطريق السلطةَ الفلسطينية أن تبذل “جهودًا ملموسة” لاعتقال الأفراد والجماعات الذين “يشنون ويخططون لهجمات عنيفة ضد الإسرائيليين في أي مكان.” وتضمنت الشروط المفروضة على قطاع الأمن الفلسطيني مكافحةَ الإرهاب، وإلقاء القبض على المشتبه بهم، وحظر التحريض، وجمعَ كل الأسلحة غير المشروعة، وتزويد إسرائيل بقائمة أسماء منتسبي الشرطة الفلسطينية، ورفع تقرير مرحلي إلى الولايات المتحدة. وهكذا فإن تطور القطاع الأمني الفلسطيني لم يكن سوى “عملية تتحكم بها جهات خارجية،” ولا يخفى أنها “مدفوعة باعتبارات مصالح الأمن القومي الإسرائيلي والأمريكي.”2
وفي الوقت نفسه، تجدر الملاحظة أن السلطة الفلسطينية بقيادة عباس، الذي كان رئيس الوزراء ثم الرئيس منذ 2005، كان لها أسبابها الخاصة لاعتماد هذا الإطار. فقد تمنى عباس أن يحتكر استخدام القوة، ويعزز قيادته بعد توليه مقاليد الحكم خلفًا للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ويحمي النخب الفلسطينية، كما أشار إلى هذا مستشار الشبكة السياساتي طارق دعنا في مقالة نُشرت مؤخرًا. وعلاوةً على ذلك، كان للسلطة الفلسطينية مصلحة في تضييق الخناق على الأحزاب الإسلامية وأحزاب المعارضة الأخرى في الضفة الغربية، ولا سيما في أعقاب فوز حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية سنة 2006 والانقسام بين فتح وحماس منذ 2007. وبعدما أصبح سلام فياض رئيسًا للوزراء في العام 2007، اكتسبت جهود صناعة التنمية الرامية لإعادة تكوين قوات الأمن الفلسطينية زخمًا، وكلّه باسم مشروع بناء الدولة.
وعلى الرغم من انتهاكات السلطة الفلسطينية الواضحة والمتزايدة لسيادة القانون، استمرت الجهات المانحة الدولية والسلطة الفلسطينية نفسها في الترويج لإصلاح القطاع الأمني على أنه يستهدف إقامة العدل بفاعلية ونزاهة وإلى حماية حقوق الإنسان.3 غير أن سيادة القانون في ظل الاحتلال العسكري وكما تعّرف حالياً مضيعة للوقت. فقد اعترف أحد الدبلوماسيين الغربيين المشاركين في التدريب الأمني في سياق تقريرٍ نشرته مجموعة الأزمات الدولية بهذا الشأن: “إن معيار النجاح الرئيسي هو رضا إسرائيل. فإذا قال لنا الإسرائيليون إن الأمر يسير كما يُرام، فإننا نعتبره نجاحًا.”
لا تنبري هذه الورقة السياساتية لمناقشة قطاع الأمن في غزة، ولكن تجدر الإشارة إلى التشابهات بين السلطة الفلسطينية في رام الله بقيادة فتح وبين سلطة حماس في غزة. فمن موظفي الخدمة المدنية العاملين في سلطة حماس والبالغ عددهم 23,000، هناك 15,500 يعملون في القطاع الأمني. وتمامًا كما تحافظ السلطة الفلسطينية على مقاليد الحكم في الضفة الغربية عن طريق تخويف وإرهاب الجماعات المسلحة الأخرى، فإن حماس تفعل ذلك في غزة. ومن الأمثلة، أفادت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في رام الله بأنها تلقت 3,185 شكوى على خلفية انتهاكات ارتكبتها الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية في عام 2012، منها 2,373 شكوى من الضفة الغربية و812 من قطاع غزة. ولم يتبين بعد كيف أن مجيء حكومة الوفاق الوطني إلى غزة سوف يؤثر في قطاعها الأمني.
سَعت حماس، ضمن جهودها لاستدامة سيطرتها على قطاع غزة، إلى تثبيت اتفاقات وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وهكذا، ومن باب المفارقة، صارت حماس الضامن الأفضل لأمن إسرائيل منذ فرض الحصار الإسرائيلي الصارم على قطاع غزة في العام 2006 – رغم أن تنسيق حماس مع إسرائيل، كما يشير المحلل المخضرم معين رباني، يختلف عن تنسيق فتح بكونه “غير رسمي، وجدلًا تكتيكي.” وقد اعترف المحللون الإسرائيليون بقدرة حماس على تثبيت وقف إطلاق النار مع إسرائيل رغم أن ذلك لم يمنع إسرائيل من شن هجمات مدمرة على نحو متزايد على غزة بُغية “جز العشب” وهي كناية يستخدمونها لوصف النهج المدمر الذي تتبعه إسرائيل في تعاملها مع غزة.
القمع من دولة بوليسية قيد الإنشاء
تمخض إصلاح القطاع الأمني لغاية الآن عن تعزيز استبداد السلطة الفلسطينية إلى درجة غير مسبوقة. يقول ناثان براون بشأن السياق الاستبدادي لإصلاح القطاع الأمني: “لا يقوم البرنامج برمته على تهوين مسألة الديمقراطية وحقوق الإنسان وتأجيلها وحسب، بل وعلى حرمان الفلسطينيين منها في الوقت الحاضر.” ويخلص يزيد صايغ إلى أن إصلاح القطاع الأمني أدى إلى حدوث تحول استبدادي يهدد الأمن على المدى البعيد، وكذلك القدرة على إقامة الدولة الفلسطينية. وبالتالي فإن كُتِب لدولة فلسطينية أن تقوم، فستكون على الأرجح دولةً بوليسية على غرار معظم الدول والأنظمة العربية الأخرى.
وبالنظر إلى ما يكابده سكان الضفة الغربية المحتلة في عهد السلطة الفلسطينية اليوم، فإن هذه السلطة باتت، بالنسبة للكثيرين، دولةً بوليسية يتعاملون فيها مع مستويات متعددة من الظلم الذي تمارسه إسرائيل والسلطة الفلسطينية على حد سواء. وهذا ينعكس في التباين والفجوة بين السلطة الفلسطينية والشعب من حيث اللغة المستخدمة، فالسلطة الفلسطينية تسمي العمل المشترك مع إسرائيل “تنسيقًا” بينما يسميه الشعب “تعاونًا” بدلالته السلبية. ويتحدث بعض الفلسطينيين عن سياسة “الباب الدوار،” حيث يُخلى سبيل الأسرى من سجن سلطة ليزَج بهم في سجن السلطة الثانية. وفي هذا الصدد، يقول أحد اللاجئين من مخيم جنين في مقابلةٍ مع المؤلف: “اعتقلني جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية وأودعني السجن مدةَ تسعة أشهر بسبب انتمائي لحماس، وبعد الإفراج عني بثلاثة أسابيع، اعتقلتني إسرائيل واتهمتني بالتهم ذاتها، بل واستخدمت العبارات نفسها حرفيًا.”4
يُفسر مسؤولٌ رفيع المستوى في الأمن الوقائي الوضعَ القائم بعبارةٍ مختصرة: “تصلنا قوائم أسماء. [الإسرائيليون] يريدون شخصًا، ونحن نُكلَّف بجلب ذلك الشخص لهم.” ولسنوات ظل هذا هو النهج المتبع كما يبين التقرير التقييمي الذي أصدرته مجموعة الأزمات الدولية في 2010: “جهاز المخابرات العامة (الشاباك) يزوِّد نظيره الفلسطيني بقوائم أسماء مسلحين مطلوبين، ثم تقوم السلطات الفلسطينية باعتقالهم. [ويقول] ضباط الجيش والاستخبارات الإسرائيلية ’لم يسبق أن جرى التنسيق على نطاق أوسع من هذا أو على وجه أفضل كما في الوقت الحاضر.‘”
تمارس قوات أمن السلطة الفلسطينية القمعَ باستمرار وبأشكال مختلفة، وهناك أمثلةً تُظهر إلى أي مدى تصل قوات السلطة الفلسطينية في قمع المعارضة الشعبية. ففي منتصف عام 2012، انقضّت قوات أمن السلطة الفلسطينية على مسيرة سلمية في رام الله، وخلَّفت إصابات بين المتظاهرين حيث نُقِل خمسة إلى المستشفى، وقدَّم 18 منهم شكاوى. وكانت الإصابات التي تعرَّض لها أحد المتظاهرين وهو في عهدة الشرطة شديدةً لدرجة أن منظمة العفو الدولية وصفتها بأنها ترقى إلى حد التعذيب.
يفيد تقرير آخر أصدرته منظمة العفو الدولية سنة 2013 بأن وحشية الشرطة أفضت إلى مقتل فلسطينيين اثنين، أحدهما امرأة في الرابعة والأربعين من العمر حين أغارت الشرطة على إحدى القرى وألحقت إصابات بالغة بثمانية أشخاص وأثارت احتجاج مئات السكان المحليين واشتباكات مع قوات الأمن، والثاني قُتل في عملية منفصلة في مخيم عسكر للاجئين في نابلس. ووصف التقريرُ الوحشيةَ التي تمارسها قوات الأمن بأنها ” تبعث على الصدمة، حتى بمقاييس قوات أمن السلطة الفلسطينية.”
وفي ترداد صارخ لصدى المعاملة التي يتلقاها الفلسطينيون من القضاء الإسرائيلي في سعيهم لتأمين حقوقهم في الحياة والأرض والحرية، لم تتبين المحاكم الفلسطينية، بحسب تقرير أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش سنة 2013، “مسؤولية رجال أمن في الضفة الغربية عن أعمال تعذيب أو احتجاز تعسفي قط، أو المسؤولية عن وفيات غير قانونية رهن الاحتجاز […] ولم تلاحق السلطة الفلسطينية رجال أمن على ضربهم للمتظاهرين في رام الله يوم 28 أغسطس/آب.” وهذه هي الحال حتى عندما تكون هوية ضباط الشرطة معروفة. بل إن السلطات تتمادى أحيانًا وتذهب إلى حد مقاضاة الضحايا كما حدث بعد اعتداء الشرطة على ناشطين في نيسان/إبريل 2014. وفي الواقع، تمتلك قوات الأمن النفوذ لتسخير النظام القضائي لصالحها. وهذا يكشف حقيقة سيادة القانون في ظل برنامج إصلاح القطاع الأمني.
لا يقتصر القمع على المتظاهرين أو “المطلوبين،” أي المطلوبين لإسرائيل، حيث أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مؤخرًا أن قوات الأمن الفلسطينية في العام 2013 اعتقلت 723 شخصًا تعسفًا واستجوبت 1,137 شخصًا دون توجيه اتهامات واضحة أو إصدار قرارات قضائية أو مذكرات. واعتقلت قوات أمن السلطة الفلسطينية كذلك 56 شخصًا بسبب تعليقاتهم على الفيسبوك ضدها، واعتقلت 19 صحفيًا، وعددًا من رسامي الكاريكاتير والكتّاب. ووثق المرصد أيضًا 117 حالةً من التعذيب الشديد.
يتجلى التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في أوضح صوره في مخيمات الضفة الغربية للاجئين، حيث يفاقم عزلة أهالي المخيمات عن بقية المجتمع ويقضي على ما تبقى من جيوب المقاومة الفلسطينية المسلحة ويجرِّمها. وخير مثالٍ على ذلك هو المعاملة التي يتلقاها أهالي مخيم جنين. فبعد أن دمرت القوات الإسرائيلية جنين إبّان الانتفاضة الثانية رغم المقاومة البطولية، أخذت حكومة فياض والجهات المانحة الدولية وإسرائيل تستعملها منذ 2007 كمحافظة تجريبية لتعزيز سيادة القانون. وتحت ستار “عملية الأمل والابتسامة،” كُلِّفت قوات السلطة الفلسطينية باجتثاث أي مصدر “للإرهاب وعدم الاستقرار” من المخيم.
لا يزال قمع جنين مستمرًا إلى يومنا هذا. وعلى سبيل المثال، أغار الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن الفلسطينية بين آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر عام 2013، وهي فترة انعقاد المحادثات برعاية وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، أكثر من 15 غارةً على مخيم جنين للاجئين (انظر تقرير وكالة معًا الإخبارية كمثال). وفي شهر آذار/مارس 2014، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مخيم جنين واغتالت ثلاثة أشخاص وأصابت 14 آخرين على الأقل. وزُعِمَ أن أجهزة الأمن الفلسطينية العاملة في المنطقة أُمرت بالتزام مواقعها قبل الغارة. واعتادت قوات الأمن الفلسطينية كذلك على تخويف وإرهاب الفلسطينيين الذين يجرؤون على انتقاد تصرفاتها أو تصرفات مسؤولي السلطة الفلسطينية، كما حدث حين اعتدى عناصر الأمن الفلسطيني وحراس محافظ جنين في أيار/مايو 2014 بوحشية على مدني فلسطيني عندما سمعوا صدفةً تعليقه الساخر بشأن مرور موكب المحافظ عبر المدينة.
تُظهر تجربة جنين أن السلطة الفلسطينية تتعامل مع المقاومة المسلحة، التي كانت ذات يومٍ جزءًا لا يتجزأ من النضال الفلسطيني من أجل تقرير المصير، باعتبارها شكلًا من أشكال المعارضة التي لا ينبغي ضبطها ومراقبتها وحسب وإنما القضاء عليها وتجريمها. وهكذا، فإن من أهداف عملية إصلاح القطاع الأمني أن تجرِّمَ المقاومة ضد الاحتلال وتترك إسرائيل – وتابعيها الموثوقين – ليكونوا الوحيدين القادرين على رفع السلاح في وجه شعب أعزل.
إن نجاح عملية إصلاح القطاع الأمني، التي تؤطرها الولايات المتحدة وإسرائيل وتنفذها السلطة الفلسطينية، يتوقف على مدى تهيئة قوات الأمن الفلسطينية لكي تكيِّف نفسها. ويتجلى هذا التكييف الذاتي بوضوح على مختلف المستويات بدءًا بكبار المسؤولين الحكوميين، حيث يعقد عباس اجتماعات دورية مع قوات الأمن ويأمرها مرارًا وتكرارًا بأن تحكم بقبضة من حديد. وذهب المتحدث باسم قوات الأمن الفلسطينية، عدنان الضميري، إلى حد القول إن قوات الأمن صنعت معجزةً أمنية، وإن الضفة الغربية باتت أكثر أمنًا من المدن الإسرائيلية.
يثير الشباب الفلسطينيون المتدربون في قوات الأمن القلق أكثر حين يكشفون عن هذا التكييف الذاتي. يقول طالب من الأكاديمية التركية معترفًا: “إنها فوضى، ولكن علينا أن نثبت أننا قادرون على ذلك. وعندما نحصل على دولتنا، فبإمكاننا أن نديرها على النحو الذي ينفعنا.” وهكذا، فإن الشباب الفلسطينيين الملتحقين بصفوف قوات الأمن لربما يجسدون الازدواجيةً في أوضح صورها، فهم الخاضعون للاحتلال والمتعاونون معه. وعندما تكون قرابة نصف فرص العمل المتاحة في القطاع العام الفلسطيني مخصصةً للقطاع الأمني، فإن القرار يكاد يكون قد اتُخذ بالنيابة عن هؤلاء الشباب الفلسطينيين الباحثين عن عمل.
بالرغم من الاتفاق على عدم السماح قطعًا بدخول الإسرائيليين إلى المنطقة (أ)، اعترفت مجموعة من ضباط الشرطة في رام الله بأنهم حين يدخلون، “يتصلون بنا، ويأمرنا رؤساؤنا أن نضع أسلحتنا وندخل لمقراتنا. ولا يُسمح لنا حتى بالتواجد في الطرقات ولا في سيارات الشرطة إذا ما قرروا المجيء بقصد التوغل. وإذا قالوا اختفوا، فإننا نختفي. مَن سيوقفهم؟ لا أحد.”
لاحظَ العديد من المحللين أثر ذلك التكييف الذاتي، مثل أستاذ القانون عاصم خليل الذي يشير إلى أن التنسيق الأمني في حد ذاته هو شكلٌ من أشكال التكييف: “لم يعد النضال الفلسطيني معنيًا بتقرير المصير – بل بالسمعة الدولية وبإثبات أنك تستحق إدارة دولتك، والتنسيق هو شكلٌ من أشكال الانضباط الذي تشترطه الجهات المانحة الدولية وسلطة الاستعمار من أجل قيام الدولة الفلسطينية المستقبلية.” وتحاجج العالِمة السياسية، ماندي تيرنر، بأن مشروع بناء الدولة هو شكلٌ من أشكال مكافحة العصيان ولكنه يستغرق وقتًا طويلًا حتى يُثمر لأنه يقتضي تربية المستَعمَرين على تكييف أنفسهم لمواكبة المعايير التي تفرضها مبادئ النيوليبرالية.
دعوةٌ للفلسطينيين لإصلاح “الإصلاح”
تكشف “أوراق فلسطين” التي سربتها قناة الجزيرة، ومن ضمنها وثائق مفصلة من الاجتماعات الإسرائيلية الفلسطينية المنعقدة في أنابوليس عام 2008، أن القادة الفلسطينيين كانوا يعتقدون إلى حدٍ ما أنهم إذا نفذوا كل ما تطلبه منهم الجهات المانحة من حيث الأمن فإنهم سيحصلون على دولة (انظر، مثلًا، صائب عريقات). غير أن الفلسطينيين اليوم هم أبعد من أي وقت مضى من الحصول على دولة. وعلاوةً على ذلك، قطعَ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أخيرًا الشكَّ باليقين إبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف 2014 عندما قال إن إسرائيل لن تتنازل عن السيطرة الأمنية غرب نهر الأردن. وانكشف زيف الخرافة القائلة بأن ملايين الدولارات التي ضخها المانحون في القطاع الأمني الفلسطيني سوف تخدم مشروع بناء الدولة.
إن عملية إصلاح القطاع الأمني، كما يجري تنفيذها في الأرض الفلسطينية المحتلة، تشوه النضال الوطني وأولوياته بهدف تعطيل قدرة الشعب الفلسطيني على مقاومة القهر الاستعماري. وهي تحجب قوات الاحتلال الإسرائيلية عن أنظار الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال، وتساهم في خلق نخبة جديدة من الممارسين الأمنيين الذين يسيئون استعمال سلطاتهم ويُنزلون بالمدنيين الفلسطينيين ما يلقونه من إهانة من القوات الإسرائيلية.
السؤال الآن هو ما تأثير العدوان الذي شنته إسرائيل على غزة على مدار واحدٍ وخمسين يومًا هذا الصيف على القطاع الأمني في الأرض الفلسطينية المحتلة؟ لم يبدُ أنه تغير الكثير قبل بدء العدوان، فقد بدأت إسرائيل عمليتها في غزة مباشرةً عقب حملة التضييق التي نفذتها في الضفة الغربية في حزيران/يونيو 2014، والتي شهدت قيام السلطة الفلسطينية بشنّ حملة تضييق مكثفة على المحتجين الفلسطينيين بالتوازي مع القوات الإسرائيلية وبمفردها. ثم سرعان ما لعب عباس ورقة القومية للاستجابة للغضب الفلسطيني والعالمي إزاء العدوان على غزة، وشاركت جميع الفصائل في الوفد الفلسطيني المفاوض على وقف إطلاق النار في القاهرة. ولكن بعد انتهاء العدوان، عادت فتح وحماس إلى تبادل الاتهامات، بيد أن اتفاقهما في نهاية أيلول/سبتمبر على السماح لحكومة التوافق الوطني بالعمل في قطاع غزة قد يُنجِح العلاقة. ولكن من المبكر الآن الحكمُ على تأثير العدوان في قطاع الأمن سواء في غزة أو الضفة الغربية.
وبغض النظر عن ذلك، يظل الإصلاح الأمني تحت الاحتلال معيبًا من أساسه، فكلما استثمرت السلطة الفلسطينية في الإصلاح الأمني، رسَّخت الاحتلال وصارت مضطرةً أكثر للعمل كمقاول فرعي وتابع لإسرائيل. فهناك حاجةٌ ملحة إذن لنبذ نموذج التنمية القائم على العنصر الأمني، المشيَّد في عهد عباس والمعزز في عهد فياض، وينبغي عوضًا عنه أن تُلبى احتياجات التنمية الحقيقية في الأرض الفلسطينية المحتلة. إن ارتفاع عدد الأسر التي تتلقى مساعدات مالية من 30,000 أسرة إلى 100,000 بين عامي 2007 و2010 لهو دليلٌ آخر على أن حجج السلطة الفلسطينية بأن تحسن الظروف الأمنية سوف يؤدي إلى تحسن الظروف الاقتصادية هي حجج فارغة.
وفيما يلي أربع توصيات نرفعها للمجتمع المدني الفلسطيني وداعميه في فلسطين وخارجها لكي يبدأوا العمل الذي لا بد منه لإصلاح “إصلاح القطاع الأمني.”
أولًا وأهم شيء، ينبغي لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني أن تستخدم وسائل الإعلام والمنتديات العامة وغيرها من وسائل التواصل من أجل تغيير الخطاب ورفض تجريم المقاومة ضد الاحتلال. فجميع الرازحين تحت الاحتلال لهم الحقُّ في مقاومته، سواء بالتظاهر أو بالكلمة أو بالكتابة أو بالدفاع لصد الهجمات المسلحة. فتجريم مقاومة المحتل هو الجريمة بعينها.
ثانيًا، يحتاج المجتمع المدني لتسخير جميع إبداعاته لإيجاد السبل اللازمة لإرساء الضوابط والموازين. إن نجاح الإصلاح الأمني يكمن في المساءلة والملكية العامة، وكلاهما مفقود في السياق الفلسطيني بسبب غياب الضوابط والموازين والرقابة المستقلة الفلسطينية، ناهيك عن الاحتلال الإسرائيلي الشامل. يزعم مسؤولو السلطة الفلسطينية أنهم “ملتزمون بالمعايير الدولية”، ولكن من دون برلمان فاعل وديوان مظالم مستقل وجدوى من اللجوء إلى القضاء، فإن هذه العبارات تظل بلا معنى. وحتى تُستحدث الضوابط والموازين، سيظل إصلاح القطاع الأمني جزءًا من المشكلة وليس جزءًا من الحل.
ثالثًا، لا بد من الاستثمار في الفرص الاقتصادية البديلة لتمكين الناس من العيش ومواصلة النضال ضد مستويات القمع المتعددة كي لا يضطر الناس للعمل في القطاع الأمني المتضخم والقمعي.
وختامًا، جددت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها الأملَ لدى الفلسطينيين ومؤيديهم في فاعلية وسائل المقاومة الشعبية في مجابهة الظلم وإحراز الحقوق. ويمكن اتباع بعض مبادئها وممارساتها ضمن الجهود المبذولة للانعتاق من نير الدولة الأمنية البوليسية.
- تتوفر كافة إصدارات الشبكة باللغتين العربية والانجليزية (اضغط/ي هنا لمطالعة النص بالإنجليزية). لقراءة هذا النص باللغة الفرنسية، اضغط/ي هنا. تسعد الشبكة لتوفر هذه الترجمات وتشكر مدافعي حقوق الإنسان على هذا الجهد الدؤوب، وتؤكد على عدم مسؤوليتها عن أي اختلافات في المعنى في النص المترجم عن النص الأصلي.
- Hussein Agha and 24352, A Framework for a Palestinian National Security Doctrine (London, UK: Royal Institute for International Affairs/Chatham House, 2005).
- For more information, see Roland Friedrich and Arnold Luethold, Entry-Points to Palestinian Security Sector Reform (Switzerland: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces (DCAF), 2007).
- الاقتباسات مستمدة من مقابلات أجراها المؤلفان في رام الله وبيرزيت وبيت لحم ونابلس وجنين وأنقرة في الأعوام 2012 و2013 و2014، ما لم يرد خلاف ذلك.