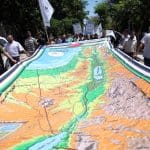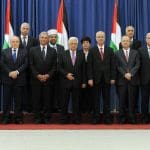لمحة عامة
استثمر مجتمع المانحين، منذ إعلان مبادئ أوسلو سنة 1993، ما يزيد على 23 مليار دولار في “السلام والتنمية” في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما يجعلها من أكثر المستفيدين من المعونة غير العسكرية في العالم من حيث نصيب الفرد. ومع ذلك، فإن المعونة لم تجلب السلام أو التنمية أو الأمن للشعب الفلسطيني، ناهيك عن العدالة. يتناول الكاتب الضيف على الشبكة، جيريمي وايلدمان، ومدير برامج الشبكة علاء الترتير جذور النموذج الراهن القائم على المعونة مقابل السلام، ويستعرضان آثاره على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ويجمعان الانتقادات الكثيرة الموجهة لنموذج أوسلو الاقتصادي.
يرى المؤلفان أن المانحين يعكفون على تعزيز أنماطٍ فاشلةٍ من الماضي ترتبط بنموذج “عوائد السلام”، بينما يُجرُونَ تغييرات تجميلية وحسب في مشاركتهم. بل لا يبدو أن المانحين مستعدون لتغيير هذا النهج الذي يهيمن عليه “الذرائعيون” في مجال السياسات الذين يتجاهلون ويرفضون النتائج التي لا تطابق قيمهم المحددة سلفًا بدلًا من التمسك بالقانون الدولي فيما بتعلق بالحقوق الفلسطينية ومبادئ التنمية الدولية التي تسعى جاهدة “لعدم الإضرار.” ويُبرز الكاتبان احتماليةً مُقلِقةً تتمثل في أن نموذج أوسلو للمعونة ربما يخدم مصالح كثيرة جداً لدرجة أنه يتعذر تفكيكه، ويختمان بتقييم ما سيتطلبه التغيير.1
ابتكار نموذج أوسلو الاقتصادي
وضع البنك الدولي في عام 1993، بُعيد توقيع اتفاق أوسلو الأول، خطةً اقتصادية للفلسطينيين تحت مسمى “استثمارٌ في السلام“. وكان الهدف منها إرشاد المانحين الثنائيين الرئيسيين حول سُبل صرف المعونة بما يدعم عملية السلام.2 وسعت الخطة لتحقيق ذلك بواسطة بناء المؤسسات، وتشجيع الأسواق المفتوحة والحرة، والتجارة، والاستثمار، والتحرير المالي، والنهوض بالحكم الرشيد، والتكامل الاقتصادي الإقليمي. وشجعت كذلك على التكامل الاقتصادي مع إسرائيل، بينما كان يُفترَض بها أن تهيئ الفلسطينيين للاستقلال.3 وبالإضافة إلى ذلك، أُنشئت سلطةٌ فلسطينية شبه مستقلة لتتولى ضبط الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة بدلًا من الجيش الإسرائيلي.
وكان من “النجاحات” الرئيسية للخطة توثيق أواصر التكامل الاقتصادي مع إسرائيل، بدءًا بوضع بروتوكول باريس في 1994 كملحقٍ لاتفاقات أوسلو. أنشأ بروتوكول باريس اتحادًا جمركيًا تطبق بموجبه السلطة الفلسطينية سياسة إسرائيل التجارية والتعريفية، وتحتفظ بموجبه إسرائيل بالحقِّ في تغيير هذه السياسة دون أن يلزمها سوى إخطار السلطة الفلسطينية بتلك التغييرات. نظَّم البروتوكول أيضًا الضرائبَ والسياسة التجارية، وأسس لجنةً اقتصادية مشتركة لإدارة الاتفاق. وبموجب الغلاف الجمركي الذي أرساه البروتوكول، كان يتعين على كافة أشكال المعونة الأجنبية المتبرَع بها للفلسطينيين أن تمر عبر إسرائيل التي كان لها حرية الخيار في فرض الضرائب عليها.4 وقد قالها أحد المفاوضين الإسرائيليين المشاركين في تصميم البروتوكول إن البروتوكول “في الأساس قد شرعن الزواج القسري بين الاقتصادين منذ 1967.”
خطة “استثمار في السلام” هي سياسةٌ نيوليبرالية تُماثل غيرها من البرامج التي وضعتها المؤسسات المالية الدولية للعالم النامي في عقد التسعينيات من القرن الماضي. وبناءً على المعرفة المسلَّم بها في إجماع واشنطن وإجماع ما بعد واشنطن، فإنها تجاهلت حقيقةَ أن الأرض الفلسطينية ترزح تحت وطأة احتلال عسكري طويل الأمد أعطى النيوليبرالية في الأرض الفلسطينية المحتلة خصوصيتها و”نكهتها.” وكانت فلسفة خطة البنك الدولي تتمثل في تحسين مستوى حياة الفلسطينيين وتشجيعهم على المشاركة في عملية السلام بالاستفادة من “عوائد السلام.”5 ولم تتغير هذه الفلسفة إلى اليوم: استثمر المزيد من المال لإشعار الفلسطينين بالتحسن اقتصاديًا لكي يهون عليهم تقديم التنازلات السياسية.
وفي المحصلة، بات الفلسطينيون في الأرض الفلسطينية المحتلة من أكثر متلقي المعونة غير العسكرية في العالم من حيث نصيب الفرد، حيث بلغ مجموع المعونة الدولية الممنوحة للفلسطينيين حوالي 22.7 مليار دولار بين عامي 1993 و2011، وبمتوسط 360 دولارًا للفرد سنويًا. ارتفعت تدفقات المعونة من معدلها السنوي البالغ 656 مليون دولار في الفترة 1993-2003 إلى ما يزيد على 1.9 مليار دولار منذ العام 2004. وتضاعفت المعونة الدولية 17 مرةً في الفترة 1993-2009، وتجاوزت المبالغ المصروفة في الفترة 2008-2012، أي في عهد رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض وحقبة الترسيخ المتنامي للنهج النيوليبرالي الذي بات يُعرف باسم “الفياضية،” مجموعَ مبالغ المعونة الواردة في الفترة 1994-2005. وفي ذروة تدفقات المعونة في عامي 2008-2009، حلَّت الأرض الفلسطينية المحتلة في المرتبة الثالثة بعد ليبريا وتيمور-ليشتي على قائمة متلقي المعونة بحسب نسبتها المئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
هل فشل امرئٍ هو نجاح امرئ آخر؟
إن خطة البنك الدولي للاستثمار في السلام التي سَنَّت طُرق صرف المعونة الخارجية للفلسطينيين على مدار العقدين الماضيين قد فشلت فشلًا ذريعًا حتى في تحقيق أهدافها المتمثلة في استدامة النمو الاقتصادي، وتعزيز السلام، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. ومع ذلك، لا يزال البنك الدولي يمارس نفوذًا هائلًا في عملية المعونة، ولا يزال يوصي باتباع السياسات نفسها رغم أن بعضها قد غدا غير عملي أكثر فأكثر مع مرور الوقت، ومنها على سبيل المثال تلك الواردة في تقرير النمو لعام 2012 الصادر عن البنك الدولي والذي نقدناه سابقًا.
لقد أضحى الفلسطينيون أسوأَ حالًا بكثير عمّا كانوا عليه في عام 1993 بحسب أي معيار اقتصادي أو سياسي. فوفقًا لتعريف الفقر بحسب الدخل، كان %50 من الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر في عام 2009 و2010، %38 في الضفة الغربية و%70 في غزة. وقد وجد برنامج الأغذية العالمي بأن %50 من الأسر الفلسطينية تعاني انعدام الأمن الغذائي. وظلت البطالة تُراوح معدل %30 منذ عام 2009، %47 في قطاع غزة عام 2010 و%20 في الضفة الغربية. ويثير معدل البطالة في أوساط الشباب الفلسطيني دون سن 30 عامًا القلق بوجه خاص إذ يبلغ %43. ولا تزال فجوة اللامساواة في الدخل والفرص في اتساع مستمر ليس بين الضفة الغربية وغزة وحسب وإنما داخل الضفة الغربية أيضًا. وما انفكت القدرات التصنيعية والإنتاجية تتراجع باستمرار.6 وفي الوقت نفسه، لا يزال قطاع الزراعة الذي كان ذات يومٍ محركَ الاقتصاد الفلسطيني يعاني التجاهل والإهمال، فمنذ تأسيس السلطة الفلسطينية وتنفيذ برامج المعونة المسترشدة بخطة “استثمار في السلام،” لم يتجاوز المبلغ المخصص للقطاع الزراعي نسبةَ %1 من إجمالي الموازنة السنوية للسلطة الفلسطينية في الفترة 2001-2005، وانخفضت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي من نحو %13.3 في 1994 إلى %5.9 في 2011. وعلاوةً على ذلك، صُرِفَ نحو %85 من هذه الموازنة الضئيلة كرواتب لموظفي وزارة الزراعة.
وقد تضاعَفَ الدين العام، في حين تضخمت الديون الشخصية بسبب سهولة الحصول على الائتمان. وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، كان النمو الاقتصادي المحتفى به البالغ %7.1 في 2008 و%7.4 في 2009 و%9.3 نموٌ بلا فرص عمل، مدفوعٌ بالمعونة، ولا يشمل القدس، وكان يعكس ببساطة صورةَ اقتصادٍ يتعافى من الحضيض. بل بات الفلسطينيون معتمدين كليًا على المعونة الخارجية في استدامة مناطقهم المعزولة في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي أصبحت سوقًا أسيرةً تعتمد على أموال المساعدات في شراء معظم احتياجاتها من إسرائيل.7 وعُزي التضخم الناجم عن معونة المنظمات غير الحكومية والديون الشخصية وغلاء المعيشية إلى تعثر عملية السلام – وهي عمليةٌ لم تشهد سوى التراجع المضطرد في مستوى حياة الفلسطينيين وانحسار تطلعاتهم إزاء تقرير المصير.
وعلى المستوى السياسي، فإن السلطة الفلسطينية، التي تُشرِف على وتتلقى نسبةٍ كبيرة من المعونة، تفتقر إلى السيادة القانونية والفعلية. وفي أعقاب أوسلو، تسارعَت وتيرة بناء المستوطنات الإسرائيلية ومصادرة الأراضي الفلسطينية تسارعًا ملحوظًا، وشُدِّدت سياسات الإغلاق الإسرائيلية التي تحد من دخول الفلسطينيين للعمل في إسرائيل أو التحرك بحرية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة والسفر إلى بقية أنحاء العالم، وهو من العوامل الأساسية التي أدت إلى التراجع الحاد في الاقتصاد الفلسطيني.8 وأسفرت الغارات اليومية الإسرائيلية المسلحة عن عشرات آلالاف من الفلسطينيين القتلى، والعاجزين بسبب الإعاقة، والمسجونين. ولا تزال المبالغ التي اقتطعتها إسرائيل من رواتب العمال الفلسطينيين وأجورهم في إسرائيل بين عامي 1970 و1993 – والبالغ مجموعها 16.5 مليار شيكل إسرائيلي – تعود بالنفع على الاقتصاد الإسرائيلي. أمّا السلطة الفلسطينية فهي عاجزةٌ عن المطالبة بحقوق هؤلاء العمال أو بالعائدات الضائعة على خزينتها.9 وخاتمة القول إن المعونة تُستخدَم حاليًا لاستدامة عملية السلام الفاشلة والاحتلال الإسرائيلي ذاته.
ليس غريبًا، إذن، أن يكون هناك توافقٌ عام في الأدبيات المنشورة على أن المعونة خذلت الشعب الفلسطيني. ومع ذلك، ثمة خلافٌ حول السبب وراء فشل المعونة وقد حددناه بأربعة مذاهب أو مجموعات.10 يمكن تسمية المذهب الأول بالمذهب “الذرائعي” وهو يرى بأن أساسيات خطة الاستثمار في السلام سليمةٌ، وأنه ينبغي المحافظة على هذا النموذج ولكنه يحتاج ببساطة إلى تطبيق أفضل. تميل المجموعة القائلة بهذا المذهب إلى تجميل طبيعة الاحتلال الإسرائيلي والاستعمار الاستيطاني للدولة الإسرائيلية. وهي تتجاهل السياسات الإسرائيلية الثابتة تجاه الأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني منذ زمن يسبق قيام دولة إسرائيل. وهي تُلقي أيضًا باللوم الكثير على السلطة الفلسطينية بسبب إخفاق المعونة في تحقيق النتائج.
تشمل هذه المجموعة باحثين في البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والعديد من الوكالات الحكومية المانحة الثنائية. يساعد النهج الذرائعي في تفسير السبب وراء عدم تغير نموذج الاستثمار في السلام المعتمد في 1993 بعد عقدين من الصراع والانهيار الاقتصادي. أما المجموعة الثانية، فهي مجموعة “الذرائعيين الناقدين” وهي تركز على الاحتلال باعتباره العقبة الرئيسية في طريق السلام والتنمية. ومع ذلك، تؤمن كلتا المجموعتين إيمانًا ذرائعيًا بقدرة السياسات على إحداث التغيير الإيجابي.
تضم المجموعة الثالثة منتقدي نموذج أوسلو المتبع في المعونة، وكثيرون منهم يؤكدون على أن نموذج المعونة في حد ذاته هو جزءٌ من الاحتلال لأنه مصممٌ ليقوِّض التنمية الفلسطينية ويعزز الاحتلال الإسرائيلي ويدعمه، بموازاة السياسات الإسرائيلية المطبقة منذ أيام النكبة 1948 وما قبلها.11 وبالنسبة للمنتقدين، فإن التنمية ليست السياسة الملائمة التي ينبغي تطبيقها، بل ينبغي مقاومة الهيمنة لأن الغرض المخفي من وراء المعونة الإنمائية في حالة فلسطين-إسرائيل إنما يرمي إلى تعزيز الاحتلال.
ثمة مجموعةٌ رابعة لا يُلتفت إليها في الغالب عند تحليل تأثير المعونة، وهي مجموعة المستعمرين الجدد الذين يؤمنون بنجاح أوجه المعونة الخارجية، ولا سيما في الضفة الغربية حيث جرى تسكين حدة المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي إلى حد كبير، في حين تحققت أهداف السياسة الإسرائيلية بدرجةٍ كبيرة. ولهذا المنظور نفوذٌ كبير، وبخاصة في الولايات المتحدة، حيث يُثبت فاعليته في الاصطفاف إلى جانب مصالح الحكومة الإسرائيلية ورسم ملامح سياسة المعونة الأمريكية تجاه الفلسطينيين. وعلى سبيل المثال، ما انفكت منظماتٌ من قبيل معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى تدعو منذ عقد الثمانينيات على الأقل إلى اتباع نهج في المعونة يوفر الحوافز الاقتصادية للفلسطينيين مقابل تخليهم عن حقوقهم.
يتسم المستعمرون الجدد بتأثيرهم الملحوظ، كما يوضِّح تقريرٌ صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس في يونيو/حزيران 2012 إذ أشار إلى أن المعونة المقدمة للفلسطينيين هدفت على مر السنين إلى دعم ثلاث أولويات أمريكية رئيسية على الأقل في مجال السياسات: مكافحة الإرهاب ضد إسرائيل، وتشجيع التعايش الفلسطيني السلمي مع إسرائيل بينما يجري إعداد الفلسطينيين للحكم الذاتي، وتلبية الاحتياجات الإنسانية للحيلولة دون تفاقم حالة عدم الاستقرار. وقد اتسعت النقطة الأولى لتشمل معارضة المسعى الفلسطيني الرامي إلى نيل الاعتراف بفلسطين كدولةٍ في الأمم المتحدة، ومعارضة أي مبادرة تسعى لزيادة الاعتراف الدولي خارج إطار “عملية السلام”.
وإذا ما حلَّلنا المعونة الخارجية للفلسطينيين من وجهة نظر الاستعمارية الجديدة، فإنها قد لا تكون فاشلةً على الإطلاق، بل قد تكون في الواقع قد نجحت نجاحًا باهرًا، فأهل الضفة الغربية باتوا مضبوطين ومطوَّعين على نحو متزايد تحت حكم السلطة الفلسطينية الخانعة، وغزة باتت مقفلةً ومحاصرةً بإحكام من جميع الجهات، والمقدسيون ما انفكوا يُضطرون إلى مغادرة مدينتهم. وهي تشجع الفلسطينيين على التخلي عن أي نوعٍ من مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وتُبقيهم ملآ البطون وتحت السيطرة، وتتيح لإسرائيل أن تقاطعهم ماليًا إذا ما قاوموا هذه العمليات. وفي الوقت نفسه، تبتلع إسرائيل الأرض الفلسطينية المحتلة دون أن تُضطر إلى تحمل تكاليف أولئك القاطنين تحت الاحتلال.12
أي مستقبلٍ لنموذج أوسلو؟
بالرغم من فشل نموذج أوسلو من حيث بلوغ التطلعات الوطنية الفلسطينية وإعمال الحقوق الكلية، كما أشرنا آنفًا، فإنه يخدم مصالح إسرائيل. وعندما يقترن نفوذ إسرائيل في الولايات المتحدة بالنظرة الذرائعية القائلة بأن المشكلة مع المعونة لا تكمن في النموذج وإنما في تطبيقه، يعني ذلك أن أوسلو قد تبقى لسنوات عديدة. وقد لمسنا في المقابلات التي أجريناها مع المراقبين المطلعين على سياسات المانحين في الأرض الفلسطينية المحتلة ما يعزز استنتاجنا هذا. وعلى سبيل المثال، أشار أحد منتقدي أوسلو من فلسطينيي الضفة الغربية إلى أنه بالرغم من استحداث برامج جديدة للمانحين “فإن هذه البرامج ترتبط مباشرة بالسلام والتطبيع، ولا سيما برامج الأوروبيين.” وأكد مراقبٌ آخر بأن ثمة ضغطًا يدفع باتجاه إقامة مشروعات مشتركة “تهدف إلى كسر مقاومة الفلسطينيين… وإخضاع الفلسطينيين للإسرائيليين.”13
وعلى صعيد الجهات المانحة، أشار أحد المانحين الرئيسيين إلى أنه لم يطرأ “تغيير محدد” في برامج الأرض الفلسطينية المحتلة بخلاف “التأكيد مجددًا على الأهمية الإقليمية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأهمية النهج [الذي نتبعه] لبناء الدولة الفلسطينية.” وذهبت جهةٌ مانحة رئيسية أخرى إلى حد القول إن النموذج الفلسطيني يمكن تصديره إلى العالم العربي، على اعتبار أن برامجها كانت “متطورةً جدًا” في الأرض الفلسطينية المحتلة.14
ومع ذلك وبالرغم من أن نهج المانحين لم يتغير جوهريًا، فإن المواقف الفلسطينية تجاه المعونة قد توترت وأصبحت تُردِّد على نحو متزايد وجهة النظر الناقدة للمعونة. فثمة غضبٌ متنام تجاه وكالات المعونة الدولية لم يعد مقتصرًا على دوائر النخبة وحسب بل انتقل إلى الشارع الفلسطيني الذي شَهد احتجاجات عديدة شملت احتجاجات جدية ضد بروتوكول باريس من قِبَل الحركات الشبابية، وحتى وصلت الأمور إلى أن بعض شخصيات السلطة الفلسطينية قامت بالاحتجاج أيضاً رغم أن معظمها ظل مقتصرًا على الصحف ووسائل الإعلام. وأُقيمت أيضًا احتجاجات ضد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي انصب عليها الغضب أثناء زيارة الرئيس باراك أوباما مؤخرًا، وكذلك ضد مكتب تنسيق دعم الشرطة الفلسطينية التابع للاتحاد اﻷوروبي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا).
ولسوء حظ المنتقدين المتطلعين إلى إحداث تغيير في نموذج المعونة – إن لم يتسنَ تغييره بالكامل – فإن الاحتجاجات لا تزال على هامش المناقشات وليس لها سوى تأثيرٍ ضئيل في السياسات. فقد أشارت إحدى الجهات المانحة المدركة للوضع إلى أن احتجاجات الفلسطينيين تقتصر على قضايا لا تتحدى حقًا أولئك المسيطرين، ولا تستهدف تصويب الاستراتيجيات داخليًا أو تجاه إسرائيل. وقالت، على سبيل المثال، إن الاحتجاجات الواسعة المركزة على الأوضاع الاقتصادية وعلى السجناء المضربين عن الطعام توضح في الواقع “استحياء السياسة الفلسطينية وأُفُقها المحدود.”15 وحالما تتخطى الاحتجاجاتُ الحدودَ المرسومةَ لها من القيادة المنقسمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن جماحها يُكبَح وتُعاد مجددًا إلى ضمن تلك الحدود.
وباختصار، لا شيء في ظل ضعف الاحتجاجات الجدية سيُجبر المانحين أو السلطة الفلسطينية أو إسرائيل على تغيير نهجهم. ولعل التحول الأبرز قد يكون في دور المانحين العرب الذين تدخلوا لدعم النموذج القائم، وربما فاقموه سوءًا بزيادة أوجه قصوره الهيكلية، مثل الاستثمار القطري الأخير في غزة. وتبدو مبادرة السلام الاقتصادي الذي أطلقها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مؤخرًا متماشيةً مع السياسة الأمريكية المعهودة المتمثلة في تمويل “عوائد السلام” للمساعدة في الحفاظ على هدوء الفلسطينيين وتوفير حوافز إضافية للمفاوضين الفلسطينيين للاستمرار في تقديم تنازلات. وتهدف هذه الخطة، التي تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار، إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %50 على مدار السنوات الثلاث المقبلة، الأمر الذي سوف يساهم في تهدئة الصراع. وإلى جانب خطة كيري هذه، هناك مبادرة “كسر الجمود” التي تضم نحو 300 رجل أعمال فلسطيني وإسرائيلي بهدف إطلاق موجة جديدة من التطبيع الاقتصادي.
البحث عن نموذج جديد للمعونة
قدَّم بعضُ مَن قابلناهم مقترحات لإحداث التغيير الذي يتحدى الاحتلال وانتهاكات الحقوق الفلسطينية. ومن تلك المقترحات تعزيزُ السلطة الفلسطينية لتتمكن من قيادة عملية التنمية بدلًا من أن تترك المانحين ليضعوا جدول الأعمال؛ وضمانُ أن المعونة لا تخلق التبعية أو تدعم الاحتلال؛ وإعادة توجيه المعونة من عمليات الإغاثة إلى التنمية؛ وزيادة مبلغ المعونة الذي يُنفق محليًا وخفض المبلغ العائد من الباطن إلى الجهات المانحة؛ وضمان أن المعونة لا تنتقص من التزامات إسرائيل باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال.
ومع ذلك، يريد العديد من منتقدي المعونة أن يذهبوا إلى ما هو أبعد من ذلك وأن يطعنوا في الإطار العام وأن يُصلحوا النموذج القائم إصلاحًا شاملًا. وبحسب هؤلاء، فإن السُبل إلى تحقيق فاعلية المعونة تشمل ما يلي:
- على المعونة أن تدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير وأن تُعينهم على مقاومة المشروع الاستعماري، وألا تدعم الاحتلال الإسرائيلي.
- وجود برنامجٍ سياسي واقتصادي وتنموي فلسطيني موحد هو أمر ضروري.
- على المعونة أن تمكِّن الفلسطينيين من تحدي سيطرة إسرائيل على الموارد والحدود، ويمكن لذلك أن ينطوي مثلًا على استغلال احتياطيات الغاز الواقعة قبالة شاطئ غزة والتي ما انفكت إسرائيل تحول دونها.
- هناك حاجةٌ لوقف الاعتماد على الولايات المتحدة من خلال الربط مع القوى الإقليمية والدولية الأخرى ومع المجتمع المدني العالمي.
- لا بد من توفر السيادة السياسية لضمان فاعلية المعونة؛ فالتخصيص الأفضل للمعونة أو زيادة الموارد في إطار علاقةٍ تبعية لن يغير شيئًا.
- ينبغي للجهات المانحة أن تؤيد مطالب الحركات الوطنية الفلسطينية مثل حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.16
ووفقًا لهذه الأصوات الناقدة، إذن، لا بد من تغيير نموذج التنمية حالًا من نموذجٍ يعتبر التنمية نهجًا تكنوقراطيًا غير سياسي و”محايد” إلى نموذجٍ يعترف بهياكل وديناميكيات القوة والعلاقات القائمة على الهيمنة الاستعمارية ويعيد صياغة عمليات التنمية في سياق النضال من أجل الحقوق والمقاومة والتحرر. وبعبارة موجزة، وكما قالها أحد منتقدي المعونة، “ما نحتاج إليه هو التخلص من أوسلو وكل ما يتصل بها.”
إن العمل من أجل التغيير موعدُه الآن، ولا سيما أن العديد من مشاريع المانحين ستتطلب التمديد وإعادة التمويل في 2013-2014. وينبغي أن يكون الفلسطينيون منظمين لكي يضعوا جدول الأعمال، وإلا فإن نهج صناعة المعونة سيظل كما هو، وستظل القاعدة العامة: “الولايات المتحدة تقرر، والبنك الدولي يقود، والاتحاد الأوروبي يدفع، والأمم المتحدة تُطعِم.”17
- عرض وايلدمان والترتير نتائج دراسةٍ متعمقة تستند إلى مقابلات شاملة مع المانحين ومنتقدي المعونة في حلقة عمل بعنوان “The Politics of Foreign Aid in the Arab Middle East: Have the Arab Uprisings Changed the Practice?” نظمتها جامعة نيويورك وكلية لندن للاقتصاد في فلورانسا بإيطاليا بتاريخ 28 حزيران/يونيو 2013. وقد عُرِضت الدراسة للنشر الأكاديمي بعنوان ” _Unwilling to Change, Determined to Fail: Donor Aid in Occupied Palestine in the aftermath of the Arab Uprisings_”
- World Bank (1993) _Developing the Occupied Territories: An Investment in Peace_, Washington. D.C
- Taghdisi-Rad, S. (2011) _The Political Economy of Aid in Palestine: Relief from Conflict or Development Delayed_, Routledge and LMEI, London, U.K.
- Toaldo. M. (2013) _Beyond the Paris Protocol: Reforming Israeli-Palestinian Economic Relations; Pivoting to Palestinian Economic Sovereignty_, The Middle East Peace Process Project, European Council on Foreign Relations, U.K.
- Le More, A. (2008) _International Assistance to the Palestinians after Oslo: Political Guilt, Wasted Money_, Routledge, U.K.
- Sara Roy foresaw this process in her _The Gaza Strip: The Political Economy of De-Development_ (1995), Institute for Palestine Studies, Washington. D.C.
- Hever, S. (2010) _The Political Economy of Israel’s Occupation: Repression Beyond Exploitation_, Pluto Press.
- Farsakh, L. (2002) “Palestinian Labor Flows to the Israeli Economy: A Finished Story?”, _Journal of Palestine Studies_, Vol. 32, No. 1 (Autumn 2002), pp. 13-27.
- استنادًا إلى أحدث [تقرير](http://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdb60d3_en.pdf) أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فإن السلطة الفلسطينية تخسر 300 مليون دولار سنويًا على الأقل من عوائد الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة التي [لا تحولها](http://www.theguardian.com/global-development/2013/sep/03/palestine-loses-300m-trade-taxes-israel) إسرائيل إلى الخزينة الفلسطينية.
- للاطلاع على نقاش أوفى حول المذاهب الأربعة، انظر دراستنا القادمة بعنوان ” _Unwilling to Change, DeterminedFailure: Donor Aid in Occupied Palestine in the aftermath of the Arab Uprisings_”
- Khalidi, R. and Samour, S. (2011) ‘Neoliberalism as Liberation: The Statehood Program and the Remaking of the Palestinian National Movement’, _Journal of Palestine Studies_, Vol. XL, No. 2, pp. 6–25; Khalidi, R. and Taghdisi-Rad, S., (2009) _The Economic Dimensions of Prolonged Occupation: Continuity and Change in Israeli Policy towards the Palestinian Economy_, UNCTAD, Geneva; Nakhleh, K. (2011) _Globalized Palestine: The National Sell-Out of a Homeland_, The RedSea Press, Inc. See also critiques by [Abdelnour](https://al-shabaka.org/unmasking-aid-after-palestine-papers) and [Tartir, Abdelnour and Bahour](https://al-shabaka.org/briefs/التغلب-على-الاتكالية،-وبناء-اقتصادٍ-م%D9%258) of Al-Shabaka.
- اعتمدت إسرائيل قبل عملية أوسلو، في عقد الثمانينيات، على الأردن وعلى المعونة الخارجية المتدفقة عبر الأردن للمساعدة في تحمل تلك التكاليف. “ومن وجهة النظر الإسرائيلية، فإن الدعم الاقتصادي الذي قدمه الأردن قد سهَّل على إسرائيل بسطَ سيطرتها على الأراضي، وهو أمرٌ لا يخلو من المفارقة.” Starr, J. (1989) _[Development Diplomacy: U.S. Economic Assistance to the West Bank and Gaza](http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/development-diplomacy-u.s.-economic-assistance-to-the-west-bank-and-gaza)_.
- مقابلات مع الكاتبين.
- مقابلات مع الكاتبين.
- مقابلات مع الكاتبين.
- مقابلات مع الكاتبين.
- Le More, A. (2005) Killing with Kindness: Funding the Demise of a Palestinian State’, _International Affairs_, 81(5), pp. 981–999, p. 995.
العضو السياساتي في الشبكة، جيريمي وايلدمان، يعمل باحثًا مشاركًا في قسم العلوم الاجتماعية والسياسية بجامعة باث، حيث يعكف حاليًا على البحث في سياسة المانحين تجاه الفلسطينيين. أتم دراسته في مرحلة الدكتوراه حول المساعدات الإنمائية الكندية والأجنبية للفلسطينيين، وتعاون في مشاريع بحثية حول التنمية والاقتصاد والمنظمات غير الحكومية في فلسطين. يمتلك جيريمي خبرةً واسعةً في العمل في قطاع المنظمات غير الحكومية الفلسطيني، حيث شارك في تأسيس مشروع الأمل وهو جمعيةٌ خيريةٌ مقرها نابلس تُعنى بتطوير الشباب الفلسطيني.
علاء الترتير، مستشار برامج لدى الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية، ومدير وباحث رئيسي في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. الترتير هو أيضاً زميل بحثي ومنسق أكاديمي في المعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية في جنيف، وزميل بحثي عالمي في معهد أبحاث السلام في أوسلو، وعضو مجلس أمناء مبادرة الإصلاح العربي. يحمل الترتير درجة الدكتوراة في دراسات التنمية الدولية من جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وهو محرر مشارك لكتاب فلسطين وحكم القوة: المقاومة المحلية مقابل الحوكمة الدولية (2019) ولكتاب الاقتصاد السياسي في فلسطين: منظورات نقدية مناهضة للاستعمار ومتعددة التخصصات (2021)، ولكتاب مقاومة الهيمنة في فلسطين: آليات وتقنيات للسيطرة والاستعمار والاستعمار الاستيطاني (2023). تابعوا الترتير على تويتر(@alaatartir)وطالعوا مؤلفاته على موقعه الإلكتروني www.alaatartir.com