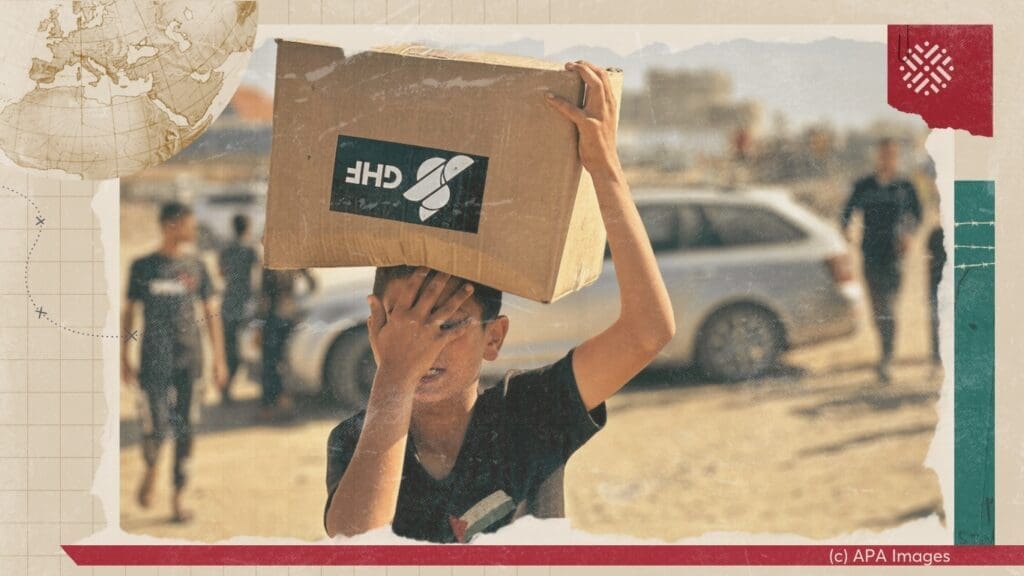لمحة عامة
ظلت السلطة الفلسطينية معوَّقةً منذ نشأتها إلى حدِّ كبير. فلم تنقل إليها إسرائيلُ الصلاحيات والموارد الضرورية للحكم، وإنما ألقت عليها أعباء الحكم. وفي حين أن الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية بمليارات الدولارات من أجل “التنمية” والبنية التحتية والإغاثة الإنسانية ودعم الميزانية لقي إشادةً كمسعى ناجحٍ في بناء المؤسسات، فإنه جلبَ ظروفًا اقتصاديةً واجتماعيةً وبيلة، وجعل السلطة الفلسطينية أشبه بمنظمةٍ غير حكومية باعتبارها كيانًا إداريًا يعمل على تيسير تنفيذ المشاريع بالغة الصغر المموَّلة من معونة المانحين – وحتى هذه المشاريع الصغيرة تتحكم فيها إسرائيل بأساليب غير معروفة لدى الكثيرين.1
مواضيع مرتبطة
يناقشُ العضو السياساتي في الشبكة إبراهيم الشقاقي والكاتبة الضيفة جوانا سبرينغر الفصلَ بين السياسة وبين التنمية الاقتصادية وكيف قادَ إلى الهوس بوصفات الكفاءة والحلول الفنية دون مراعاة السياق السياسي والمؤسسي، وهي مقاربةٌ يمكن أن نسميها الهوسَ بالتكنوقراطية. والأدهى هو أن هذا الفصل قد أضرَّ الرواية الفلسطينية الجماعية بشأن التحرير. فضلًا على أن سيطرة إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة وتأثيرها في تحديد سياسات معونة المانحين أجبرت السلطة الفلسطينية على اللجوء إلى أنشطةٍ اقتصادية “تتحاشى الاحتلال” وتحاول تخطي العقبات الإسرائيلية مع الالتزام بالقليل من المساءلة أمام الشعب الفلسطيني.
يقترح الشقاقي وسبرينغر توصيات سياساتية لمعالجة هذا الوضع، ومنها أن تُعيدَ السلطةُ الفلسطينيةُ النظرَ في جهودها المنصبّة على تنفيذ الوصفات الاقتصادية السائدة التي توصي بها المؤسسات المالية الدولية، وتبني سياسات تتصدى مباشرةً للظروف التي يوجِدها الاحتلال الإسرائيلي، وتقلل الاعتماد على إسرائيل تدريجيًا. ويحثُّ الكاتبان المانحين أيضًا على رفع يدهم عن وضع الأجندة من خلال تأثيرهم في السياسة الحكومية وفي القطاع غير الحكومي، وعلى الموازنةِ بين تقوية السلطة الفلسطينية وبين دعم التنظيم السياسي المستقل وتعبئة المجتمع المدني ونظم المساءلة الممأسسة بين السلطة الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين.
إصلاح الحكم رغم التخلي عن السيطرة
تَعتبر الدولُ المانحةُ الداعمةُ لموازنةِ السلطة الفلسطينية إصلاحاتَ الحكمِ المنفذةَ على مدى السنوات العشر الماضية نجاحًا باهرًا. وقد ساهم ذلك في حصول منظمة التحرير الفلسطينية على وضعٍ دبلوماسي أرفعَ أو اعترافٍ رسمي بدولتها في عدد من الدول المانحة في السنوات الأخيرة. غير أن نظرةً فاحصة تكشفُ أن إصلاحات الحكم تتحاشى مجالات سيادية رئيسية، ويرجع السبب الأكبر في ذلك إلى سيطرة إسرائيل على معظم جوانب الحياة الفلسطينية. ورغم النقاشات المستفيضة حول أوجه السيطرة الإسرائيلية، فإنه يجدر تلخيصها في هذه الورقة السياساتية، وهي تشمل السيطرة على:
- الموارد الطبيعية، بما فيها موارد المياه والمعادن.
- الموارد المالية الداخلية، بما فيها الإيرادات (ضريبة الاستيراد، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة البترول) التي تبلغ ثلثي إجمالي إيرادات السلطة الفلسطينية، وشكَّلت 40% من حجم الإنفاق في 2013، وقد دأبت إسرائيل على استخدامها كورقةِ ضغطٍ سياسية.
- الحدود الخارجية. المواد الأولية والآلات كافة يجب أن تخضع للتفتيش من الجانب الإسرائيلي. 2
- السياسات الاقتصادية: تتحدد السياسة النقدية إلى حدٍ كبير في البنك المركزي الإسرائيلي بما يتماشى والاحتياجات والأولويات الاقتصادية الإسرائيلية، دون مراعاة المؤشرات والأهداف الاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويضرُّ ارتفاعُ سعرِ صرفِ الشيكل الإسرائيلي ارتفاعًا مبالغًا فيه الصادراتِ الفلسطينيةَ، ويُنفِّرُ الاستثمارات من قطاعات رئيسية مثل التصنيع والزراعة والتي يمكن توجيهها نحو التصدير.3
حتى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي شدَّدا مؤخرًا على ضرورةِ أن يتولى الفلسطينيون زمامَ السيطرة في إقامةِ اقتصادٍ قابلٍ للحياة ودولةٍ مستقبلية. وبما أن إسرائيل تتحكم فيما ينبغي أن ينضوي تحت سيادةِ الحكومة الوطنية في الدولة المستقلة، ركَّزت إصلاحات الحكم ونهج السلطة الفلسطينية الإنمائي على اعتبارات تكنوقراطية وإدارية وعملياتية، ممّا حصر الفلسطينيين في تنفيذ المشاريع الصغيرة. ولكن إسرائيل تسيطر حتى على هذه العمليات الصغيرة الاعتيادية، مع أن تأثيرها في تخطيط مشاريع “التنمية” لا يحظى بالتغطية والتركيز الكافيين. فإسرائيلُ عضو في لجنةِ الاتصال المخصصة للمعونات الدولية، وهي الهيئة الأكثر تأثيرًا في تخطيط التنمية وتنفيذها في الضفة الغربية. وهذا يعطيها دورًا في وضع أجندة سياسة التنمية إلى جانب البلدان المانحة الرئيسية والمؤسسات المالية الدولية.
وبخصوص تنفيذ المشاريع، لا يوجد ممثلين للسلطة الفلسطينية في هيئتي التنسيق على المستوى المحلي وهما: لجنة الاتصال المشتركة وفرقة العمل المعنية بتنفيذ المشاريع، في حين أن الاتصالات المتبادلةَ بين هاتين الهيئتين وحكومة إسرائيل نشطةٌ، ما يدلُّ على تمكنها من الاقتصاد الفلسطيني. يُنسق المانحون مع إسرائيل لأسباب عملية: من أجل تنفيذ مشاريعهم، وباعتبارهم بديلًا للسلطة الفلسطينية التي تفتقر إلى القدرة الكافية على مساومة السلطات الإسرائيلية. ولكن يستتبع ذلك نزعُ دورٍ حيوي في الحكم من السلطة الفلسطينية، ممَّا يقوِّض هدف المانحين المزعوم المتمثل في بناء الدولة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وعلاوةً على ذلك، تتدخل إسرائيل في أنشطة وكالات المعونة، ويُسفرُ ذلك عن تداعيات خطيرة على مشاريع التنمية في فلسطين. وقد نشرت رابطةُ الوكالات الإنمائية الدولية، في العام 2011، بيانات مقنعة بشأن طُرق توجيه موارد المانحين بحيث تتحاشى العراقيل البيروقراطية والمادية الإسرائيلية، ويكشف التقرير كيف أن السياسات الإسرائيلية تُجبر وكالات المعونة على تغيير برامجها، ممّا يحدو بغالبية الوكالات إلى تبني استراتيجيات أقل فاعلية ولا تخدم الفئات الأكثر ضعفًا.
يقول رئيسُ منظمة الصحة العالمية السابق في فلسطين واصفًا جهودَ إعادة إعمار غزة في العام 2012: “أُحبطت جهودنا كلُّها بسبب المعوقات ومتاهات البيروقراطية الإسرائيلية. فقد عقَّدونا في مفاوضات بشأن عدد الشاحنات التي سيسمح لها بالدخول، ومواعيد فتح المعابر وإغلاقها، والمعلومات المطلوبة للتخليص على البضائع، وعدد التصاريح التي سيصدرونها لسائقي الأمم المتحدة.”
ثمة مثالٌ صارخٌ آخر للتدخل الإسرائيلي في العملية التي تديرها الأمم المتحدة لإعادة بناء المنازل في أعقاب العدوان على غزة في صيف عام 2014. فمن خلال آلية إعادة إعمار غزة، باتت الأمم المتحدة فعليًا تدير جوانبَ من الحصار الإسرائيلي، رغم أن الحصار ينتهك القانون الدولي. وكان الهدف يتمثل في تسهيل إعادة بناء خُمسِ المنازل البالغ عددها 100000 منزلٍ قبل حلول فصل الشتاء وذلك من خلال مراقبة المواد للتأكد من أنها لم تستخدم في بناء الأنفاق من غزة.
غير أن الأنظمة التي يطالب بها الإسرائيليون صارت معقدةً وغيرَ عمليةٍ بما يفوق المعقول. فكمية الإسمنت ومواد البناء الأخرى التي سُمِح لها بدخول غزة والتي صُرِفت لأصحاب المنازل لم تكن كافية البتة، ممّا ساهم في تفاقم الأزمة في غزة. وعلاوةً على ذلك، فإن نُظم تحديد المواقع الجغرافية (جي بي أس)، وكاميرات الفيديو، وقاعدة البيانات المركزية للمعلومات الخاصة بمستلمي المواد، ساهمت في إحكام السيطرة الإسرائيلية على سكان غزة. وهكذا فإن المجتمعَ الدولي، باختياره أن يتحاشى الحصارَ عوضًا عن مواجهته، قد عزَّز قبضة إسرائيل، بينما ساهمَ بالقليل في جهود إعادة الإعمار.
أفضلية الخيار الثاني
حاولت السلطة الفلسطينية أن تمارسَ وظائفَ سياساتية ضمن الضوابط الإسرائيلية الصارمة، والمعايير الضيقة التي وضعها مجتمع المانحين. فمثلًا، تمثلت إحدى المبادرات الرئيسية التي طرحها رئيس الوزراء السابق سلام فياض في وضع خططٍ ثلاثية لأهداف التنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة. واستخدمَ عمليةً جديدةً في التخطيطٍ تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة، وإسناد دورٍ أكبر إلى السلطة الفلسطينية في وضع الأجندة.
حاولت الوزارات التنفيذية الفلسطينية ووكالات المعونة المانحة جمعَ المدخلات على المستوى المحلي في مجموعات عمل قطاعية، ورفع توصياتها إلى صناع القرار في وزارة التخطيط. غير أن رقابة المانحين اخترقت الخططَ الموضوعة نظرًا لأدوارهم كمشاركين في رئاسة المجموعات الاستراتيجية القطاعية أو كمستشارين فنيين أو ممثلين بنسبة ثلاثة إلى واحد في منتدى التنمية المحلية. أما دور المعيق الذي تلعبه إسرائيل في هيئات صنع القرار الرئيسية فلم تذكره الخطط أو تتصدى له.
فقدت استراتيجية فياض “للتحرير عن طريق الإصلاح” مصداقيتها في 2013 بعد أن أخذ نمو الناتج المحلي الإجمالي المعتمد على المساعدات بالاضمحلال، وبعد حدوث تغيرٍ ضئيل على أرض الواقع عقبَ الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة سنة 2012. ومع ذلك، واصلت الجهات المانحة ووزارات السلطة الفلسطينية توجيه الموارد والاهتمام نحو تحسين عملية التخطيط لخطة التنمية 2014-2016.
تمثَّل الهدف الجديد في ربط التخطيط بعملية اعداد الميزانية من خلال التنسيق بين الوكالات ومزامنة الدورات الإدارية. وبالإضافة إلى العمليات البيروقراطية الجديدة المعقدة، ثمة حاجة لأساليب جديدة لجمع البيانات من أجل التنبؤ بواقعيةٍ بميزانيات الجهات المانحة الفردية على مدار ثلاث سنوات. وكما يظهر في الاختصاصات المفصلة الواردة في الإطار العام لإعداد خطة التنمية الوطنية للأعوام 2014-2016، فإن مقياس النجاح أو الفشل يستند إلى حُسن ترجمة هذه الاختصاصات إلى واقع عملي، وليس إلى مدى تأثير خطة التنمية المنبثقة، أي أن المسألة تدور حول النجاح الإداري وليس التقدم التنموي.
وبسبب هذا الإصلاح بالذات، اضطرت السلطة الفلسطينية إلى السير في اتجاه الانكماش المالي للتكيف مع تناقص تدفقات المعونة وتكرر احتجاز الإيرادات من جانب إسرائيل، ناهيك عن انخفاض الموارد الآتية من داخل الأرض الفلسطينية المحتلة نفسها. ومن الآثار الأخرى المترتبة على هذا النهج ربطُ الإنفاق العام للسلطة الفلسطينية، وبالتالي فرص التنمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بقرارات اعداد الميزانية التي تتخذها برلمانات البلدان المانحة. وعلى الرغم من الإصلاحات الجوهرية التي أجرتها السلطة الفلسطينية، لا تزال مساعدات المانحين تتحدد من منظور سياسي، وبالتالي لا يمكن التعويل عليها في كثير من الأحيان، وهكذا يغدو نهجُ التخطيط المتوسط الأجل إشغالًا للوقت لا أكثر.
إذا كان الهدف الأكبر من الإصلاح المؤسسي هو البرهنة لمجتمع المانحين على أن السلطة الفلسطينية هي متلقيةٌ مسؤولةٌ لأموال المانحين من خلال جهودها الدؤوبة الرامية إلى خفض العجز في ميزانيتها حتى حين يُضيِّق الاحتلالُ على الموارد العامة، فإن هذه الإصلاحات تحقق أهدافها بلا شك. أمّا إذا كان الهدف هو تشكيلُ حكومةٍ ذات قدرةٍ أكبر على ممارسة دورٍ قيادي في عملية وضع أجندة التنمية واستراتيجيتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإن هذه الإصلاحات قد فشلت.
بالرغم من أن ربط التخطيط بعملية اعداد الميزانية هو قطعًا من الممارسات الفضلى، فإن السياق السياسي والاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلة قد يعني أن ثاني أفضلَ الحلول السياساتية قد يحقق نتائجَ أفضل. يُقر الإطار العام لإعداد خطة التنمية الوطنية للأعوام 2014-2016 بأن التوقعات الواقعية للميزانية تقتضي قَصر النفقات المالية على معالجة “الاحتياجات الأساسية الأكثر إلحاحًا” للفلسطينيين. وهذه أقرب إلى استراتيجيةٍ للتدخل الإنساني منها إلى خطةٍ إنمائية لدولةٍ ذات سيادة. وبعبارةٍ أخرى، حوَّلت ظروف الاحتلال المستمر ما هو “ممارسةٌ فضلى” إلى إقرارٍ بالهزيمة من جانب السلطة الفلسطينية. أمّا ثاني أفضل استراتيجية سياساتية فقد تتمثل في مواصلة إنتاج خطط إنمائية شاملة بالرغم من أن تمويلها مستبعد، حيث ستكون هذه الخطط بمثابة بيانٍ سياساتي حول إمكانات الفلسطينيين الإنمائية المُفشَلة. وينبغي لتلك الخطط أن تستند إلى إطار عمل معقول لإعداد الميزانية العامة وأن تعزو سببَ القصور مباشرةً إلى الاحتلالِ والاعتمادِ على المعونة.
التركيز الخاطئ للحكم على السوق
يسعى الحكم بمعناه الواسع لاستحداث الأدوات والأطر اللازمة للمساهمة في رفاه المجتمع اجتماعيًا واقتصاديًا، وهو بالتالي نتيجةٌ ثانويةٌ لخطابٍ وطني محدد. ومن هذا المنظور، فإن النهج النيوليبرالي الحالي ليس إشكاليًا من الناحية الاقتصادية وحسب، بل له أثرٌ مدمرٌ أيضًا على التطلعات الوطنية الفلسطينية. ويرجع بعضُ السبب في ذلك إلى تأثير السلطة الفلسطينية في الخطاب العام حول المقاومة والسياسات الوطنية في مواجهة سلطة الاحتلال، كما ستأتي هذه الورقة السياساتية على مناقشته لاحقًا.
ولا بد من الإشارة إلى التشوه الشديد في العديد من أوجه النيوليبرالية في السياق الفلسطيني. فعلى سبيل المثال، أخذَ الإنفاق على التعليم يتناقص تمشيًا مع مبادئ النيوليبرالية، ممَّا يؤدي إلى زيادة الرسوم الدراسية تدريجيًا. وجرى أيضًا تركيب 300,000 عدادٍ للكهرباء المدفوعة مسبقًا في الضفة الغربية دون استثناء المناطق الريفية ومخيمات اللاجئين من أجل القضاء على “ثقافة الاستحقاق.” وأدى ذلك إلى قطع التيار الكهربائي عن أسر فقيرة.
ومع ذلك، طغت الاعتبارات السياسية في كثير من الأحيان على السياسة الاقتصادية: فبخلاف توصيات النهج النيوليبرالي، لا تزال تحويلات الرعاية الاجتماعية التي تصرفها وزارة الشؤون الاجتماعية في تزايد مستمر. وبالرغم من الضغط المتواصل باتجاه خفض فاتورة أجور العاملين في السلطة الفلسطينية، لا يزال القطاع العام يستحوذ على 20% – 25% من القوى العاملة الفلسطينية. فالدعم المالي الذي تقدمه السلطة الفلسطينية من خلال رواتب الخدمة المدنية والتحويلات المباشرة يشكِّلُ عنصرًا أساسيًا في شرعيتها.
من أجل تطبيق مبدأ شمولية الكفاءة النيوليبرالي الذي يُقاس بمقدار معاملات السوق، ترتكز النيوليبرالية إلى توسيع تعريف السوق ليشمل كل مجالات النشاط البشري. وهذا يصف بالضبط الحالةَ الفلسطينية التي تكتسب السوق فيها أهميةً بالغة. يصوِّر خطابُ السلطة الفلسطينية الراهن دورَ الحكومة والبلديات على أنه خدمي بحت، أو لاسياسي. فبدلًا من مقاومة الاحتلال اقتصاديًا، كرفض دفع الضرائب لإسرائيل أو مقاطعة العمل في إسرائيل ومقاطعة منتجاتها (كما كانت الحال في الانتفاضة الأولى)، يجري الآن تعزيز التعاون (أو بالأحرى الاستسلام) الاقتصادي، حيث ازدهرت الشراكات التجارية، وصار الكثيرون من الفلسطينيين المقربين من السلطة الفلسطينية وكلاءَ تجاريين لمنتجات إسرائيلية، ممّا يخلق مصالح مشتركة بين أصحاب رأس المال والنفوذ الفلسطيني وبين الشركات الإسرائيلية.
تؤثر العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بالإضافة إلى نهج السلطة الفلسطينية النيوليبرالي تأثيرًا تدريجيًا وعميقًا في اختيارات الناس واتجاهاتهم الاستهلاكية. وهذه تكمن في صميم النظام الاقتصادي. لا تنسجم اتجاهات الاستهلاك لدى الفلسطينيين مع مداخيلهم أو وضعهم العام في ظل الاحتلال. إن الرسائل الخفية في الإعلانات والنظام المصرفي تشجع على الإفراط في الاستهلاك من خلال توفير نظام ائتمان “مطَّاط”. ففي العام 2012 بلغ الاستهلاك النهائي للأسر المعيشية 9.6 مليار دولار أمريكي (86% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية). ووفقًا لتقارير البنك الدولي، لم تتجاوز تلك النسبة سوى 10 بلدان بين عامي 2010 و2014.
تُظهر بيانات سلطة النقد الفلسطينية أن نحو ثلثي الائتمان في العام 2013 صُرِف على قطاع العقارات (باستثناء البناء)، وديون البطاقات الائتمانية، والسيارات، “والقروض الاستهلاكية”، والتجارة. رغم أهمية الائتمان البالغة للاقتصاد، فإن نظام الائتمان السليم هو الذي يعيل المشاريع الإنتاجية التي تستحدث فرص العمل أو التي تحفز الطلب الكلي على السلع المحلية. ولكن ليس هذا هو الواقع في فلسطين، بل على العكس من ذلك، انخفضت الأجور الحقيقية (مع حساب التضخم) بنسبة 11% بين عامي 2006 و2010 (انخفضت 3% في الضفة الغربية و31% في قطاع غزة) بينما زاد تركيز الثروة انسجامًا مع نمط توزيع الائتمان السائد.
اقتصاد يتحاشى الاحتلال
في حين يدعم مسؤولو السلطة الفلسطينية القطاعَ الزراعي بالكلام فقط، بلغَ نصيب الزراعة من ميزانية السلطة الفلسطينية 1% فقط مقارنةً بنسبة 28% المخصصة لبنود “الأمن” في 2013. وعلاوةً على ذلك، خُصِّص أقل من 1% من إجمالي المساعدات في الفترة بين 1994 و2006 للأنشطة المتصلة بالزراعة. وهذا بالرغم من أن البنك الدولي نفسه خصص حوالي 8.3 مليار دولار عالمياً لقطاع الزراعة ما بين الأعوام 2013 و2015 استنادًا إلى أبحاث تقول إن الاستثمار في القطاع الزراعي لديه القدرة على الحد من فقر 75% فقراء العالم.
يعزو صناعُ القرار غيابَ الدعم للزراعة الفلسطينية إلى انخفاض إنتاجية هذا القطاع. ورغم صحة القول بأن متوسط الإنتاجية (نسبة العمالة إلى المساهمة) هي أقل في الزراعة منها في قطاع الخدمات أو التصنيع، فإن القطاع الزراعي يلعب دورًا أهم بكثير يتجاوز المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي. فضلًا على أن انخفاض الإنتاجية يُعزى أيضًا إلى غيابِ الدعم من السلطة الفلسطينية أو المساعدات الدولية، ممّا يعوق المزارعين عن استخدام تكنولوجيا جديدة عوضًا عن تلك التي عفا عليها الزمن. فعلى سبيل المثال، انخفضت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي من 12% في العام 1995 إلى أقل من 5% في 2012. وكثيرًا ما تُبرَّرُ قلةُ الدعم المرصود للقطاع الزراعي بوجود قيود إسرائيلية تعوق الوصول إلى الأراضي والمياه لاستدامة الأنشطة الزراعية في المنطقة (ج) (المنطقة التي تمارس فيها إسرائيل سيطرةً كاملة لفترةٍ كان يُفترَضُ أن تكون مؤقتةً بموجب اتفاقات أوسلو).
وبدلًا من ذلك، تتمحور توصيات المانحين السياساتية حول الأنشطة القائمة على الخدمات، مثل شركات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات. وعلى الرغم من أن الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات ضروري للتنمية الاقتصادية في السياق العالمي المعاصر، فإنه في هذه الحالة تحديدًا يحمل سمة النشاط الذي “يتحاشى الاحتلال”. فبخلاف الزراعة، لن تكون هناك شاحنة محمَّلة بالبرمجيات تتلف تحت الشمس وهي تنتظر المرورَ عبر نقطة تفتيش إسرائيلية! فضلًا على أنه لا حاجة للتفتيش على الحدود عند تصدير البرمجيات. وثمة إشكالية في قطاع تكنولوجيا المعلومات تتمثل في تأسيس بضع شركات مشتركة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وهذه الشركات تستغل رخصَ أجور المبرمجين الفلسطينيين الذي يتقاضون أقل من ثلث ما يتقاضاه نظراؤهم الإسرائيليون.
تقوم الاقتصادات النامية، في العديد من نُهج التنمية، باستيراد التكنولوجيا لاستخدامها في القطاع الزراعي لتوفير اليد العاملة والسماح للاقتصاد ككل بتحويل الموارد إلى قطاع التصنيع. وفي الآونة الأخيرة، أخذت الاقتصادات النامية تعوِّض عن القيود في قطاع التصنيع بالتركيز على الخدمات. أمّا في فلسطين فقد نجحَ الاحتلال في النيل من قطاعي الزراعة والصناعة – وهما القطاعان الإنتاجيان – في حين أصبح قطاع الخدمات أكثر تشرذمًا واعتمادًا على المعونة وأقل موثوقية.
إن الاستثمار في الزراعة الفلسطينية أساسي وضروري. فعلى المدى القصير، يستطيع القطاع الزراعي أن يستوعب اليد العاملة لأنه كثيف العمالة، وهو أمرٌ ضروري نظرًا لارتفاع مستويات البطالة في الأرض الفلسطينية المحتلة (23% في العام 2013). وفي السابق كانت الزراعة توظِّف نسبةً كبيرةً من العاملات، بل ثمة مَن يقول إن انخفاضَ معدلات مشاركة المرأة الفلسطينية في اليد العاملة انخفاضًا كبيرًا (17% في 2013 مقابل 70% للذكور) يعود جزئيًا إلى تراجع دور القطاع الزراعي في الاقتصاد الفلسطيني. وعلى الرغم من العراقيل التي يضعها الاحتلال الإسرائيلي في وجه النشاط الزراعي، يمكن أن يكون للاستثمار في هذا القطاع أثرٌ فوري على الحد من الفقر بواسطة استحداث فرص العمل في المناطق الريفية.
والأهم من ذلك، من حيث الرباط الوثيق الذي لا ينفصم بين السياسة والاقتصاد، هو أن معظم الأراضي الصالحة للزراعة تقع في المنطقة (ج)، التي تضم معظم مساحات غور الأردن الخصيب، وهي لا تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وحسب بل تضم غالبية المستوطنات الإسرائيلية. ولكن رغم أن السيطرة الإسرائيلية تشكِّل العقبةَ الرئيسية، فإن الزراعة لا تتطلب بنى تحتية واستثمارات بقدر ما يتطلب القطاع الصناعي، مثلًا، ويمكن الاستفادة من الزراعة بدءًا بالمشاريع الصغيرة. لقد أدى نقص الاستثمار في الزراعة إلى انتقال العمالة الفلسطينية من هذه المناطق إلى أجزاء أخرى من الضفة الغربية. إن هجرة اليد العاملة المضطرة للبحث عن عمل إمّا في القطاع العام أو قطاع الخدمات ساعدت على نحو غير مباشر في توسع المستوطنات القائمة، وقيام بؤرٍ استيطانية جديدة. لذ فإن زيادة التركيز على المناطق الزراعية يمكن أن تساعد في التصدي لتشريد الفلسطينيين داخل الضفة الغربية، والصمود في وجه القيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي الزراعية.
تحرير واضعي السياسة الفلسطينية
لا يتصدى التخطيط الإنمائي في الأرض الفلسطينية المحتلة للعقبات الهيكلية التي تواجه التنمية، حيث تحُول أجندةُ مجتمع المانحين للسياسات دون إنفاق الحكومة على استحداث فرص العمل في القطاعات الإنتاجية، وتقيِّد التغييرات الهيكلية التي تصب في صالح الفقراء. بالإضافة إلى أن النهج الفني المعتمَد في تخطيط التنمية يستنزف طاقات السلطة الفلسطينية في الإصلاحات الإدارية، ولا يمنح القيادات سوى حوافز قليلة لمعالجة أولويات المواطنين. لذا تفشلُ خطط التنمية في تحقيق الغايات السياسية والاقتصادية التي تتصدر أولويات الفلسطينيين. أمّا بالنسبة للقطاع الخاص الفلسطيني الذي كان الدعامة الرئيسية للاقتصاد قبل العام 1994، فقد أُضعِف دورُه في الوقت الراهن، وبات لا يرغب في الاستثمار في المشاريع التي لا تدرُّ أرباحًا كبيرة أو لا يحصل فيها على الدعم. وصارت منظمات المجتمع المدني هي الأخرى تعتمد على المساعدات، وتعمل ضمن دورات المعونة، ممّا يجعل من الصعب كثيرًا، على سبيل المثال، أن تدعمَ مشاريع الزراعة المستدامة.
وضعت إصلاحات الحكم المتغنى بها حدودًا لقدرة السلطة الفلسطينية المالية، وحصرت التخطيط في المشاريع البالغة الصغر وذلك بتأثير الأطر النيوليبرالية والاحتلال الإسرائيلي المتعنت. وجلبت تلك الإصلاحات كذلك الهوسَ بالتكنوقراطية إلى عملية صنع السياسات الفلسطينية، بحيث صارت السلطة الفلسطينية صاحبةَ ولايةٍ تكنوقراطية إدارية مركِّزة على العمليات، بينما يُظَن أنها تمثل ممارسةً عالمية فضلى. وتحاول السلطة الفلسطينية، بدورها، أن تفرض هذا الإطار المقيِّد على الحوار الفلسطيني في مجال السياسات. إن المساءلة أمام المانحين والضرورات التي يقتضيها التحكم الإسرائيلي بدقائق الأمور قد أوهنت المساءلة أمام الشعب الفلسطيني الذي بوسعه أن يضغط على السلطة الفلسطينية لكي تستجيب بفاعليةٍ أكبر لأولويات المواطنين. ونتيجةً لذلك، لم تشهد المؤشرات العامة تقدمًا حقيقيًا، ولم يطرأ تحسنٌ حقيقي على حياة الفلسطينيين اليومية. بل على العكس من ذلك، تراجعت تلك المؤشرات تراجعًا حادًا.
ينبغي للسلطة الفلسطينية، في الأجل القريب، أن تتجه نحو قطع روابط التبعية بإسرائيل، بدلاً من سياسة الاستسلام الاقتصادي التي تنتهجها حاليًا. ومن الخطوات المهمة في هذا الصدد مقاطعةُ المنتجات الإسرائيلية، بدءًا بالسلع الاستهلاكية التي يسهل إيجادُ بدائلَ محليةٍ لها. وقد أخذت السلطة الفلسطينية خطوةً صغيرةً بالفعل في هذا الاتجاه حين دعت إلى مقاطعة ست شركات إسرائيلية (لا تزال كيفية تطبيق المقاطعة غير معروفة). وفي الأجل البعيد، ينبغي للسلطة الفلسطينية أن تنظر بجدية في التحول إلى مزودٍ للخدمات الأساسية (الصحة والتعليم) بدلا من محاولة إدارة الأرض الفلسطينية المحتلة في ظل انعدام الانتخابات وغياب السيادة السياسية أو الاقتصادية. وهذا ليس بالتغيير الذي يحدث دفعةً واحدة بل يحتاج إلى تخطيطٍ سليم ونقاش داخلي. ومن أمثلة هذه المناقشات تقريرُ مبادرة “اليوم التالي” الصادر عن المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية.
إن من الأهمية بمكان أن يتصدى مجتمعُ المانحين للقيودَ السياسيةَ والاقتصادية والتداعيات المنبثقة عن السياسات في هذا المجال. وينبغي للمانحين أن يرفعوا يدهم عن وضع الأجندة من خلال تأثيرهم في السياسات والبرامج الحكومية، وفي برامج القطاع غير الحكومي أيضًا. ويمكن للتحول الاستراتيجي أن يتأتى من خلال تعزيز التكتلات والمشاركة السياسية في أوساط منظمات المجتمع المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة. ولا بد من وضع سياسة لتحقيق التوازن على صعيد تقوية السلطة الفلسطينية من خلال وضع استراتيجية لدعم التنظيم السياسي المستقل وتعبئة المجتمع المدني. وينبغي للإصلاحات في مجال الحكم أن تنطوي على وضع نُظمٍ مؤسسية لمساءلة السلطة الفلسطينية أمام المواطنين الفلسطينيين.
ينبغي للمانحين أيضًا أن يتصدوا لمشكلة الاعتماد على المعونة، وهي مشكلةٌ تستديمها المشاريع التي تتحاشى الاحتلال. ومن المقاربات العملية لتحقيق ذلك وضعُ أجندةٍ واضحة للتنمية الاقتصادية التي تصب في صالح الفقراء. وهذا يناقض الوصفات السياساتية النيوليبرالية التي تقوض أولويات المواطنين عبر تبرير الأعباء الملقاة مباشرةً على كاهل الفقراء والتنبؤ بتحسن النمو الاقتصادي في الأجل البعيد.
وفضلًا على ذلك، ينبغي أن يدعم المانحون خطابًا مقاوِمًا تتفق عليه الأطراف الداخلية. فمن شأن ذلك أن يفسحَ المجالَ لدعم المشاريع التي تعزز حركةَ مقاطعةِ إسرائيل وسحبِ الاستثمارات منها وفرضِ العقوبات عليها، ولا سيما من خلال الالتزام بتعزيز الاستقلال الاقتصادي. ويمكن تحقيق جزءٍ من ذلك بالتحول إلى المنتجات المحلية عوضًا عن الإسرائيلية. بيد أن النجاح يعتمد أيضًا على تكثيف البناء الشبكي مع الحلفاء في الخارج لتمهيد الطريق أمام الصادرات الفلسطينية، بدلًا من الاعتماد على الشركات وغرف المقاصة الإسرائيلية.
لقد آن للسلطة الفلسطينية أن تعترفَ بأن النُهجَ الاقتصاديةَ السائدة تعجزُ عن تحقيق أي تنميةٍ حقيقية في الأرض الفلسطينية المحتلة لأن ظروف الاحتلال والاستعمار الجاثمين تخلقُ سياقًا مؤسسيًا مشوَّهًا لسياسة التنمية والتخطيط الإنمائي. وبالتالي، فإن المعرفة المسلَّم بصحتها لا تنطبق على هذا السياق، ولا بد من التخلي عنها لصالح مقاربةٍ تراعي الحقائق المؤسسية والسياسية المحددة في الأرض الفلسطينية المحتلة. ويجب أن يكونَ الهدفُ النهائي من التخطيطِ الإنمائي التقدمَ نحو الحريةِ والعدالة والمساواة للشعب الفلسطيني بأسره.
- تتوفر كافة إصدارات الشبكة باللغتين العربية والانجليزية (اضغط/ي هنا لمطالعة النص بالإنجليزية). لقراءة هذا النص باللغة الفرنسية، اضغط/ي هنا. تسعد الشبكة لتوفر هذه الترجمات وتشكر مدافعي حقوق الإنسان على هذا الجهد الدؤوب، وتؤكد على عدم مسؤوليتها عن أي اختلافات في المعنى في النص المترجم عن النص الأصلي.
- النقطة الحدودية الوحيدة التي لا يوجد لإسرائيل فيها حضورٌ مادي هي معبر رفح بين غزة ومصر، ولكنه قلما يُفتَح.
- بالرغم من أن وجود عملة فلسطينية مستقلة سيتيح تحكمًا أكثر في أذرع السياسة النقدية، ثمة نقاشٌ مشروع حول مقدار الجاهزية لعملة فلسطينية، وحول البدائل الممكنة.