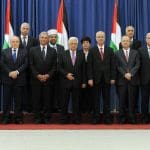لمحة عامة
ظلت منظمة التحرير الفلسطينية لأكثر من أربعة عقود الممثلَ الشرعي الوحيد المعترف به دوليًا للشعب الفلسطيني. غير أنها ظلت كذلك بالاسم فقط منذ العام 1994. وفي حين يتساءل الكثير من الفلسطينيين عمَّن يمثلهم ويسعون إلى إحياء منظمة التحرير، يرى مستشار الشبكة لشؤون السياسات أسامة خليل بأن إحياءها لن يُفضي إلى قدرٍ أكبر من التمثيل والمساءلة. ويحاجج بأن مؤسسات منظمة التحرير صُمِّمت لتناسب حركةَ تحررٍ وطني في سياق الحرب الباردة، ولِتحُد عن قصدٍ من التمثيل الواسع النطاق إلى حين إحراز النصر. وفي غياب هذا النصر، استُخدمت تلك الهياكل المؤسسية نفسها لعرقلة الإصلاحات الممكنة ولإبعاد القيادة الفلسطينية عن الشعب الذي تدعي تمثيله.1 ويخلص الكاتب إلى أن تحقيق أهداف الفلسطينيين يتطلب منهم التخلي عن منظمة التحرير الفلسطينية والشروعَ في إنشاء هيئة تمثيلية جديدة أكثر ملاءمةً للتحديات والاحتياجات والفرص في القرن الحادي والعشرين.
مَن يمثل الفلسطينيين؟
نجحت منظمة التحرير الفلسطينية، وهي في أوجها، في إبقاء الكفاح الفلسطيني حيًا وحاضرًا على الصعيد العالمي. وفي 1974، اعترفت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بالمنظمة باعتبارها “الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.” ومع ذلك لم يكن إخفاق الحركة الوطنية الفلسطينية في تحقيق أهدافها أكثرَ وضوحًا وجلاءً من وقتنا الحاضر إذ يستعد الفلسطينيون لإحياء الذكرى الخامسة والستين للنكبة والذكرى العشرين لاتفاقات أوسلو.2 وهذا يطرح السؤال التالي: من يمثل الشعب الفلسطيني اليوم؟
إن قضية التمثيل تعتبر قضية ملحةٌ بوجه خاص نظرًا لِما برز في الآونة الأخيرة من تحولات ومبادرات على المستوى الدولي، الاقليمي والفلسطيني. أولها الثورات العربية والثورات المضادة التي أطاحت بعدة أنظمةٍ ديكتاتوريةٍ طال وجودها في المنطقة. حيث ظل الفلسطينيون اثناء تلك الثورات على هامش “الربيع العربي” إلى حدٍ كبير. ثانيها تصويت الأمم المتحدة مؤخرًا على قبول فلسطين كدولةٍ مراقبةٍ غير عضو. ولهذا القرار آثار غير مؤكدة على مكانة منظمة التحرير الفلسطينية ووضع الفلسطينيين المقيمين خارج حدود “دولة فلسطين.” ثالثها المفاوضات المستمرة بين فتح وحماس والوعد بعيد المنال بإنجاز الوحدة الوطنية. رابعها المبادرة الأخيرة الداعية إلى إجراء انتخابات مباشرة لاختيار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في أعقاب تنفيذ اتفاق الوحدة. وآخرها احتضار “عملية السلام” وهو ما ستُبرزه أكثر زيارةُ الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى المنطقة هذا الشهر دون أن يحمل في جعبته مقترحًا لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
دافعت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بشدة منذ 1974 عن تسميتها “الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني،” بل واستخدمت هذه العبارة كدرعٍ وهرواة لمواجهة خصومها ومنافسيها (الحقيقيين والمتخيَّلين) في الداخل والخارج. وادعت المنظمة، باعتبارها حركةَ تحررٍ وطني، بأن من الضرورة بمكانٍ أن يتحدث الفلسطينيون بصوت واحد. وعقب توقيع اتفاقات أوسلو سنة 1993 وإنشاء السلطة الفلسطينية، صار فرضًا أن لا توجدَ سوى “سلطةٍ واحدة” فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة.
غدا كل نقدٍ يوجَّه لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية يثير حفيظتها لتردَّ عليه بسؤالٍ لا يخلو من نبرة الاتهام: “مَن أنتم؟” مَن أنتم – تقول القيادة – لتتحدثوا وتشككوا وتنتقدوا؟ والهدف من ذلك جلي: للإخراس والتخويف والحد من الأسئلة والمعارضة المباحة. وتعمدت قيادة المنظمة، عندما عرَّفت الجهةَ الممثلةَ للفلسطينيين ورسمت ملامحها، أن تحد من خضوعها لمساءلة شعبها ومحاسبته. في حين عكس سلوك القيادة المستبد الأصولَ التي قامت عليها منظمة التحرير الفلسطينية وقد أُعيد انتاجه في هياكلها المؤسسية.
تأسست منظمة التحرير الفلسطينية بدعمٍ من الرئيس المصري جمال عبد الناصر وكانت نتاجًا للتنافسات القائمة بين العرب. ولم تستقل المنظمة فعليًا عن القاهرة إلا سنة 1968. وعلى مدار العقدين اللاحقين، حظيت المنظمة بدعم مختلف ألوان الطيف السياسي ابتداءً من ممالك الخليج المحافظة إلى الدول الثورية مثل الجزائر وفيتنام وكوبا. وفي خضم الحرب الباردة، اصطفت منظمة التحرير إلى جانب تلك الدول الثورية ممّا دبَّ الذعر في واشنطن التي سعت جاهدةً لاحتواء نفوذ المنظمة إقليميًا ودوليًا.3
انتفعت منظمة التحرير الفلسطينية من الدعم الدبلوماسي والمالي والعسكري من حلفائها العرب وغير العرب، مستغلةً التنافسَ بين القوتين العظميين آنذاك، واشنطن وموسكو، وكذلك التنافسات القائمة بين الدول العربية. وبلغ الدعم ذروته حين ألقى زعيم منظمة التحرير ياسر عرفات خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1974. غير أن القيود المفروضة على ذلك الدعم تجلت تمامًا إبان الاجتياح الإسرائيلي للبنان سنة 1982 حيث سعت إسرائيل إلى طرد منظمة التحرير من لبنان – إنْ لم يكن تدميرها عن بكرة أبيها.
وضعت الحرب الباردة أوزارها وواجهت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بيئةً دوليةً مختلفةً جذريًا ومنطويةً على تحديات أكبر. وساء وضع منظمة التحرير الفلسطينية مع اندلاع حرب الخليج الأولى بسبب الدعم العلني الذي أبداه عرفات للعراق، الأمر الذي نفَّر عددًا من الحكومات العربية وعرَّض الجاليات الفلسطينية المتجذرة في الدول الخليجية للخطر. وفي المحصلة، تقيدت قواعد الدعم المالي والسياسي لمنظمة التحرير بشدة. ولمّا كانت الانتفاضة الفلسطينية الأولى تستقطب اهتمامًا وتعاطفًا دوليًا، خشي عرفات أن تظهر قيادةٌ بديلةٌ في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين. وهكذا ساهمت هذه العوامل مجتمعةً في اتخاذه قرارَ التفاوض سِرًا على اتفاقات أوسلو. قدّمت الاتفاقات، التي صُمِّمت بالأصل لتكون اتفاقًا مؤقتًا لخمس سنوات، لمنظمة التحرير ما هو أقلُّ بكثير من أهدافها المعلنة. وأسفر تنفيذ تلك الاتفاقات عن تفكيك منظمة التحرير وإنشاء السلطة الفلسطينية. وقد أكدت مفاوضات “الوضع النهائي” واستمرار الاحتلال الإسرائيلي على مدى العقدين اللاحقين أن فلسطين ما كانت لتتحرر أو تصبح دولةً مستقلة.
وبالرغم من أن وضع الفلسطينيين ومنظمة التحرير الفلسطينية تغير كثيرًا منذ 1968، فإن هياكل المنظمة المؤسسية واللوائح الحاكمة لها ظلت كما هي ولم تتغير فعليًا. صممت منظمة التحرير الفلسطينية مؤسساتها الرئيسيةَ لتلائمها باعتبارها حركة تحررٍ وطني، لذا فقد عفا عليها الزمن وأخذت تعوق الآن أيضًا التحديات الداخلية والخارجية. ويتجلى ذلك عند مقارنة أرفع هيئتين في منظمة التحرير وهما المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية.
خرافة المؤسسات المستقلة
أُنشئ المجلس الوطني الفلسطيني وفقًا لمذكرة قانونية أُعدت للسلطة الفلسطينية ليكون بمثابة برلمان للفلسطينيين كافة. ومن مسؤولياته “صياغة سياسات المنظمة وخططها وبرامجها.” أمّا اللجنة التنفيذية فهي “الجهاز التنفيذي الرئيسي” لمنظمة التحرير وممثلها “على المستوى الدولي.” وعلى مر العقود الأربعة الأخيرة، ظلت اللجنة التنفيذية تقوم فعليًا بالمهام التشريعية والتنفيذية في منظمة التحرير، وقد تجلى هذا الدور أكثر فأكثر بمرور الزمن. وفي المقابل، لم يطبق المجلس الوطني الفلسطيني الضوابط والموازين على عمل اللجنة التنفيذية بل ولم يقدم لها المشورةَ، وإنما ظل يصادق على قراراتها. وفضلًا على ذلك، أصبحت اللجنة التنفيذية، كما منظمة التحرير الفلسطينية والحركة الوطنية الفلسطينية بعمومها إلى حدٍ كبير، مدينةً ومعتمدةً بوتيرةٍ متناميةٍ على قرارات عرفات وأفعاله التي لا تقبل الجدل في معظم الأحيان. ومنذ وفاة عرفات، سعى محمود عباس إلى تقمص هذا الدور.
لم يكن عجز المجلس الوطني الفلسطيني مُعضِلًا للزعماء السابقين والمحللين الفلسطنيين، إذ يذكر شفيق الحوت في كتابه أن عرفات قرر في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في 1991 عقدَ أول انتخابات لاختيار رئيسٍ للمجلس عن طريق الاقتراع السري. وكان الجميع يعلم أن خيار عرفات المفضل هو تجديد رئاسة الشيخ عبد الحميد السايح، وهو فعلًا ما تمخضت عنه الانتخابات بأغلبيةٍ ساحقة.4
وهكذا وفي 15 اجتماعًا عقدها المجلس على مدار أكثر من 20 عامًا، لم تُعقد انتخابات بالاقتراع السري لاختيار قيادة أعلى هيئةٍ في منظمة التحرير الفلسطينية. ولم يعتبر المجلس هذا الأمر غير اعتيادي بالنظر إلى أن الاختيار كان يعتمد على قرار عرفات وليس على مبادرةٍ من أعضاء المجلس. وفضلًا على ذلك، عكست النتيجة ديناميات السلطة القائمة داخل منظمة التحرير وبخاصةٍ ما يفضله عرفات. وهذا يدل على أن المجلس الوطني الفلسطيني بالكاد كان هيئةً مستقلةً صانعةً للقرار حتى قبل إبرام اتفاقات أوسلو واستيعاب منظمة التحرير داخل السلطة الفلسطينية.
تنسجم ذكريات الحوت والنقد الذي وجهه عالم الاجتماع الفلسطيني جميل هلال إلى المجلس الوطني الفلسطيني حيث قال إن مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية كانت بحاجةٍ إلى إصلاحات جوهرية حتى قبل توقيع اتفاقات أوسلو. وانتقد بوجه خاص جلسات المجلس “الشكلية والاحتفالية” التي اقتصرت على اجتماعات تنعقد سنويًا أو كل سنتين بهدف “إضفاء شرعية على الصفقات السياسية التي تتوصل إليها قيادت تنظيمات المقاومة المختلفة.”
بالرغم من أن الجماعات السياسية المختلفة الممثَّلة في المجلس الوطني الفلسطيني قد أجرت بالفعل مناقشات ومداولات، الا انه من الصعب – إنْ لم يكن من الزيف– أن يسمى ذلك هيئةً تشريعية. فأعضاء المجلس كلهم معينون وليسوا منتخبين، والغالبية العظمى منهم اختيروا على أساس نظام حصص التمثيل الذي وضعته منظمة التحرير الفلسطينية ليتناسب وحجم الفصائل السياسية. ويبين الدكتور أسعد غانم كيف أن عرفات استغل نظام الحصص “لضمان تمرير القرارات التي أيدها وتعيين المقربين منه في المناصب المهمة.”5 ورغم أن المجلس الوطني الفلسطيني اشتمل على مقاعد للمستقلين ولعموم الأعضاء، فإن أولئك المعينين كانوا منحازين إلى حدٍ كبير إلى فتح، ممّا عزَّز وزنها داخل منظمة التحرير الفلسطينية وزاد نفوذ عرفات.
عَمِلت هذه البنية على تعزيز ديناميات ثلاث. أولًا، ظل صنع القرار في منظمة التحرير الفلسطينية بيد اللجنة التنفيذية التي كانت تضم قيادات من المنظمات السياسية المختلفة وتعقد اجتماعات دورية، على خلاف المجلس الوطني الفلسطيني. وبالإضافة إلى ذلك، خضعت ميزانية المنظمة لرقابة اللجنة التنفيذية، وليس المجلس. وبمرور الوقت، ترسخت مهام صنع القرار داخل اللجنة التنفيذية ومراقبة الميزانية في زمن عرفات واستُخدمت تلك المهام في التأثير في صنع القرار. وبات ذلك سمةً لحكم عرفات داخل السلطة الفلسطينية. وثانيًا، اختارت قيادات الفصائل المختلفة أعضاءَ المجلس الوطني الفلسطيني. ولذا كان هؤلاء الأعضاء مدينين لمنظماتهم وبخاصةٍ قياداتها لا إلى جماهير الناخبين. وثالثًا، هيمنت حركة فتح وعرفات على منظمة التحرير الفلسطينية بحيث أصبحت الحركة والمنظمة بمرور الوقت مترادفتين عن قصد ولا يمكن تمييز إحداهما عن الأخرى أو عن الحركة الوطنية بعمومها.
كشفت اتفاقات أوسلو ضعفَ مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ودورَ عرفات المهيمن في اللجنة التنفيذية. فقد كانت المعرفة بالمفاوضات مقتصرةً على زمرةٍ صغيرةٍ ملتفةٍ حول عرفات. ولم تحظَ الاتفاقات بمصادقة المجلس الوطني الفلسطيني ولا اللجنة المركزية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بل التقى عرفات في بادئ الأمر بقيادة فتح ولم يوافق على انعقاد اللجنة التنفيذية إلا بعد مواجهة ضغوطات. وعندما خضعت الاتفاقية أخيرًا للتباحث والتداول داخل اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وافقت اللجنتان على الاتفاقات.6
وبعد تنفيذ الاتفاقات بعامٍ واحد، أصبح حضور منظمة التحرير الفلسطينية اسميًا فقط. ورغم أن السلطة الفلسطينية مسؤولة قانونًا أمام منظمة التحرير، فقد نُقِلت قيادة المنظمة وموظفوها الأساسيون وتمويلها إلى غزة ولاحقًا إلى رام الله. أمّا القلة المتبقية من موظفي المنظمة فقد اضطروا إلى التكيف مع العجز المزمن في الميزانية ومع تلاشي أهميتهم.
وفي الوقت نفسه، فاقمت فترة أوسلو عجزَ المجلس الوطني الفلسطيني. وفي ظل سلطة عرفات المطلقة واحتضار منظمة التحرير الفلسطينية، بات المجلس الوطني الفلسطيني رمزًا وظيفته المصادقة على القرارات. وتجلت هذه الحقيقة بأوضح ما يكون في اجتماع المجلس المنعقد في كانون الأول/ديسمبر 1998 في غزة لتعديل الميثاق الوطني الفلسطيني – وهو قرارٌ اتخذه عرفات وصادق عليه المجلس. غير أن هوية الأعضاء الذين ضمهم المجلس في دورة عام 1998 لم تتضح لغاية اليوم إذ كان من بين الحضور والمصوتين أعضاء وغير أعضاء.7
تطرح محدودية تأثير المجلس الوطني الفلسطيني قبل أوسلو وبعدها تساؤلات حول إمكانية إصلاح هذه الهيئة. وفي حين أن تركيبته وصفته التمثيلية ولوائحه الداخلية لربما كانت مبررةً باعتباره “برلمانًا في المنفى” لحركة تحررٍ وطني، الا انه لم يعد صالحاً اليوم. وفضلًا على ذلك، كيف لمجلسٍ وطني فلسطيني – حتى وإنْ كان منتخبًا بالاقتراع المباشر – أن يأمل في الحدِّ من نفوذ اللجنة التنفيذية التي تتحكم بالميزانية والسياسات الداخلية والخارجية أو يأمل في تقييدها أو حتى التأثير فيها. لذا فإن إصلاح المجلس وحده لن يكفي لتغيير هذه الدينامية.
ثمة مثالٌ آخر لهيئةٍ منتخبةٍ وقائمةٍ بالفعل ولكنها عديمةُ التأثير وهي المجلس التشريعي الفلسطيني الذي “مثَّل” الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من العام 1996 إلى 2006. غير أن الصلاحيات المالية والسياسية لم توكل إلى المجلس التشريعي وإنما كانت منوطةً برئيس السلطة الفلسطينية. وقد أدارَ عرفات، باعتباره رئيس السلطة الفلسطينية، المجلسَ التشريعي كما أدارَ منظمةَ التحرير والمجلس الوطني الفلسطيني. وكلَّما حاول المجلس التشريعي أن يمارس استقلاليته، كان عرفات يتجاهل قرارته أو يستخدم سلطاته الرئاسية ومنصبه ولقبه الثاني كرئيسٍ للجنة التنفيذية في منظمة التحرير ليقوِّض قرارت المجلس أو يبطلها.8
وعلاوةً على ذلك، فإن اتفاقات أوسلو قيدت وظائف المجلس التشريعي وصلاحياته، ووسعت صلاحيات رئيس السلطة الفلسطينية التنفيذية والتشريعية. ومن تلك الصلاحيات إصدار المراسيم التنفيذية دون استشارة السلطتين التشريعية والقضائية وبمعزلٍ عن رقابتهما.9 وهكذا فإن رئيس السلطة الفلسطينية يمثِّل سلطةً قائمةً بحد ذاته – ولكن ليس على إسرائيل والولايات المتحدة بالطبع.
الانتخابات ليست البلسم الشافي
سوف تواجه أي محاولة لإحياء المؤسسات الفلسطينية مقاومةً من قيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية ومن الولايات المتحدة وإسرائيل. وقد تجلى ذلك من قبل في أعقاب انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المنعقدة عام 2006 حيث سعت تلك الأطراف إلى الانقلاب على فوز حماس في صناديق الاقتراع. وحتى بعد الإعلان عن حكومة الوحدة، ظل يُمنَعُ أعضاءٌ منتخبون في المجلس التشريعي من حضور جلسات المجلس. ومن بين الوسائل المستخدمة في ذلك حملةٌ حثيثةٌ شنتها إسرائيل من أجل سجن أعضاء المجلس التشريعي في الضفة الغربية ومنع الأعضاء في غزة من السفر إلى رام الله لحضور الاجتماعات. وعلاوةً على ذلك، لم ينعقد المجلس التشريعي منذ ما يزيد على خمس سنوات ولا يزال الكثيرون من أعضائه في السجون الإسرائيلية.
يمثل موقف رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية عقبةً أخرى في طريق الإصلاح. فلقد استُحدِث منصب رئيس الوزراء بضغطٍ من واشنطن، والشرط الأساسي فيمن يشغل هذا المنصب هو أن يحظى برضا الولايات المتحدة وإسرائيل وليس الشعب الفلسطيني. وكما هو متوقع، أذعنت قيادة السلطة الفلسطينية لهذا المطلب. فإذا كانت السياسات والإجراءات الأمريكية والإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من اختيار رئيس وزرائهم بحرية وتمنع المجلس التشريعي من الانعقاد، فكيف ستنظر الولايات المتحدة وإسرائيل إلى المساعي الرامية إلى انتخاب مجلس وطني فلسطيني يستخف علنًا بالهيمنة الأمريكية في المنطقة ويتحدى الاحتلال الإسرائيلي؟ هذا لا يعني أنه ينبغي للفلسطينيين أن يقبلوا إملاءات الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن تنصيب قادتهم وممثليهم المنتخبين، بل عليهم أن يأخذوا في الحسبان كيف أن الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية سيعملون من أجل عرقلة وتقويض أي جهود تُبذَل من أجل ضمان التمثيل والمساءلة والديمقراطية.
تكشف هذه القضايا والقيود تناقضًا رئيسيًا في المساعي الرامية إلى إحياء المجلس الوطني الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية، وهو أن الانتخابات الديمقراطية التي تكرس سيادة الحركات غير الديمقراطية لن تجلب الإصلاحات ولا الديمقراطية ولن تُفضي سوى إلى ترسيخ الوضع الراهن. فحركة فتح، بالأخص، المهيمنة على السياسة الفلسطينية منذ أواخر عقد الستينيات من القرن الماضي والمحتكرة فعليًا للمجالين السياسي والاقتصادي منذ ما يزيد على عقدين من الزمن، صرَّحت مرارًا وتكرارًا أنْ لا مصلحة لها في إقامة نظام حكمٍ تمثيلي وتشاركي.
يهيمن هذا الواقع على مؤتمرات فتح النادرة الانعقاد التي يشيد بها أنصار الحركة في كل مرةٍ كدلالةٍ على أن الإصلاحيين سوف يبرزون من أجل استرداد الحركة واستعادة مجدها السابق المتصوَّر. وبالطبع، لا تجد هذه الآمال سوى الخيبة عندما لا تبارح القيادة المفضوحة والفاسدة مكانها.
وهذا تحديدًا ما حدث في المؤتمر السادس لحركة فتح المنعقد سنة 2009، إذ يُفترَض بالحركة أن تنتخب لجنتها المركزية كل أربع سنوات، ولكن مؤتمر 2009 كان السادس لها فقط والأول منذ 20 عامًا. شَهِد المؤتمر ظهور محمد دحلان من جديد وهو رئيس جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية في غزة والذي فقد هيبته في وقت سابق، وهو مشهور بوحشيته وفساده، ومع ذلك فقد انتُخب عضوًا في اللجنة المركزية لحركة فتح. ولم يُفلح محمد قريع، وهو شخصية فاسدة أخرى، في الحصول على مقعد في اللجنة إلا عبر صفقات في الكواليس وتدخلات من عباس. وفي حين فقد دحلانٌ حظَّه ومكانته مذ ذاك الحين، فإن قريع لا يزال شخصيةً رئيسيةً في فتح والسلطة الفلسطينية. وهكذا فإن حركة فتحً، التي يشكٍّل ممثلوها كتلةً كبيرةً في مجلس فلسطيني منتخب ويدينون بالفضل إلى قيادةٍ غير ممثِّلة وغير فعالة، لن تكون الوسيلة لإحياء الحركة الوطنية بل ستكون العقبة الماثلة في سبيل ذلك.
أمّا الرابحُ الرئيسي الثاني من انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في مرحلة ما بعد اتفاق الوحدة والعائقُ الثاني أمام الإصلاح فهو حركة حماس. فبدلًا من تنفيذ برنامجها الانتخابي لعام 2006 المتمثل في “الإصلاح والتغيير،” عمدت حركة حماس إلى محاكاة حكم فتح من حيث قمع المعارضين السياسيين، وتبنت سياساتٍ تتسم بطابعٍ محافظٍ أكثر. وتعرَّض الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة ممن حاولوا في العامين الماضيين تنظيمَ تجمعات واحتجاجات سلمية إلى قمع عنيف بعصا السلطتين المتنافستين. وعلاوةً على ذلك، فإن الاتفاقات والمبادرات العديدة، منذ العام 2005، الرامية إلى تسوية الخلاف بين فتح وحماس والتي توصلت إليها المفاوضات ولكن لم تُنفذ، تُبيِّن بوضوحٍ تام أن شاغلهما الوحيد هو اعتلاء السلطة والحفاظ عليها.
أمّا المنظمات الرئيسية الأخرى المكونة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهي الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فإنها لا تشكل بديلًا. وتجلى ذلك في الانتخابات المحلية التي عُقدت في الآونة الأخيرة في الضفة الغربية. فرغم ضعف الإقبال على التصويت نظرًا لعدم مشاركة حماس وانقسام فتح، لم تحصل الأحزاب اليسارية على عددٍ كبيرٍ من الأصوات أو المقاعد. فمن دون إجراء تغييرات جذرية في البنية التنظيمية لتلك الاحزاب وجمع والتبرعات، والتوعية والتواصل، سيكون من المستبعد جدًا أن يتمكن اليسار الفلسطيني من إنعاش مكانته المحتضرة إذا ما انعقدت انتخابات تشاركية لاختيار المجلس الوطني الفلسطيني. وبدلًا من ذلك، فإن استجداء اليسار الفلسطيني للأهمية والمكانة سوف يُستَغل، كما حصل معهم في منظمة التحرير الفلسطينية بعد 1988، من أجل تعزيز أجندات الأحزاب الأقوى التي تتناقض مواقفها وبرامجها مع مواقف اليسار وبرامجه.
الممثل الشرعي الوحيد؟
لا تزال الحالة السياسية الفلسطينية قاتمةٌ ولايُقدم أيُّ من الفصائل السياسية القائمة رؤيةً مقنعةً من أجل المستقبل. ويعود السبب الأكبر في ذلك إلى أن تلك الفصائل لا تمثل مستقبل الفلسطينيين وإنما تمثل ماضيهم. كما انها لن تقود إلى ولادةٍ جديدةٍ للحركة الوطنية الفلسطينية، بل ستؤخر تطويرها وتعوقه على الأرجح. فإذا كان هناك أمل بأن تنجح الحركة الوطنية بعد إحيائها حيثما فشلت المساعي السابقة، فإنها ستتطلب طريقة مختلفةً في التفكير حول ماهية الحركة الوطنية الفلسطينية في القرن الحادي والعشرين. ولا بد لها أن تكون ممثِّلًا حقيقيًا، وسوف تتطلب التخلي عن الهياكل والمنظمات السابقة، بما فيها منظمة التحرير وهيئاتها الرئيسية.
وما تبقى من منظمة التحرير الفلسطينية اليوم– اسمها ومكانتها الدولية وبقايا مؤسساتها ومكاتبها وألقابها البيروقراطية – فستظل زمرةٌ صغيرةٌ غير منتخبة وغير ممثِّلة تستخدمه من أجل خدمة أجنداتها الخاصة.10وبذلك فإنها تصدُّ عن قصد المحاولات الراميةِ للإصلاح وتحدي السياسات الإسرائيلية وخلق أصوات بديلة.
ورغم هذه الحقائق، ثمة مَن يقول إن منظمة التحرير الفلسطينية تبقى “الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.” وأنا أختلف مع هذا الطرح بكل احترام، وأسأل بدوري: كيف يتخلى ممثلٌ عن شعبه الذي يدّعي تمثيله؟ وكيف يكون للممثل قيادةٌ مدينةٌ بالفضل في وجودها ليس لشعبها وإنما للقوى المسؤولة عن تشردهم المتواصل؟ كيف يتخلى الممثل مرارًا وتكرارًا عن حقوق شعبه الأساسية ويهاجم المعارضين، بينما تتنفع القيادة والقِلة الحاكمة من حولها من مكانتهم وألقابهم وامتيازاتهم واستمرار الاحتلال؟ تبين هذه الأسئلة بوضوح الفرق الشاسع بين منظمة التحرير الفلسطينية اليوم وكيف كانت صورتها في معتقد الكثير من الفلسطينيين لمّا كانت في أوجها.
ثمة مَن يرى أن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، بما في ذلك من خلال انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني بصورة مباشرة، سيكون السبيل إلى توحيد الحركة الوطنية وإحيائها. وهنا أيضًا أختلف مع هذا الطرح بكل احترام وأقول إن هذه المساعي تتجاهل القيود المؤسساتية الجسيمة والخطيرة التي لا تعرقل الإصلاح وحسب وإنما كلَّ محاولةٍ ترمي إلى تغيير الوضع القائم. لذا أطرح عددًا من الأسئلة الملحَّة التي لا تستطيع، باعتقادي، انتظار الإجابة عليها حتى موعد الانتخابات أو بعد انعقادها:11
كيف ستتغلب منظمة التحرير الفلسطينية بعد إحيائها، حتى وإنْ امتلكت مجلسًا وطنيًا فلسطينيًا منتخبًا ديمقراطيًا، على القيود السياسية والمؤسساتية المفروضة عليها تاريخيًا؟ كيف ستخضع لمساءلة الفلسطينيين حول العالم بشكل أكبر ممّا خضعت له نسختها الأصلية أو السلطة الفلسطينية؟
ما هي التدابير المأخوذة لضمان عدم خضوع منظمة التحرير الفلسطينية الجديدة/المجلس الوطني الفلسطيني الجديد للتلاعب الخارجي من الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهم العرب؟ أو للتلاعب الداخلي من قيادة منظمة التحرير/السلطة الفلسطينية الحالية؟
كيف يُعقل أن تعتمد المبادرات التي تتطلع إلى تحدي القيادة الفلسطينية الحالية على مكاتب تلك القيادة وممثليها من أجل تسجيل الناخبين وإجراء الانتخابات؟ أو على حسن نيتها من أجل إعادة بناء الحركة الوطنية؟
هل ستتبرأ منظمة التحرير الفلسطينية بعد إحيائها من اتفاقات أوسلو؟ وإذا كانت تلك هي النية، ماذا سيحل بالسلطة الفلسطينية وموظفيها وأسرهم الذين يعتمدون على تلك الرواتب؟ وإذا لم تكن تلك هي النية، فما هي إذن الغاية من إحياء منظمة التحرير الفلسطينية إذا ظلت مرتهنةً باتفاقات أوسلو؟
أين سينعقد المجلس الوطني الفلسطيني بعد الانتخابات؟ وكم عدد المرات التي سيجتمع فيها؟ ومن أين مصدر ستأتي ميزانيته؟ ومَن سيكون مسؤولًا عن إدارتها؟
رغم أن فكرة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بنائها وتنظيم انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني تبدو صافية النية، فإن هنالك درجةً عاليةً من عدم اليقين إزاء آثارها وتداعياتها على حقوق الفلسطينيين كما تبين هذه الأسئلة بوضوح. وإذا ما استدللنا بالتاريخ، فإن من المرجح أن تُعمِّق منظمة التحرير الفلسطينية بعد إحيائها الخلافات بين الفصائل بينما تُضفي الشرعية على قيادةٍ عقيمة لم تعد أهلًا لها. وعلاوةً على ذلك، يدرك عباس الأهمية القانونية والرمزية لألقاب منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها. لذا فقد غازل فكرة تفعيل دور المنظمة وعقدِ انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني كوسيلةٍ للتخفيف من حدة الانتقادات والتحديات التي يواجهها حكمه.
غير أن تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية يقدم درسًا مختلفًا ومسارًا بديلًا ممكنًا. فقبل عام 1967، كان يُنظر إلى منظمة التحرير الفلسطينية كأداة بيد الأنظمة العربية، ولا سيما نظام عبد الناصر في مصر، وكانت تهيمن عليها العائلات البارزة التي كان يُنظر إليها باعتبارها مسؤولةً عن التناحر السياسي الداخلي الذي ساهم في وقوع النكبة. ومع ذلك، كان معظم الفلسطينيين ولا سيما الشباب ينظرون إلى الجماعات السياسية الوليدة – حركة فتح وحركة القوميين العرب (التي غدت تُعرف لاحقًا باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) – باعتبارها أكثر استقلالًا وشرعيةً بكثير. وفي أعقاب كارثة حرب حزيران 1967، أزاحت تلك الجماعات القيادةَ الأصلية لمنظمة التحرير الفلسطينية واستولت على المنظمة.
ورغم أن هذه المقارنة التاريخية ليست دقيقةً تمامًا، فإنها إيحائية ودلالية. فإذا كان الفلسطينيون يريدون هيئةً ممثِّلةً لهم ووحدةً وطنية ونهايةً للخلافات الفصائلية وللقيادة الفاسدة وغير الشرعية، فسيتعين عليهم أن يبنوا تلك الحركة بأنفسهم من الصفر. وسيكون عليهم أيضًا أن ينبذوا الهيئة السابقة وقادتها – بغض النظر عن أصولهم الثورية وخطاباتهم وألقابهم ورمزيتهم والتعلق العاطفي بهم. فلا بد للفلسطينيين، نظرًا لماضيهم المشوب بالفشل، أن يتخيلوا مستقبلًا مختلفًا كثيرًا وأن يعملوا لأجله، وإلا فلن يكون هناك أملٌ يُذكر في إيجاد استراتيجيةٍ أو وسيلةٍ ناجعة لإحراز الحقوق الفلسطينية.
- عُرِضت نسخة من هذه الورقة باللغة الانكليزية على مؤتمر رابطة دراسات الشرق الأوسط لعام 2012.
- ترد إخفاقات الحركات الوطنية بالتفصيل في عدد من الأعمال منها كتاب أسعد غانم
“Palestinian Politics After Arafat: A Failed National Movement” (Bloomington: Indiana University Press, 2010);
وكتاب رشيد الخالدي“The Iron Cage: The Story of the Palestinian Struggle for Statehood” (Boston: Beacon Press, 2006);
وكتاب يزيد صايغ“Armed Struggle and the Search for State: The Palestinian National Movement, 1949-1993” (New York: Oxford University Press, 2000).
- See Paul T. Chamberlin, The Global Offensive: The United States, the Palestine Liberation Organization, and the Making of the Post-Cold War Order (Oxford, Oxford University Press, 2012).
- Shafiq al-Hout, My Life in the PLO (New York: Pluto Press): 242-244
- Ghanem, 72
- انظر غانم، 77 والصايغ، 658.
- See Edward Said, The End of the Peace Process: Oslo and After (New York: Vintage, 2001): 299
- Amal Jamal, The Palestinian National Movement: Politics of Contention, 1967-2005 (Bloomington: Indiana University Press, 2005): 124
- المرجع السابق
- ثمة استثناءٌ بارز يتمثل في دور ممثل منظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في الترافع بجدية عن القضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية عام 2004.
- انظر أيضًا مقالة توفيق حداد.
أسامة خليل هو مؤسس مشارك للشبكة. وهو أستاذ مشارك في التاريخ في كلية ماكسويل للمواطنة والعلاقات العامة في جامعة سيراكيوز. أسامة هو مؤلف كتاب “قصر الحلم الأمريكي: خبرات الشرق الأوسط وصعود دولة الأمن القومي” (مطبوعات جامعة هارفرد ٢٠١٦).