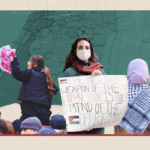مقدمة
أفضى العدوان الإسرائيلي على غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى واحدةٍ من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث، وما تزال رحى الإبادة الجماعية تدور بلا هوادة بتمكينٍ من القوى الدولية، رغم التضامن العالمي الواسع الذي أشعلته. وبموازاة القصف المستمر بلا انقطاع وعمليات النزوح الجماعي، يشن النظام الإسرائيلي حملةَ تجويعٍ ممنهجة. وقد أكد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن غزة تخطت “عتبة المجاعة” بالفعل، في ظل انتشار الجوع وسوء التغذية وتفشي الأمراض، ما أدى إلى ارتفاع حادٍّ كان يمكن تفاديه في عدد الوفيات. هذه الظروف ليست وليدة الصدفة، بل تعكس سياسةً إسرائيلية منسقة تهدف إلى قتل الفلسطينيين وتهجيرهم وإبادتهم.
وفي ردٍّ على تلك الكارثة الإسرائيلية الصنع، شَرعت عدة دول أوروبية في الاعتراف بدولة فلسطين، أو في التلويح بنيتها الاعتراف بها. وكانت آخرها فرنسا التي أعلنت نيتها الاعتراف رسميًّا بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد في أيلول/ سبتمبر المقبل. وصرّحت المملكة المتحدة كذلك بأنها قد تتخذ خطوةً مماثلة ما لم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار وبحل الدولتين. وتبدو موجة الاعترافات الرمزية التي بدأت في 2024 كأنها الخطوة الوحيدة التي أبدت قوى أوروبية عديدة استعدادها لاتخاذها في مواجهة الإبادة الجماعية، بعد قرابة عامين من دعمها المعنوي والمادي والدبلوماسي للنظام الإسرائيلي، في ظل إفلات شبه كامل من العقاب.
تَطرح هذه الحلقة النقاشية بمشاركة محلِّلات السياسات في “الشبكة”: ديانا بطو، وإيناس عبد الرازق، والمديرة المشاركة للشبكة يارا هواري الأسئلة التالية: لماذا الآن؟ وما المصالح السياسية أو الإستراتيجية وراء هذه الاعترافات؟ وماذا يعني الاعتراف شكليًّا بدولة فلسطين دون التعرض لبُنى الاحتلال والفصل العنصري والنظام الإبادي الذي يغذِّي استمرارها؟
هل يُعدُّ الاعتراف بدولة فلسطينية خطوةً مجديةً؟
ديانا بطو
من الضرورة أن نضعَ الاعترافات المتتالية بالدولة الفلسطينية في سياقها التاريخي؛ فلم ينشأ التحرك نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية ردًّا على الإبادة الجماعية التي بدأت في 2024، بل يعود إلى 2011. فبعد العدوان الإسرائيلي على غزة في 2008–2009، وجدت السلطة الفلسطينية نفسها وقد باتت خاوية الوفاض. ومع فشل مسار التفاوض لحل الدولتين وغياب أي عملية سلام مرتقبة، توجَّه الرئيس محمود عباس إلى الساحة الدولية.
إذا كان سقفُ مطالبنا السياسية في ظل الإبادة الجماعية هو 'استجداء الاعتراف بنا' فكيف لنا لاحقًا أن نعودَ إلى المطالبة بتوقيع عقوبات أو إحقاق العدالة؟ Share on Xلمَّا كان عباس يفتقر إلى إستراتيجيةٍ قابلة للتطبيق أطلقَ حملةَ الاعتراف بالدولة لهدفين: دعم السلطة الفلسطينية التي انتهى دورها كهيئة انتقالية منذ فترة طويلة، وإبراز حضورها في المشهد السياسي. فبعدما تجلى دور السلطة كذراعٍ أمنية للنظام الإسرائيلي، صارت في حاجة ملحة إلى الشرعية. وفي الوقت نفسه، منحت هذه الحملة الدولَ الأوروبية طريقةً تُجنِّبها مواجهةً مع إسرائيل تستلزم اتخاذ تدابير، مثل فرض العقوبات أو حظر التوريد.
تكرّر هذا النمط عام 2024، حيث بادرت كلٌّ من أيرلندا وإسبانيا والنرويج وسلوفينيا، وبعدهم فرنسا والمملكة المتحدة، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، ردًّا على الإبادة الجماعية الجارية. غير أن هذه الإستراتيجية تخدم مصالح السلطة الفلسطينية والدول الأوروبية؛ فهي تدعم سلطةً فقدت مصداقيتها، وتوفِّر للقوى الغربية مهربًا مواتيًا من مسؤوليتها.
والنتيجة هي مسرحٌ سياسي؛ فالاعتقاد بأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيحدث حِراكًا دوليًّا هو اعتقادٌ واهٍ. فإذا لم يتدخل العالم ليوقف إبادةً جماعية، ما الذي سيدفعه إذن للتدخل فيما هو دون ذلك وهو أن تحتل دولةٌ عضو في الأمم المتحدة دولةً عضوًا أخرى؟
إيناس عبد الرازق
إنّ ما نراه في موجة الاعترافات الأوروبية الأخيرة بالدولة الفلسطينية ليس دعمًا لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، بل مجاملة سياسية للسلطة الفلسطينية. فعلى سبيل المثال، ركّزت النرويج في اعترافها على السلطة الفلسطينية وبُناها المؤسسية. يقوِّض هذا التأطير حقّ الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ولا يلبّي حتى أبسط المعايير القانونية لقيام الدولة، فالسلطة الفلسطينية لا تمارس أي سيطرة على الحدود أو المجال الجوي أو الموارد الطبيعية أو الأرض، إذ إن إسرائيل هي التي تسيطر عليها. ومن ثمّ، جاء اعتراف النرويج موجَّهًا إلى كيان سياسي يعمل تحت السيطرة الإسرائيلية، ويفتقر في آنٍ واحد إلى السيادة وإلى الشرعية الديمقراطية.
الأدهى أنَّ مثل تلك الإيماءات الرمزية، مثل الاعتراف بالدولة تُقدَّم أحيانًا في صورة مواقف أخلاقية جريئة، لكنها في واقع الأمر لا تعدو كونها وسيلة دبلوماسية للتهرُّب من المسؤولية. حتى إن المحللين التابعين لجماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل أقروا بأن مثل هذه الخطوات لا تُغيِّر شيئًا من الواقع القائم على الأرض. ولكنها تمنح الدول فرصةً لتبدو وكأنها تحرّكُ ساكنًا بينما تتفادى فرضَ أي عقوبات أو التزامات قانونية حقيقية. وفي المقابل، يُمكِّن هذا الاعتراف السلطة الفلسطينية من التصرف كجهة تمثل الدولة، رغم افتقارها إلى التمثيل الشرعي والسيادةِ الحقة.
يتماشى كل ذلك مع الإستراتيجية الشاملة التي تتبعها إسرائيل، المتمثلة في التدمير والتجريد من الممتلكات، ثم الدفع نحو مفاوضات تفرض فيها شروطها. فمنذ اتفاقات أوسلو المبرمة في التسعينيات حتى آليات الإغاثة الإنسانية في يومنا الحاضر، حافظ النظام الإسرائيلي على سيطرته وتحكمه في مسار الأحداث، والاعتراف الرمزي بالدولة الفلسطينية يعزز هذه السيطرة. والغضب الذي أبدته الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس إلا استعراضًا سياسيًّا.
وفي هذا السياق، نجد أن الإبادة في غزة لا تُقابل بالعقاب بل بالمراسم الشكلية. وبينما تتشبث السلطة الفلسطينية بالمظاهر وتكتفي الدول الغربية بالإيماءات الرمزية، يظل الفلسطينيون بلا عدالة وبلا دولة، مع وجود فجوة متسعة بين ما يشهدونه في واقعهم اليومي وبين ذاك الاستعراض الدولي.
يارا هواري
لا بدَّ أن نكون واضحين إزاء ما تعترفُ به الدولُ فعليًّا عندما تعلن دعمَها لـ”دولة فلسطين”. فهو ليس اعترافًا بالسيادة، بل هو ضربٌ من الخيال الدبلوماسي، يُرسِّخُ في جوهره سرديةَ التقسيم الاحتلالي؛ أي تفتيت فلسطين التاريخية إلى جيوب جغرافية وسياسية.
هذه الاعترافات ليست عديمةَ التأثير فحسب، بل هي خطِرة أيضًا، إذ تعزز منطق التقسيم الضيق الذي يختزل “فلسطين” في الضفة الغربية وغزة، ويختزل الشعب الفلسطيني في أقل من نصف تعداده الحقيقي.
كما تمثل اعترافات الدول الأوروبية وسيلةً لإلهاء الرأي العام عن تواطئها مع الإبادة، إذ لا ترافقها عقوبات فعالة على إسرائيل، ولا حظر حقيقي وشامل على تسليحها، ولا التزام جاد بتفكيك الاحتلال والفصل العنصري. إن موجة الاعتراف بدولة فلسطين ليست سوى خطوات رمزية في المجال القانوني، وفي الوقت نفسه تمنح إسرائيل غطاءً يحميها من المساءلة عن جرائم الحرب والانتهاكات الممنهجة التي تقترفها.
أمّا القول بأن هذه الاعترافات تمنح الفلسطينيين إمكانية الوصول إلى المحافل الدولية، وأنها قد تُسهم في تحقيق توازن دبلوماسي، فليس إلا ادِّعاء ساذجًا ومضلِّلًا. الدول ليست سواءً في النظام العالمي، والولايات المتحدة تضمن إفلات إسرائيل من العقاب بحق الڨيتو الذي تمتلكه. وستحرص، باعتبارها الحليف الأقرب لإسرائيل، ألَّا يتفاوض الفلسطينيون يومًا من الأيام من موقعٍ متكافئ.
وهنا مكمن المشكلة بالتحديد: نحن لسنا دولة ذات سيادة، بل شعبًا محتلًّا ومحاصَرًا يواجه إبادةً جماعية في غزة. ولا بدَّ لأي حراكٍ سياسي جاد أن ينطلق من هذه الحقيقة، وليس مِن توهُّم وجود “دولة” غير موجودة فعليًّا. وبدلًا من وقف الإبادة الجماعية والتجويع المتعمد، اللذين تُسهّلهما الدولُ نفسها المعترِفة بدولة فلسطين، يُطلب منَّا التعلق بسراب الدولة الذي ما مِن أحدٍ يرغب في تحويله إلى حقيقة. ذاك التناقض يحمل في طياته الكثير.
ما الذي تكشفه موجة الاعترافات الأخيرة بدولة فلسطين بشأن التزام الدول بمسؤولياتها القانونية بموجب القانون الدولي؟
إيناس عبد الرازق
تواصلُ معظم الحكومات عملَها ضمن إطار ما يعرف بعملية السلام في الشرق الأوسط الذي عفا عليه الزمن. ولا يزال هذا الإطار يهيمن على طريقة تناول قضية فلسطين، ويؤثر في معظم التحركات السياسية الحالية، كما تجلَّى مثلًا في مؤتمر حل الدولتين الذي استضافته المملكة العربية السعودية وفرنسا في مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك؛ إذ قُدِّم الحدث بأكمله في إطارٍ يُصوِّر القضية على أنها صراع بين “طرفين”. لا يزال هذا التصوير رائجًا، كما يتضح في التصريحات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التي أكد فيها أن الحل الوحيد القابل للتطبيق يظل حلَّ الدولتين، “حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن.” وتعكس هذه اللغة تعاطيًا مع الوضع وكأنه نزاع متكافئ بين طرفين، متجاهلة واقع الاحتلال والفصل العنصري والعدوان أحادي الجانب.
إنّ ما نراه في موجة الاعترافات الأوروبية الأخيرة بالدولة الفلسطينية ليس دعمًا لحق الفلسطينيين في تقرير المصير، بل مجاملة سياسية للسلطة الفلسطينية Share on Xلم يأتِ النقاش على ذكر المحتل والدولة المحتلة، ولم يعترف بوجود طرفٍ معتدٍ وشعبٍ يتعرض للاعتداء، ولا بواقع الاحتلال والفصل العنصري. هذا التكافؤ الزائف ليس مضلِّلًا فحسب، بل هو فخٌ سياسي خطِر أيضًا.
حان الوقت لنتجاوز إطار حل الدولتين، ولا سيما أن القانون الدولي يبين الخطوات البديلة التي على الدول أن تتخذها عوضًا عن ذلك. فقد أشارت محكمة العدل الدولية في رأييها الاستشاريين الصادرين عامي 2004 و2024 إلى إطارٍ قانوني للمساءلة يقدم بديلًا للجمود السياسي الذي يفرضه إطار حل الدولتين.
إنّ الآراء القانونية التي أصدرتها المحكمة تُحمِّل المجتمع الدولي مسؤولية التحرك الفعلي، لا مجرد التوسط في النزاع. غير أن القوى العالمية ما تزال تدّعي الحياد المزعوم والتناظر الزائف، وهذا يحمي إسرائيل من العواقب ويُجنبها المساءلة. وهكذا، ما لم يتم التخلي عن إطار حل الدولتين، فإنه سيعزز إفلات إسرائيل من العقاب ويسرِّع وتيرة الإبادة الجماعية.
ديانا بطو
ما يزيد الكَدر هو أن هذا الاعتراف -على رمزيته- يظلُّ أسيرًا لمنطق المفاوضات الثنائية. فلا يزال الاعتراف محكومًا بمنطق يُلزم الفلسطينيين بالتفاوض على جميع تفاصيل تحررهم، وكأن التحرير لا بد أن يكون مشروطًا وتدريجيًّا وتحت رعاية المستعمر نفسه. ذلك هو المنطق الذي لا نزال عالقين به.
بهذه الطريقة تحديدًا، سعت أوروبا إلى التهرب من مسؤوليتها الأعمق تجاه ما يحدث. وها هي الحكومات الأوروبية ماضيةٌ في التصرف وكأنها مراقِب محايد مكتوف الأيدي، رغم أنها ليست محايدة، بل أطرافًا ثالثة فعالة، تقع على عاتقها التزامات قانونية ملزِمة بموجب القانون الدولي، تتمثل في عدم الاعتراف بالاحتلال وعدم المساعدة في استمراره والعمل نحو إنهائه، ولكنها التزامات اختارت تلك الدولُ تجاهلَها.
يارا هواري
أُفضِّل أن أرى الدول تعترف بالإبادة الجماعية على اعترافها بالدولة الفلسطينية. فالاعتراف بالإبادة الجماعية يفرض على الدول بموجب القانون الدولي أن تبذلَ قصارى ما في وسعها لمنع تلك الإبادة وإيقافها. أُدرك تمامًا أن الدول لن تنفِّذ تلك الالتزامات بالضرورة، ولكن وجود مرجعية قانونية سيوفِّر قاعدةً حقيقيةً للضغط والمساءلة.
أمّا التركيز في الاعتراف بالدولة الفلسطينية فإنه يُبرئ ذمة الدول، ويُمكِّنها من التهرب من مسؤولياتها القانونية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي الإنساني. وهو يعطي انطباعًا بوجود حراك أوروبي على مستوى الدول ضد الإبادة، من دون أن يترتب عليه أي نتائج فعلية.
وعمومًا، بُذلت جهود كبيرة من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية، بما في ذلك من قِبَل الحلفاء والمناصرين للقضية الفلسطينية، لا تتناسب والفائدة العائدة من الاعتراف. وإذا ما أردنا مواصلة التعاطي مع الإطار القانوني الدولي، فينبغي أن نصبَّ اهتمامنا على المساءلة لأنها السبيل الوحيد لوقف الفظائع الجارية في غزة وضمان عدم تكرارها مستقبلًا.
وعلاوة على ذلك، فإن الاعتراف بدولة فلسطين لا يسهم في منع تفاقم العنف، ولا يحمل الوزن أو التداعيات القانونية التي يترتب عليها الاعتراف بالإبادة الجماعية الجارية حاليًّا في غزة.
هل تستخدم أوروبا الاعتراف بالدولة الفلسطينية وسيلةً لدفع عملية التطبيع العربي الإسرائيلي؟
يارا هواري
خرجت أخيرًا سرديةٌ جديدة مفادها أن الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين قد يُمهِّد الطريقَ أمام تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل. وهكذا يغدو الاعتراف ورقةً تفاوضية لا علاقة لها بالحقوق الفلسطينية أو تحقيق العدالة، بل خدمة لحسابات جيوسياسية أوسع في المنطقة. والفكرة وراء ذلك بسيطة: كلما زاد عدد الدول الأوروبية التي تعترف بفلسطين، صار أسهل على السعودية تبرير تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
إنه منطق نفعي بحت، قائم على مقايضة رخيصة. فمثلما أشرنا سابقًا، لا يحمل الاعتراف سوى قيمةً رمزية في أحسن أحواله. ولا يضمن أي التزامات فعلية للفلسطينيين بوقف الإبادة أو إنهاء الاحتلال أو ضمان حقوقهم الأساسية والثابتة. لكن بالنسبة إلى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يوفِّر الاعتراف غطاءً سياسيًّا مناسبًا لمسعاه القديم، ألا وهو تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
أُفضِّل أن أرى الدول تعترف بالإبادة الجماعية على اعترافها بالدولة الفلسطينية. فالاعتراف بالإبادة الجماعية يفرض على الدول بموجب القانون الدولي أن تبذلَ قصارى ما في وسعها لمنع تلك الإبادة وإيقافها Share on Xوهنا تكمن خطورة الموقف، حيث تكاد الدول العربية تتخلى تمامًا عن الموقف الرافض للتطبيع الذي كان ذات يوم متجذرًا في النظرة إلى إسرائيل باعتبارها كيانًا استيطانيًّا محتلًّا يقوم على طرد الفلسطينيين وتجريدهم من ممتلكاتهم. أمّا الآن، فقد حلَّ محله نظامُ مكافآت قائمٌ على منح حوافز عسكرية أو اقتصادية أو سياسية لكل من يُطبِّع مع إسرائيل، ولا سيما من الولايات المتحدة.
تجلَّى هذا المنطق صراحةً في اتفاقات أبراهام في عام 2020. فتلك التحولات لم تنبع من تغيرات أيديولوجية، بل كانت صفقات تجارية بحتة. وفي مقابلها، لا يزال الرأي العام في مختلف أنحاء المنطقة مؤيدًا بقوة للفلسطينيين ومعارضًا للتطبيع بينما تُصرُّ الحكومات في السير في الاتجاه المعاكس.
ما نشهده اليوم هو استخدام الاعتراف بالدولة الفلسطينية كغطاءٍ سياسي، وليس كأداة لتحقيق العدالة. فالاعترافات الأوروبية بفلسطين تمنحُ الأنظمة العربية -ولا سيما النظام السعودي- المبرر الذي تحتاجه لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في الوقت الذي يواصل فيه الفلسطينيون مواجهة الإبادة الجماعية والجوع والاحتلال.
ديانا بطو
اللافت في موضوع التطبيع هو أن الإسرائيليين عمومًا لا يُبالون به، ولم يعد حاضرًا في نقاشاتهم العامة. بل إن تطبيع اتفاقات أبراهام لم يُحدِث أي صدًى يُذكر في الرأي العام الإسرائيلي. فلم تكن ثمة حماسة ولا نقاش مستفيض، بل قوبِل بلامبالاة شبه تامة.
ولم تفضِ هذه الاتفاقات إلى أي تواصل حقيقي بين الشعوب، ويمكن اعتبارها فاشلة شعبيًّا. ومن حيث المصالح بالنسبة إلى الدول التي وقَّعتها، لم يتحقق منها إلا القليل، باستثناء ما يتعلق بالتعاون الأمني والاستخباراتي، الذي يبدو أنه كان غايتها من الأساس.
أحب أن أكرر أن أنباء احتمال تطبيع العلاقات مع السعودية لا تحظى بأهمية تُذكر في الرأي العام الإسرائيلي، والتطبيع مع العالم العربي لا يعني شيئًا لمعظم الإسرائيليين ولا يكترثون له. وكلما دفع ولي العهد السعودي وزعماء أوروبا في اتجاه التطبيع، المرتبط الآن بالاعتراف الرمزي بدولة فلسطين، ازداد التطبيع بعدًا عن نبض الشارع والواقع الشعبي. تُظهر استطلاعات الرأي أن معظم الإسرائيليين يعارضون هذه الخطوات، ليس بدافع التضامن مع الفلسطينيين، بل لأنها لا تقدِّم إليهم شيئًا. فكثير من الإسرائيليين لا يستطيعون تسمية خمسة بلدان عربية، فضلًا عن إبداء أي اهتمام بالمنطقة، إذ طالما اتجهت بوصلتهم الثقافية والسياسية نحو أوروبا لا نحو العالم العربي.
فنجد أنفسنا أمام مفارقة غريبة، إذ يروِّجُ القادةُ الإقليميون والغربيون بحماسٍ للاعتراف بالدولة الفلسطينية وتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وكأن هذه الخطوات ستُحدث تحولًا جوهريًّا، بينما هي ضئيلة التأثير على أرض الواقع، سواء للفلسطينيين أو للإسرائيليين. أمّا بالنسبة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقاعدته الانتخابية، فليس لها أهمية على الإطلاق.
وهنا نعود إلى مربط الفرس: إنّ مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا تتعلق بالحلول الحقيقية أو التغيير الفعلي، بل بالمظاهر. فهي مجرد فعل استعراضي يوحي بتحرك ما من قِبَل الدول، ولكن دون أن يُفضي إلى شيء يُذكر لوقف الإبادة الجماعية.
إيناس عبد الرازق
اللافت في المرحلة الراهنة أنه حتى من منظور الدول العربية -لا سيما تلك الساعية إلى التطبيع مع إسرائيل- صار من الصعب تبرير عدم اتخاذ موقف. فالتوسع الإسرائيلي تجاوز الأراضي الفلسطينية، حيث تصاعدت العمليات العسكرية في لبنان، واحتلَّت أجزاء من جنوبه. كذلك تتواصل العمليات داخل الأراضي السورية، وأصبح ضم الجولان أمرًا واقعًا ومقبولًا في ظل إفلات إسرائيل من العقاب. هذا الواقع يضع الأنظمة العربية أمام وضع متأزم يصعب تجاهله، رغم أنه لم يفضِ إلى أي خطوات ملموسة بعد.
لقد ابتعدنا كثيرًا عن ردود الأفعال التي شهدناها إبان حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973، حين شنَّت مصر وسوريا حملةً عسكرية منسقة لاستعادة الأراضي المحتلة، وفرضت الأنظمة العربية حظرًا نفطيًّا على الولايات المتحدة وحلفائها احتجاجًا على دعم إسرائيل. تبدو تلك اللحظة من الضغط الجماعي وكأنها من الماضي السحيق. فلا تكاد اليوم توجد رغبةٌ في المواجهة، بل مجرد لفتات رمزية ودبلوماسية مراوِغة.
وبموازاة ذلك، تواصل إسرائيلُ إستراتيجيتها في التدمير الشامل؛ تُهدِّم كلَّ شيء في طريقها وتحتل الأرض وتدفع الفلسطينيين نحو الهلاك. وفي هذا السياق، بات تمرير شاحنة واحدةٍ من المساعدات إلى داخل القطاع يصوَّرُ وكأنه إنجازٌ عظيم، وقد تبنت الأنظمة العربية هذا المنطق كذلك.
ومثلما كان “السلام الاقتصادي” و”إعادة إعمار غزة” يستخدمان ستارًا سياساتيًّا في الماضي ليُداري عورة تلك الأنظمة، صارت شحنات الدقيق والوقود بديلًا لهما اليوم.
لماذا لا يزال حل الدولتين الإطارَ الأساسي لتقرير المصير الفلسطيني، وما الذي يلزم لتجاوزه؟
يارا هواري
يكمن جزءٌ من الإجابة في أن القيادة التي تتبنى هذه الإستراتيجية -أي إطار حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطينية والتقسيم- ليست قيادةً منتخبة أو مفوَّضة شعبيًّا. بل هي قيادة لا تحظى بأي شرعية حقيقية في أوساط الفلسطينيين، ولا تمثلنا بأي معنى ديمقراطي حقيقي. لذا، فمن الأهمية بمكان أن نتساءل في هذه المرحلة: ما معنى السيادة خارج منطق التقسيم والتفتيت الاستعماري؟ وكيف يمكن أن يبدو تقرير المصير إذا رفضنا منطق الاكتفاء بـ”المتاح” الذي فُرض علينا لعقود؟
يُقال لنا مرارًا وتكرارًا إنّ إقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف الدولي بها هو المسار الوحيد الممكن للمضي قدمًا. ولكن الشق الأول -أي إقامة الدولة- يظل بعيد المنال دومًا، بينما لا يتجاوز الشق الثاني -الاعتراف بها- كونه مجرد خطاب دبلوماسي أجوف. هذه الأطر “المتاحة” لا تحرِّرنا، بل تحاصرنا وتقلِّل من شأننا وتعيد صياغة نضالنا بعبارات مقبولة لدى الأطراف التي تسعى إلى استدامة الوضع السائد، لا تحقيق العدالة.
لا شك أن إجراء هذا النقاش صعب جدًّا في ظل الإبادة الجماعية الدائرة. فقد يبدو من الرفاهية أن نناقش الأفق السياسي بينما يتعرض الفلسطينيون في غزة للقصف والتجويع والقتل في كل لحظة. غير أنني أعتقد أيضًا أنّ هذا الوضع تحديدًا هو ما يفرض علينا هذا النقاش بإلحاح أكبر.
علينا نحن الفلسطينيين أن نطرح هذه الأسئلة ونوجّهها مباشرة إلى قيادتنا المزعومة، إذ لا يمكن، ولا ينبغي، أن تُحدَّد سيادتنا ضمن أُطر شُيِّدت على أساس تقسيمنا وتفتيتنا. وعلينا أن نتخيّل بديلًا، لأن ما يُقدَّم إلينا اليوم ليس تحريرًا، بل محاولة غير فعّالة لاحتواء كارثة.
إيناس عبد الرازق
يجب أن نعترف أيضًا بأن حكومات غربية عديدة ما زالت تنظر إلى إسرائيل بوصفها طرفًا حسنَ النية ضمن إطار حل الدولتين، وما انفكت تُجدِّدُ ثقتها بها رغم الكم الهائل من الأدلة التي تناقض ذلك.
بل إن إسرائيل ما تزال تُعامَل كطرفٍ صَدوق موثوق به، حتى حينما تكذب، ولطالما كان الكذب جزءًا من إستراتيجيتها الدبلوماسية والعسكرية. سواء في التستُّر على اغتيال شيرين أبو عاقلة، أو تبرير قصف المستشفيات، أو تقويض مصداقية منظمة الأونروا، فالنظام الإسرائيلي دأب على الاعتماد على سرديات زائفة لدرء المساءلة عنه. وهذا نمط ممنهج ومقصود.
ومع ذلك، ما زالت كثير من الدول الغربية تتلقّى هذه السرديات كما هي، من دون تمحيص. فهي غالبًا ما تحصل على وثائق رسمية إسرائيلية مكتوبة بالعبرية، وهي لغة يجهلها معظمُ العاملين في وزارات خارجيتها، ومع ذلك تُستقبل هذه الإحاطات بقبول غير نقدي يَفترض فيها الشرعية. وهذا لا يعبّر فقط عن انحياز سياسي، بل يعكس رؤية أعمق، غالبًا ما تكون مؤطَّرة بالتمييز العرقي: فإسرائيل تُصوَّر ككيان حديث، عقلاني، جدير بالثقة، في حين يُنظر إلى الفلسطينيين على أنهم غير عقلانيين، مشبوهين، ويمكن الاستغناء عنهم.
لن يتغير الحال ما دام هذا المنطق قائمًا. فإنِ استمر النظر إلى النظام الإسرائيلي على أنه حَسن النية، فلن تكون هناك أي مساءلة جدية له. وإلى أن يتصدى المجتمع الدولي لنمط الخداع والتوسع الاحتلالي الذي تمارسه إسرائيل، سيظل تحقيق العدالة للفلسطينيين والاعتراف بحقهم في الوجود والمقاومة بعيد المنال.
ديانا بطو
أذكر أثناء مفاوضات ما بعد أوسلو أنّ سؤالنا المتكرر كان: لماذا نقبل بتحرير مجتزأ يقتصر على 22% من أرضنا التاريخية، دولة لا تشمل معظم الشعب الفلسطيني ولا تضمن حق العودة؟
وكان الرد الذي تلقيناه آنذاك -ونسمعه يتردد اليوم- هو أن المستوطنات تُمثّل سرطانًا. هكذا وُصِفت بكونها سرطانًا. وكان المنطق السائد ذاته يقتضي لإيقاف هذا السرطان عمليةً سياسيةً ما تُبطئ توسعه وتُبقي على احتمال الدولة قائمًا.
وصار هذا المنطق يطغى على الحديث حول الاعتراف بالدولة اليوم، حيث يؤكد الدبلوماسيون ضرورةَ الاعتراف العاجل بدولة فلسطين، زاعمين أنه قد يُسهم في وقف هذا السرطان. ويقولون إنه ربما يردع ضم إسرائيل للأراضي أو يفرض حدودًا سياسية أو على الأقل يوقف الزحف الاستيطاني.
ولكننا نعلم أن هذا ليس صحيحًا؛ فلم يتصدَّ الاعتراف بالدولة لذلك السرطان. فالاعتراف مجرد لفتة رمزية تُهدر رأس المال السياسي دون المساس بهيكل القوة القائم. وفي نهاية المطاف، تحصد إسرائيل مزيدًا من الشرعية على عكس المرغوب.
كان في إمكان القيادة الفلسطينية أن تسلك طريقًا آخر. كان يسعها إطلاق حملة جادة ومستدامة لمحاسبة النظام الإسرائيلي، من خلال المطالبة بفرض العقوبات وحظر الأسلحة وتفعيل الآليات القانونية، وممارسة ضغط حقيقي.
نعم، السلطة الفلسطينية لا تمتلك شرعية انتخابية، ولكنها غير عاجزة. كان في مقدورها أن تسلك مسارًا تقاتل فيه من أجل البقاء، لا الاستسلام. لكن يبدو أنها اختارت أن تهمِّشَ أي مسعى لتحقيق العدالة، بل وأن تقوِّضه أحيانًا.
هنا يكمن جوهر المشكلة: إذا كان سقفُ مطالبنا السياسية في ظل الإبادة الجماعية هو “استجداء الاعتراف بنا” فكيف لنا لاحقًا أن نعودَ إلى المطالبة بتوقيع عقوبات أو إحقاق العدالة؟ إنّ قبول الاعتراف الرمزي باعتباره كافيًا سيُقوِّض مصداقية أي دعوات لاحقة للمساءلة الحقيقية.
يارا هواري هي مديرة الشبكة بالمشاركة. عملت سابقًا كزميلة سياساتية للشبكة في فلسطين وكمحللة رئيسية في الشبكة. نالت درجة الدكتوراه في سياسة الشرق الأوسط من جامعة إكستر، حيث درَّست مساقات مختلفة لطلاب مرحلة البكالوريوس، ولا تزال زميلة بحثية فخرية في الجامعة. يُركز عملها الأكاديمي على دراسات السكان الأصليين والتاريخ الشفوي، وهي مُعلِّقة سياسية تكتب لوسائل إعلامية عديدة مثل ذي جارديان وفورين بوليسي والجزيرة الإنجليزية.
إيناس عبد الرازق هي المديرة التنفيذية للهيئة الفلسطينية للدبلوماسية العامة (PIPD) ومنصته الرقمية Rabet ، وهي منظمة فلسطينية مستقلة تركز على التعبئة العالمية والحملات الرقمية من أجل العدالة والحرية والمساواة. من عام 2019 إلى عام 2022 ، كانت إيناس مديرة جهود الدفاع والمناصرة في PIPD، حيث ساعدت في تطوير الشبكات السياسية وركيزة المناصرة الدولية للمنظمة. قبل انضمامها إلى PIPD، شغلت إيناس مناصب استشارية في المكاتب التنفيذية للاتحاد من أجل المتوسط في برشلونة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي ومكتب رئيس الوزراء الفلسطيني في رام الله، حيث قدمت المشورة للقيادة التنفيذية بشأن المساعدات الدولية لسياسات التنمية. إيناس هي أيضًا عضو مجلس إدارة في المؤسسة الاجتماعية BuildPalestine ، وعضو المجلس الاستشاري في Palestine DeepDive، وعضوة للسياسات في الشبكة، شبكة السياسات الفلسطينية. وهي حاصلة على درجة الماجستير في الشؤون العامة من معهد الدراسات السياسية بباريس. تويتر: @InesAbdelrazek
ديانا بطو هي محامية، شغلت منصب مستشارة قانونية سابقة لوفد المفاوضات الفلسطيني. كانت واحدة من الفريق الذي ساعد في انجاح الدعوى الخاصة بالجدار امام محكمة العدل الدولية. معلقة دائمة في الشأن الفلسطيني في وسائل الاعلام العالمية الدولية مثل(CNN) و(BBC) ومحللة سياسية لقناة الجزيرة العالمية. مساهمة منتظمة في مجلة الشرق الأوسط. تمارس القانون في فلسطين، وتركز اهتمامها على القانون الدولي وحقوق الانسان.