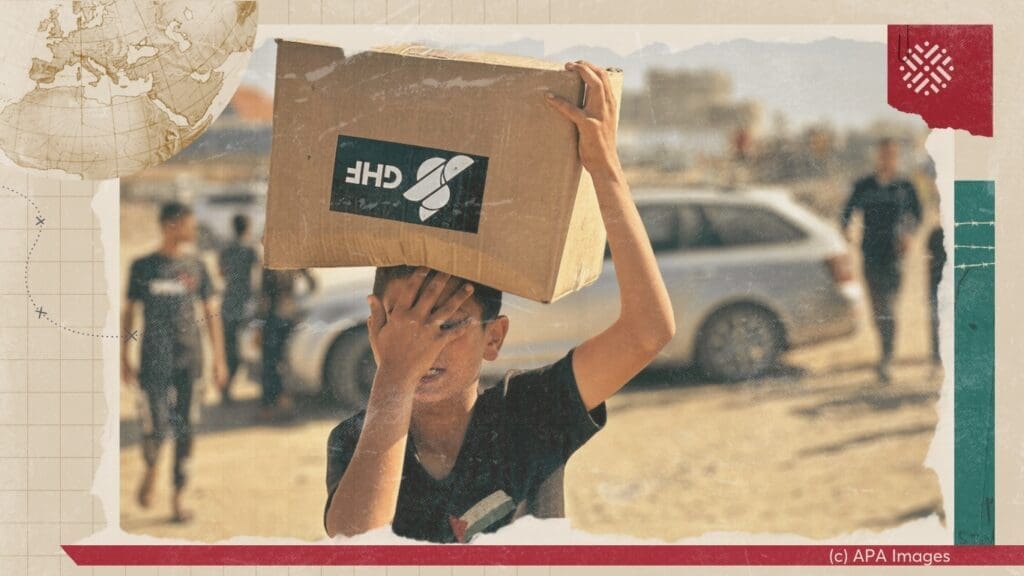ملخص تنفيذي
ما هي الرؤية الفلسطينية للتنمية التي من شأنها أن تُحقق التحرير؟ وكيف يمكن إدراك هذه الرؤية بمعزلٍ عن شروط المانحين وقيودهم؟ وعلى وجه التحديد، كيف يمكن للفلسطينيين أن يطوروا قطاعي الصحة والتعليم - المهمَليْن منذ سنوات من السلطات الفلسطينية - على نحو يُحفِّز وجودَ رؤية جماعية للمستقبل؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة قابلت المؤلفة مجموعةً من 19 باحثًا وناشطًا ومعلمًا ومهندسًا ومحاميًا وطبيبًا وتاجرًا وعاملَ إنشاءات وطالبًا في الضفة الغربية وغزة وداخل الخط الأخضر (الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل) وفي الشتات.
يمر النظام الصحي الفلسطيني في أزمة. ففي حين أن دعم المانحين مكَّن وزارة الصحة من إدخال تحسينات كمية على صعيد معدلات التطعيم ومتوسط العمر المتوقع، إلا أن القطاع الصحي لا يزال يواجه مشكلات كبرى، ليس أقلَّها انقسامُ وزارة الصحة بين الضفة الغربية وغزة. وقد كشفت المقابلات عن ثلاثة محاور مترابطة تحدُّ من التنمية الداخلية في قطاع الصحة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة: 1) الاستعانة بمصادر خارجية في توفير العديد من الخدمات الصحية، 2) وجود مؤسسة صحية أبوية وتطبيبية بشكل مفرط، 3) وغياب الفرص المستقبلية للعمل في مجال الطب.
وفي حين أن واقع الاحتلال يُقيد صحة الفلسطينيين بأساليب فريدة، فإن هناك مبادرات يمكن أن تُسهم في الارتقاء بصحة العامة وبناء نظام صحي أكثر استجابة، بما في ذلك:
- تأكيد أهمية العافية الوقائية والشاملة - بما فيها الصحة العقلية والبدنية، وصحة الأطفال، وصحة المرأة، وصحة ذوي الإعاقة - في نشر الصحة والرفاه في المجتمع.
- إصلاح التعليم الطبي ليعكس واقع الأماكن التي سيعمل فيها الأطباء المتخرجون. وفي هذه الصدد، يمكن لطب الصدمات وكذلك التدريب المتقدم للمستجيبين الأوائل وفنيي الطوارئ الطبية أن يقلل معدل الوفيات عند الفلسطينيين المصابين بسبب عنف الدولة الإسرائيلية أو المستوطنين.
- تقديم الحوافز للأطباء الفلسطينيين والعاملين في المجال الطبي المتدربين في الخارج لتشجيعهم على العودة ومزاولة الطب من خلال تأمينهم بوظيفة وراتب.
- العمل مع المؤسسة الطبية، بما في ذلك وزارتي الصحة في الضفة الغربية وغزة، لتطوير نموذج جديد ومستقل للطب والصحة العامة والعافية في فلسطين. ومن شأن ذلك إشراك أصحاب المصلحة من خارج النظام الصحي المتحجر الذين بوسعهم أن يدعموا الشرائح السكانية المحرومة، والأهم من ذلك، أن يقلصوا اعتماد الفلسطينيين على النُظم الصحية الإسرائيلية والأجنبية.
أجمعَ المقابَلون على أهمية التعليم، بيد أن بعضهم أشارَ إلى المفارقة التي نشأت في السنوات الأخيرة في واقع هذا المنظور، حيث أبناء المجتمع الفلسطيني المتعلمون لا يكادون يجدون الآن فرصةً للعمل أو مواصلة التعليم. برزت أثناء المقابلات أربعة محاور كعوائق أساسية أمام تطوير "التعليم من أجل التحرير" في الضفة الغربية وغزة: 1) المناهج والمقاربات المتقادمة في علم التربية والتعليم، 2) تأثير المانحين ونفوذهم الجامح، 3) النظرة إلى التعليم كوسيلة للحصول على وظيفة في المقام الأول، 4) ومعارضة الإصلاح داخل السلطة الفلسطينية وحماس.
انتقد العديد من المقابَلين "تقاعسَ" السلطات الفلسطينية في مجال إصلاح التعليم. وانتقدوا أيضًا نظام التعليم بسبب خضوعه الكبير لتدخلات المانحين، بما في ذلك في الكتب المدرسية. وفي حين أن أوجه القصور في نظام التعليم تتفاقم بفعل القيود الإسرائيلية المفروضة على الحركة التي تحد من فرص توظيف أعضاء الهيئات التدريسية والكوادر الأخرى، وتحدُّ من قدرة الطلبة على التفاعل مع المتحدثين والضيوف والتنقل لحضور الفعاليات واغتنام الفرص عمومًا للانخراط والعمل والمشاركة، إلا أن إحداث التغيير الداخلي ممكن في المجالات التالية:
- يجب على القيادة الفلسطينية أن تستثمر في تطوير المناهج التي تعيد الشعور بالقوة بين الطلبة، بالاعتماد على نماذج تعليمية مثل "abolitionist education" [التعليم المتحرر] والتعليم المجتمعي الذي طُبِّقَ أثناء الانتفاضة الأولى. ويجب أن يكون النظام التعليمي شاملًا للكافة، وأن يتضمن التجارب المعاشة، وأن يرفع وعي الأفراد.
- ينبغي للمجتمعات المحلية أن تُكمِّل التعليم التقليدي من خلال التعليم الثقافي مثل المسرحيات والحوارات والمناظرات وفعاليات قطف الزيتون وفرق الرقص الشعبي وما إلى ذلك.
- ينبغي مضافرة الجهود لإيجاد محتوى صحيح وموثوق على وسائل التواصل الاجتماعي لتحفيز مشاركة الشباب في تاريخهم وهويتهم.
- ينبغي للقيادة الفلسطينية أن تستثمر في التعليم المهني وغير التقليدي، وأن تدفع المانحين إلى جسر الفجوات التعليمية القائمة.
- ينبغي للقيادة الفلسطينية والمجتمع المدني الفلسطيني أن يقدموا الحوافز للفلسطينيين الذين يسافرون للخارج بغرض التعليم أو التدريب لتشجيعهم على العودة والعمل في فلسطين، حتى ولو لفترة مؤقتة.
من بين الملاحظات التفاؤلية التي ذُكرت في المقابلات فكرة أن فلسطين يمكن أن تتغير، بل وأن تكون المحور لنوعٍ جديد
من التحرير: "ينبغي لنا أن نكون مَن يحل هذه المشكلات داخليًا وأن نُصدِّر حلولنا إلى الخارج." فقد أجمعَ المشاركون في المقابلات على أن التغيير الملموس لن يأتي من الخارج، وأن على الفلسطينيين أن يمتلكوا رؤية جماعية من أجل المستقبل لإحداث هذا التغيير.
ما هي الرؤية الفلسطينية للتنمية التي من شأنها أن تحققَّ التحرير وتعتق الفلسطينيين من شروط المانحين وقيودهم؟ للإجابة عن هذا السؤال قابَلت المؤلفة مجموعةً من 19 باحثًا وناشطًا ومعلمًا ومهندسًا ومحاميًا وطبيبًا وتاجرًا وعاملَ إنشاءات وطالبًا في الضفة الغربية وغزة وداخل الخط الأخضر (الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل) وفي الشتات.1
بالرغم من تنوع المشاركين واختلاف مشاربهم، إلا أنهم تشاركوا في قلقهم إزاء افتقار الفلسطينيين إلى الرؤية، وما يترتب على ذلك من صعوبة تخيلِ مستقبلٍ مغاير للواقع الحالي حيث التنمية والمساعدات مشروطة بالتزام السلطات الفلسطينية بمتطلبات مجتمع المانحين الدولي. فمنذ إبرام اتفاقات أوسلو في 1993، ظل نموذج التنمية في الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) وغزة يولي الأولوية لأجندات المانحين السياسية على حساب حقوق الفلسطينيين واحتياجاتهم. يمكن لغياب الرؤية أيضًا أن يؤدي إلى اللامبالاة والانفصام عن الواقع، كما قال أحد المقابلين متحسِّرًا: “يتحول الشعور بطريقة ما إلى كرهٍ تجاه البلد – وفي مرحلة معينة، تتساءل، لماذا أتمسَّك بهذا المكان بهذا القدر إذا كنت لا أستطع أن أبقى على قيد الحياة فيه، ناهيك عن أن أزدهر؟”
تَقصَّينا في هذه المقابلات الإمكانيات والمعوقات التي تواجهها الرؤية الإنمائية ذات القيادة المحلية في قطاعي الصحة والتعليم. فالصحة حاجةٌ أساسية وحقٌ إنساني، ومن غير المرجح أن يمتلكَ الشعب الذي يعاني من أجل الحصول على الخدمات الصحية الأساسية القدرةَ الذهنية والبدنية للاضطلاع بالأعمال التي يقتضيها التحرر. التعليم أيضًا حقٌ إنساني، والشعب المتعلم يكون أقدر على التفكير المتعمق والإبداعي في المشكلات التي يُخيَّلُ أنها عصيةٌ على الحل. وهذان القطاعان مترابطان، فالأصحاء أقدر على التعلم، والمتعلمون سيكونون على الأرجح أصحاء. غير أن هذين القطاعين لا يجدان اهتمامًا يُذكر من السلطات الفلسطينية التي تفرط في الإنفاق على قطاع الأمن. ولذلك ظل الاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم راكدًا في السنوات الأخيرة.
تُعرض نتائج هذه المقابلات وما يلحقها من تحليل في هذه الورقة السياساتية كشرحٍ سردي متبوعٍ بخطوات عملية مقترحة يمكن أن يتخذها الفلسطينيون داخل الضفة الغربية وغزة دون مساعدة من جهات خارجية، ويتخلل السردَ اقتباساتٌ من المقابلات. لا تستبعد هذه الورقة دورَ الاحتلال والحصار والصدمات وغياب المساءلة في استدامة هذا الوضع السيء للفلسطينيين. ولا تتجاهل العجزَ الوظيفي الفلسطيني الداخلي على كافة المستويات، بما في ذلك الفساد والمحسوبية والتبعية الاقتصادية التي تمنع القيادة الفلسطينية من إيلاء الأولوية لاحتياجات الشعب الفلسطيني. غير أنها تسعى إلى إعادة زمام الفعل إلى الفلسطينيين في صراعهم مع الواقع الراهن فالقرار بشأن مستقبلهم يجب أن يكون قرارًا مستقلًا وجماعيًا.
مقاربة فلسطينية تجاه الصحة والتعليم
الصحة
قال طالب جامعي من غزة أثناء المقابلات: “إنه لأمر مخيف أن تدرك في لحظةٍ ما أنك قد تموت بسبب نظام الرعاية الصحية الفاسد. فرُبَّ مرضٍ يمكن لأي بلد أن يتعامل معه، إلا بلدي يعجز عنه.” هذه حال النظام الصحي الفلسطيني الذي ظل خاضعًا لإدارة وزارة الدفاع الإسرائيلية منذ 1967 وحتى إنشاء وزارة الصحة الفلسطينية عند توقيع اتفاقات أوسلو في عام 1993.
ورثت وزارة الصحة نظامًا معطلًا لا يزال مجزأ حتى هذا اليوم. وبدعم من المانحين، تمكنت الوزارة من إدخال تحسينات كمية على صعيد معدلات التطعيم ومتوسط العمر المتوقع، بالرغم من انقسامها إلى وزارتين في الضفة الغربية وغزة على خلفية الانقسام السياسي بين حركة فتح وحركة حماس. وفيما يتعلق بالمحددات الاجتماعية للصحة، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين ما هو مطلوب وما هو متاح. فقد كشفت المقابلات عن ثلاثة محاور مترابطة تحدُّ من التنمية الداخلية في قطاع الصحة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة: 1) الاستعانة بمصادر خارجية في توفير العديد من الخدمات الصحية، 2) وجود مؤسسة صحية أبوية وتطبيبية بشكل مفرط، 3) وغياب الفرص المستقبلية للعمل في مجال الطب.
ورثت وزارة الصحة (الفلسطينية) نظامًا معطلًا لا يزال مجزأ حتى هذا اليوم Share on X
ذكرَ جميع العاملين في مجال الطب والصحة العامة الذين تمت مقابلتهم موضوع الاستعانة بمصادر خارجية كأحد العقبات الرئيسية التي تعوق الصحة الفلسطينية، وهو سببًا ونتيجةً لغياب التنمية الفلسطينية في قطاع الصحة. تُعزى العديد من دواعي الاستعانة بمصادر خارجية إلى القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة الفلسطينيين وبضائعهم. وقد أشار طبيب متقاعد كان يعمل في مدينة نابلس إلى افتقار الضفة الغربية وغزة إلى التخصصات الطبية بالرغم من تدريب بعض الفلسطينيين في الخارج: “لا يمكنك استقطاب ذوي الخبرة. فالفلسطينيون ذوو التدريب العالي الذين يحاولون العودة ينتهي بهم الأمر إلى الهجرة مرةً أخرى، لأن بإمكانهم أن يتقاضوا رواتب أعلى وأن يتمتعوا بنوعية حياة أفضل خارج فلسطين. وقد حاولنا أن نعثر على جراح قلب للأطفال – وكان ذلك شبه مستحيل.” وفي حين أن أسباب هجرة الأدمغة تتباين من منطقة إلى منطقة في فلسطين المستَعمرة، إلا أن الثغرات التي تُخلِّفها هذه الظاهرة في نظام الرعاية الصحية لها الآثار السلبية نفسها.
هناك العديد من التخصصات المفقودة كليًا، ولكن ليس بسبب قلة الاهتمام. “هناك مَن يرغب في التخصص أو العمل في أدوار طبية إدارية – ولكن كيفَ وأينَ يمكنك أن تتدربَ لتصبح جراح أعصاب؟” كما قال الطبيب المتقاعد. ويصفُ مشاركٌ آخر في المقابلات كيف أن مبادرةً تابعةً لإحدى المنظمات غير الحكومية سعت لتوظيف أطباء إبان الجائحة، ولكن المتقدمين كانوا كلُّهم تقريبًا من غير المتخصصين، وكان بعضهم يفتقر حتى إلى الخبرة. وهكذا لم يتمكنوا من خدمة مَن كان بحاجةٍ إلى رعاية أكثر من الرعاية الأساسية.
ونتيجة لذلك حتى الفحوص المخبرية تُرسَلُ إلى إسرائيل لتحليلها. تنطوي الاستعانة بمصادر خارجية على استخدام نظام التصاريح الطبية الذي رسَّخ الاعتماد على النظام الطبي الإسرائيلي الذي يديره الجيش الإسرائيلي وتدفع ثمنه السلطات الفلسطينية. وقد أفضى هذا النظام إلى تفاوتات صحية كبيرة ونتائج سيئة، ولا سيما بالنسبة إلى الفلسطينيين في غزة. وفي نهاية المطاف، التبعية تولِّد التبعية، وتفشل السلطات الفلسطينية ومجتمع المانحين باستمرار في الضغط لنيل السيادة الفلسطينية في مجال الصحة بسبب توفر البديل الأسهل وهو الاستعانة بمصادر خارجية.
وُجِّهت الانتقادات أيضًا في العديد من المقابلات إلى طابع المؤسسة الطبية الفلسطينية. فقد أدى إنشاء وزارة الصحة الحالية إبان عملية أوسلو إلى ازدراء الطب المحلي، حيث بُني النظام الصحي على غرار النظم الصحية الغربية التابعة لمانحيه والتي تؤمِن بالكفاءة على حساب الجودة، والرأسمالية على حساب الجماعية، والأبوية على حساب احتواء الكافة. يصف أحد الأطباء الوضع في السابق بقوله: “قبل أوسلو، كان الجو العام أننا تحت الاحتلال، وفي مركب واحد، ولا تمييز بيننا. كان الناس يساعدون بعضهم وكان مستوى التعاطف أكبر. أمّا الآن، فهناك التنافس والاستغلال، حتى في قطاع الصحة، حيث المستشفيات تستهدف جني المال، بينما كان الاختصاصيون في الماضي يعملون تطوعًا. لقد اختفى هذا الجو.”
يتسم هذا النظام أيضًا بمغالاته في الطب الأحيائي، ونادرًا ما يُراعي الجوانب النفسية والاجتماعية للصحة خارج إطار المنظمات المحلية التي تعمل على دعم الصحة النفسية والعقلية. وبحسب أحد طلاب الدراسات العليا في السياسة الصحية، فإن النظام الصحي الفلسطيني “لا يعترف بشرعية الصحة العامة وعلم الأوبئة وهو ليس شاملًا. تنشط الفعاليات والحملات مرةً واحدة فقط في السنة للتوعية بسرطان الثدي. هذه هي الصحة العامة في فلسطين. وهذا النظام لا يتطرق إلى العافية مطلقًا. هل هذا المجتمع يتمتع بالعافية؟ كلا.”
أثارَ أحدُ المقابَلين كذلك مسألةً مهمة تتمثل في قلة العاملين في المجال الطبي، ولا سيما في غزة. وقال مُحذرًا: “ليس لدينا حتى العناصر الأساسيين كي يضمنوا استمرار نظام الرعاية الصحية بعد تقاعد الجيل الحالي من الأطباء.” يُواجه الأطباء العاملون في القطاع العام خطر تقليص أجورهم أو عدم استلام رواتبهم لفترات طويلة، ولذلك يتجهون إلى العمل في القطاع الخاص كلما استطاعوا. يقول أحد المقابَلين إن مشاركًا واحدًا فقط في برنامجٍ مشترك بين كلية طب مرموقة في الولايات المتحدة وجامعة القدس عاد إلى فلسطين، ولكنه لم يجد فرصة للعمل كطبيب مقيم وهو يعمل ممرضًا في الوقت الحاضر. “الجميع يبحث عن فرصة في الغرب.”
انخرط العاملون في الصحة العالمية في السنوات الأخيرة في نقاشات شائكة حول إنهاء الاستعمار. واقترح أحد المقابَلين أن فلسطين أقدر من غيرها على أن تكون نموذجًا لتلك الحركة في ميدان الصحة العالمية، كما كانت في الماضي نموذجًا لحركات تحررية ومناهِضة للاستعمار. وفي حين أن واقع الاحتلال يُقيد صحة الفلسطينيين بأساليب فريدة، فإن هناك مبادرات يمكن أن تُسهم في الارتقاء بصحة العامة وبناء نظام صحي أكثر استجابة، بما في ذلك:
- تأكيد أهمية العافية الوقائية والشاملة – بما فيها الصحة العقلية والبدنية، وصحة الأطفال، وصحة المرأة، وصحة ذوي الإعاقة – في نشر الصحة والرفاه في المجتمع. سيؤدي ذلك إلى تقليل الاعتماد على الخدمات الصحية المتقدمة المتاحة خارج الضفة الغربية وغزة فقط، وسيتطلب توظيف قوى عاملة أكثر تنوعًا وتمثيلًا.
- إصلاح التعليم الطبي ليعكس واقع الأماكن التي سيعمل فيها الأطباء المتخرجون. من شأن طب الصدمات وكذلك التدريب المتقدم للمستجيبين الأوائل وفنيي الطوارئ الطبية أن يقلل معدل الوفيات عند الفلسطينيين المصابين بسبب عنف الدولة الإسرائيلية أو المستوطنين. ينبغي توفير التدريب في مجال الصحة النفسية والمحددات الاجتماعية للصحة على مستويات التعليم الصحي المختلفة، بما في ذلك من خلال إيلاء الأولوية للاحتفاظ بالأخصائيين الطبيين. ينبغي أيضًا توفير تدريب أكبر للممرضات والقابلات والمعالجين الوظفيين والفيزيائيين والقائمين على صحة المجتمع لضمان توفير الرعاية المحلية بجودة عالية، حتى في أوقات تقييد الحركة. يمكن أيضًا اعتماد خدمات الرعاية الصحية المتلفزة والرسائل النصية لأغراض الفرز الطبي في أوقات تقييد الحركة أو لتوفير المعلومات والخدمات حول مواضيع حساسة مثل العنف المنزلي والصحة النفسية.
- تقديم الحوافز للأطباء الفلسطينيين والعاملين في المجال الطبي المتدربين في الخارج لتشجيعهم على العودة ومزاولة الطب من خلال تأمينهم بوظيفة وراتب. وينبغي تقديم حوافز إضافية إذا تمكَّن هؤلاء من تدريب طلاب الطب في فلسطين. ولا بد من إدراك التحديات التي تسببها هجرة الأدمغة، ولذا ينبغي تخصيص التمويل الرسمي من الدولة ومن موارد المانحين لمكافحة هذه الظاهرة على وجه التحديد.
- العمل مع المؤسسة الطبية، بما في ذلك وزارتي الصحة في الضفة الغربية وغزة، لتطوير نموذج جديد ومستقل للطب والصحة العامة والعافية في فلسطين، يعمل على إشراك أصحاب المصلحة من خارج النظام الصحي المتحجر الذين بوسعهم أن يدعموا الشرائح السكانية المحرومة، والأهم من ذلك، أن يقلصوا اعتماد الفلسطينيين على النُظم الصحية الإسرائيلية والأجنبية.
التعليم
أكد المُقابَلون كلُّهم أهميةَ التعليم، وهذا ليس مستغربًا على المجتمع الفلسطيني الذي دأب على تبجيل قيمة العلم والتعلم. غير أن البعض أشار إلى المفارقة التي نشأت في السنوات الأخيرة في الواقع العملي لهذا المنظور، حيث لا يكاد أبناء المجتمع الفلسطيني المتعلمون يجدون الآن فرصةً للعمل أو مواصلة التعليم. حدَّد التحليل أربعةَ محاور كعوائق أساسية أمام تطوير “التعليم من أجل التحرير” في الضفة الغربية وغزة: 1) المناهج والمقاربات المتقادمة في علم التربية والتعليم، 2) تأثير المانحين ونفوذهم الجامح، 3) النظرة إلى التعليم كوسيلة للحصول على وظيفة في المقام الأول، 4) ومعارضة الإصلاح داخل السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة.
التبعية تولِّد التبعية، وتفشل السلطات الفلسطينية ومجتمع المانحين باستمرار في الضغط لنيل السيادة الفلسطينية في مجال الصحة بسبب توفر البديل الأسهل وهو الاستعانة بمصادر خارجية Share on X
يقوم نظام التعليم الفلسطيني على بقايا النظامين المصري والأردني الذيْن كانا ساريين في غزة والضفة الغربية، على التوالي، في الفترة بين 1948 و1967. وحتى إبان العقود الأولى من الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وغزة، وقبل إبرام اتفاقات أوسلو، ظلَّ هذان النظامان ساريين، ولكن تحت سلطة الإدارة المدنية الإسرائيلية التي قَصقَصتها وأخضعتها لرقابة شديدة، ومارست على المدارس إغلاقات واعتداءات متكررة. تخلَّف نظام التعليم الفلسطيني بجميع مستوياته من المرحلة الابتدائية وحتى التعليم العالي بسبب الجهود الإسرائيلية المبذولة لتقليل قيمته، ما دفع العديد من الفلسطينيين إلى البحث عن فرص عمل وضيعة في إسرائيل.
نشأت مع تأسيس السلطة الفلسطينية سنة 1994 وزارةٌ فلسطينية رسمية للتربية والتعليم، افتقرت إلى السيادة، وورثت نظامًا تعليميًا ضعيفًا، ولكنها أحدثت تغييرات كبيرة في المناهج الدراسية وجدَّدت المرافق المدرسية بفضل الدعم المالي السخي المقدَّم من المانحين. وفي عهد وزارة التربية والتعليم (المنقسمة كما وزارة الصحة بين حكومة حماس في غزة والسلطة الفلسطينية بقيادة فتح في الضفة الغربية)، زادت معدلات محو الأمية ونسب الالتحاق بالمدارس، على غرار التقدم الكمي المحرَز في القطاع الصحي. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين النظام التعليمي القائم والنظام الذي من شأنه أن يُسهم في إحداث تحسينات ملموسة في حياة الفلسطينيين.
انتقد المقابَلون، ومعظمهم من خريجي النظام التعليمي الفلسطيني، “تقاعسَ” السلطات الفلسطينية في مجال إصلاح التعليم، ولا سيما في السنوات الأولى من مرحلة أوسلو. فالعديد منهم لا يتفق مع نموذج الحفظ والاسترجاع المتبع في التعليم الابتدائي والثانوي ولغاية مرحلة التوجيهي المبنية على النظام الأردني وهي عبارة عن امتحان موحد يختم بها الطالب حياته المدرسية. بل إن أحدًا من المقابَلين لم يدافع عن هذا النموذج لأنه يستديم الانقسامات الطبقية، ويضع على كاهل الطلبة وأسرهم ضغطًا هائلًا، ويتسبب للطالب بخزي اجتماعي إنْ أخفق فيها. وفي حين أن طلبة المدارس الخاصة مقتدرون على الدروس الخصوصية أو قد تتوفر لهم فرصٌ أخرى، فإن تدني معدل الطالب في امتحان التوجيهي يُمكن أن يكون مُجحفًا ولا سيما لطلبة المدارس الحكومية.
لا يكافئ التوجيهي التفكير الابداعي والابتكار، وإنما يقيس قدرة الطالب على أداء امتحان رتيب للغاية ضمن مهلة زمنية ضيقة. ومَن يُحرز معدلًا عاليًا في امتحان التوجيهي هو فقط مَن يستطيع التقدم بطلب للالتحاق بالتخصصات المرموقة في الجامعات، مثل الطب والهندسة. وهذا يخلق مشكلةً أخرى، بحسب أحد المقابَلين، لأن “الطلاب الأذكى ليسوا بالضرورة مَن يُحرز أعلى العلامات في التوجيهي، وفجأةً يصير مستقبلهم برمته ومكانتهم في مجتمعهم المحلي مرهونًا بهذا الامتحان.”
يعتقد العديد من المقابَلين بأن السلطات الفلسطينية، إضافةً إلى افتقارها إلى الرؤية، متخوفةٌ كثيرًا من استجابة المجتمع الدولي إزاء إجراء إصلاحات ملموسة في نظام التعليم. وهذا هو المعوق الثاني: رضوخ النظام التعليمي لتدخلات المانحين. يقول أحد المقابَلين: “يمكن للتعليم، وينبغي له، أن يركز على التحرير والنضال والتاريخ – ولكن المانحين يركزون على الوظائف.” وهذا يشمل التدخل في المناهج الدراسية نفسها، حيث يقول مشاركٌ آخر في المقابلات: “يوجد في فلسطين مِن الكفاءات مَن يستطيع تصميم المناهج، غير أن الفلسطينيين لا يملكون حرية القرار بشأن الموضوعات التي ينبغي تدريسها.”
تهاجم المنظمات الصهيونية في كثير من الأحيان الكتبَ المدرسية الفلسطينية، ولذا فإن المانحين حريصون على استبعاد أي “مضمون سياسي” متصوَّر من الكتب المدرسية والمدارس التي يدعمونها. وكمثال لذلك، يقول أحد المقابَلين إن نصوصًا في كتبٍ مدرسية في غزة تغيرت نزولًا عند طلب المانحين لأنها ذكرت الأسماء العربية لمدن فلسطينية تقع داخل الخط الأخضر. لقد أدت تدخلات المانحين في التعليم إلى تسريع التوجه نحو التركيز على القيم الفردية مقابل القيم الجماعية، فكما قال أحد خريجي المدارس الحكومية: “لا تنتظر من الدولة أن توفر لك الخدمات، بل عليك أن ترعى نفسك اقتصاديًا.”
أما بالنسبة إلى التعليم العالي، فقد أشار الأساتذة الجامعيون العاملون والمتقاعدون الذين تمت مقابلتهم إلى أن التعليم الجامعي ليس بالقوة التي ينبغي أن يكون عليها أو التي كان عليها في السابق، وأنه يعتمد بشدة على المحاضرات على حساب أساليب التدريس الأخرى الأكثر ابداعًا. وعلى حد قول أحد الأساتذة: “التعليم الجامعي لا يركز على تحفيز الشباب – شحنهم بأفكار مختلفة وفرصٍ للعمل الميداني مثل إجراء استطلاعات الرأي – ولا يركز على دفعهم إلى التفاعل النقدي مع المادة العلمية.”
يتأسفُ أستاذٌ متقاعد، كان يعمل في جامعة فلسطينية قبل الانتفاضة الأولى، على التحول الذي حدث أثناء عمله في الوسط الأكاديمي: “في عقد الثمانينات، كان هناك توجه نحو التفكير النقدي لأننا لم نُرِد للجامعة أن تكون مكانًا لتلقين المعلومات. ولكن في عقد التسعينات، غدت الجامعات شبيهةً ’بالجامعات العربية‘ عمومًا من حيث تدخل السلطات السياسية في قراراتها.” وأشار إلى أن الكثيرين من الطلاب والأساتذة “الأفضل والأذكى” بدأوا يسافرون بحثًا عن فرصٍ في الخارج، وصار للشهادات من الولايات المتحدة وأوروبا قيمةٌ أعلى بكثير من الشهادات المكتسبة من مؤسسات تعليمية فلسطينية أو حتى عربية.
لا تزال هناك فجوة كبيرة بين النظام التعليمي القائم والنظام الذي من شأنه أن يُسهم في إحداث تحسينات ملموسة في حياة الفلسطينيين Share on X
تكمن المسألة الأخرى في النظرة إلى التعليم، ولا سيما التعليم العالي، بوصفه الوسيلة الأساسية للظفر بوظيفة، بالرغم من الأدلة الصريحة التي تُثبت عكس ذلك. وقد أسفرت هذه النظرة عن تنامي القيم الفردية والنيوليبرالية التي كانت أقل حضورًا في السنوات الأولى للاحتلال، وتسببت أيضًا في كبت روح الإبداع. وفي أثناء المقابلات، تساءَل أحدُ المشاركين: “ما الغاية من التعليم؟ لقد انتقلنا من التعليم المتمحور حول نيل الحرية والانعتاق والتمكين إلى التعليم المصمم لتعليم الطلبة كيفية الفوز بوظائف لا توجد أصلًا في فلسطين.”
أشار العديد من المقابَلين إلى افتقار سوق العمل في فلسطين إلى حرفيين في مهن وحرفٍ معينة، وإلى محدودية فرص التعليم المهني المتاحة لملء تلك الوظائف الشاغرة. وأشاروا أيضًا إلى الافتقار إلى الابداع في التجربة اللامنهجية وكيف أن ذلك يُثبط التنمية في هذا المجال. “لا توجد مساحات خضراء، ولا أماكن للتعبير عن نفسك، ولا حيز يمنحك الإلهام، ولا حيز للتنظيم. وهذا يُحبط معنويات الناس.”
كانت كبرى الجامعات في فلسطين، مثل جامعة بيرزيت، توفر أرضًا خصبة للصحوة السياسية والتفكير النقدي في السابق. أما الآن، بحسب العديد من المقابَلين، فإن التعيينات السياسية غير المقيَّدة داخل المؤسسات التعليمية، والتدخلات السافرة من مجالس الأمناء وغيرها من الهيئات غير الأكاديمية، والإحباط في أوساط الهيئات التدريسية والموظفين إزاء تعطُّل الأشغال والمصالح “ما لم تكن لديك واسطة” دفعت الجامعات للحد من إسهاماتها في المجتمع المحلي. يقول أحد الأكاديميين: “ينبغي للجامعة أن تؤثر في المجتمع، ولكن المدينة هي مَن صارَ يدير الجامعة،” وباتت الجامعات بموجب هذه الحال مقيدةً بفعل سياسة الهيئات الحاكمة. وعلاوةً على ذلك، حين يحاول الطلبة الانخراطَ في العمل السياسي أو التفكير من منظور إبداعي وتحدي الأعراف السائدة، فإنهم يغدون عرضةً للاعتقال والاحتجاز والسجن إمّا على يد السلطات الفلسطينية أو الإسرائيلية.
يقودنا هذا إلى المعوق الأخير، ألا وهو معارضة السلطات الفلسطينية لإجراء إصلاحات تعليمية في أي مستوى دراسي. وقد عبَّر عن ذلك أحد المقابَلين بقوله: “لا تريد السلطة الفلسطينية للطلبة أن يمتلكوا منظورًا نقديًا في التفكير أو معرفةً أساسيةً بتاريخهم وهويتهم، فالكثير من الفلسطينيين الشباب ضائعون حقًا.” وكما هي الحال مع النظام الصحي، تفتخر السلطات الفلسطينية بما حققته من تحسينات كمية على صعيد محو الأمية ونسب الالتحاق بالمدارس، ولكنها “لا تفعل أكثر من ذلك حين يتعلق الأمر بالتعليم.” وقد أشار أحد المقابَلين إلى التخلف المتعمد الذي تمارسه السلطة الفلسطينية في مجال التعليم: “لقد وصل النظام التعليمي إلى ما وصل إليه لأن السلطةَ الفلسطينية أداةٌ استعمارية. وفي حين أنها قد تُحدِث بعض الإصلاحات، إلا أنها لن تكون جذرية أبدًا.”
يؤثر الاحتلال بشدة في النظام التعليمي الفلسطيني بمستوياته كافة. فالكثير من أوجه القصور المشار إليها أعلاه تتفاقم بفعل القيود الإسرائيلية المفروضة على الحركة التي تحدُّ من فرص توظيف أعضاء الهيئات التدريسية والكوادر الأخرى، وتحدُّ من قدرة الطلبة على التفاعل مع المتحدثين والضيوف والتنقل لحضور الفعاليات واغتنام الفرص عمومًا للانخراط والعمل والمشاركة. ومع ذلك، ثمة مجالات يمكن إجراء تغييرات داخلية فيها:
- يجب على القيادة الفلسطينية أن تستثمر في تطوير المناهج الدراسية التي تعيد الشعور بالقوة بين الطلبة، على غرار نماذج تعليمية مختلفة مثل “abolitionist education” [التعليم المتحرر] أو التعليم المجتمعي الذي طُبِّقَ أثناء الانتفاضة الأولى. ويحتاج ذلك إلى التصدي لوجهات نظر المانحين إزاء ما ينبغي تدريسه، والانتقال من نموذج الحفظ والاسترجاع التقليدي إلى نموذج قائم على التفكر والتطبيق في مسائل عملية ذات صلة، وإصلاح نظام التوجيهي أو إلغاؤه بالكامل. يجب أن يكون النظام التعليمي شاملًا للكافة، وأن يتضمن التجارب المعاشة، وأن يرفع وعي الأفراد.
- ينبغي للمجتمعات المحلية أن تُكمِّل التعليم التقليدي من خلال توفير التعليم الثقافي بما في ذلك من خلال المسرحيات والحوارات والمناظرات وفعاليات قطف الزيتون وفرق الرقص الشعبي وما إلى ذلك، بهدف استعادة التفكير الجماعي وتعزيز الهوية الفلسطينية في نفوس الشباب وتوفير منافذ للتعبير الإبداعي.
- ينبغي مضافرة الجهود لإيجاد محتوى صحيح وموثوق على وسائل التواصل الاجتماعي لتحفيز مشاركة الشباب في تاريخهم وهويتهم. فبحسب أحد المقابَلين: “الفيسبوك هو المقصد الرئيسي لمعرفة الأخبار واكتساب المعرفة والتعلم.”
- ينبغي للقيادة الفلسطينية أن تستثمر في التعليم المهني وغير التقليدي، وأن تدفع المانحين إلى جسر الفجوات التعليمية القائمة. وهذا من شأنه أن يسمح للفلسطينيين بتلبية احتياجات المجتمع من العاملين وزيادة فرص العمل المتاحة التي تستبقي رأس المال الاجتماعي، لأن فلسطين بحاجةٍ إلى سباكين وكهربائيين وميكانيكيين وخبراء تجميل وغيرهم من المختصين الذين لا يحتاجون إلى تعليم جامعي. ومن شأن ذلك أيضًا أن يخلق مساحةً للعمالة الحرفية غير المعتمِدة على فرص العمل في إسرائيل.
- ينبغي للقيادة الفلسطينية والمجتمع المدني الفلسطيني أن يقدموا الحوافز للفلسطينيين الذين يسافرون للخارج بغرض التعليم أو التدريب لتشجيعهم على العودة والعمل في فلسطين، حتى ولو لفترة مؤقتة. وينبغي تقديم الحوافز المادية وغير المادية للمواطنين للعودة والعمل في فلسطين كشكلٍ من أشكال “الخدمة العامة،” بحسب اقتراح أحد المقابَلين.
فلسطين كنموذج للتحرير
من بين الملاحظات التفاؤلية التي ذُكرت في المقابلات فكرة أن فلسطين يمكن أن تتغير، بل وأن تكون المحور لنوعٍ جديد من التحرير: “ينبغي لنا أن نكون مَن يحل هذه المشكلات داخليًا وأن نُصدِّر حلولنا إلى الخارج.” ولكن هل من المعقول إلقاءُ عبء التنمية على كاهل شعب محتَل ومستَعمر؟ لم يجد المقابَلون إجابةً سهلةً على هذا السؤال، ولكنهم أجمعوا على أن التغيير الملموس لن يأتي من الخارج وأن هذا التغيير لا بد أن يقترن برؤية واضحةٍ وجماعية إزاء المستقبل. وبحسب أحد المقابَلين: “حين يعرف الشعب وجهته، فإنه يُبهرك بتضحياته، وحين يجهلُ وجهته، فإنه لن يكترث البتة.”
وبالنسبة إلى الرؤية المستقبلية، تساءَل أحدُ المقابَلين: “هل هدفنا أن نحقق التنمية ونبني الاقتصاد لأجل أن نعيش أم لأجل نتحرر؟ إذا كان التحررُ مرادَك، فعليك أن تدرك بأنك لن تكون في بحبوحةٍ اقتصادية كما لو كان مرادك أن تعيش وحسب.” وفي نهاية المطاف، “سيحدث شيء ما” كما قال أحد المقابَلين، “وستنكسر هذه العجلة، وعلينا أن نكون مستعدين. علينا أن نبتدع شيئًا جديدًا تمامًا – حركة وطنية جديدة. فنحن نحيا في عصر جديد ولدينا تكنولوجيا جديدة واقتصاد من نوعٍ جديد. والفلسطينيون متواجدون في كل أنحاء المعمورة، ولا بد أن نكون مبدعين في تفكيرنا.”
- لقراءة هذا النص باللغة الفرنسية، اضغط/ي هنا تسعد الشبكة لتوفر هذه الترجمات وتشكر مدافعي حقوق الإنسان على هذا الجهد الدؤوب، وتؤكد على عدم مسؤوليتها عن أي اختلافات في المعنى في النص المترجم عن النص الأصلي.