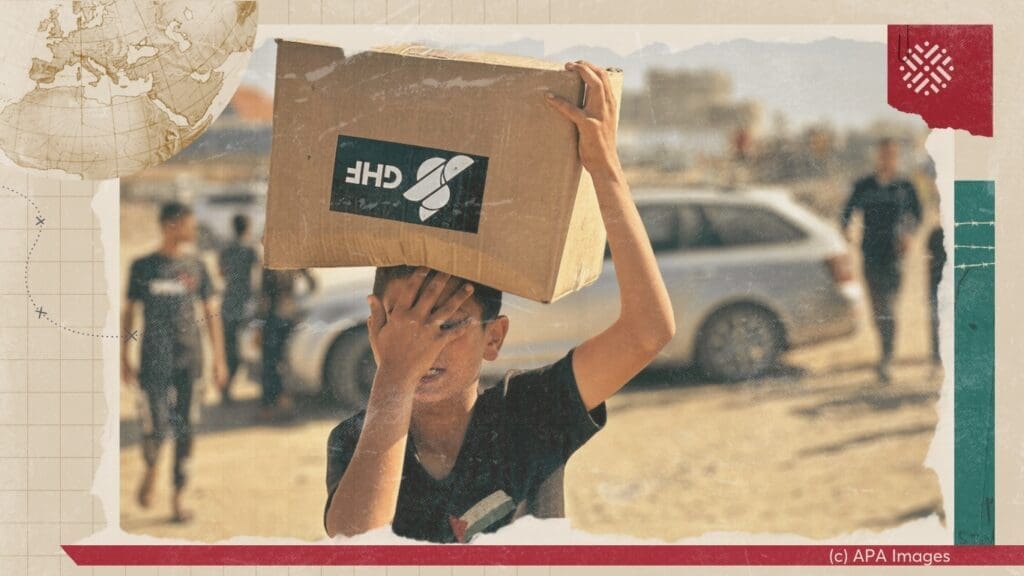لمحة عامة
ثلاثة عشر عامًا مضت على اكتشاف حقول الغاز قبالة شواطئ غزة ولا تزال الجهود المبذولة لتطويرها متعثرةً إلى اليوم رغم الدعم الدولي الذي يحظى به المشروع. وفي الوقت نفسه، يعاني قطاع غزة المحاصر من انقطاع التيار الكهربائي لفتراتٍ طويلة بينما يتحمل الاقتصاد الفلسطيني – ودافعو الضرائب الغربيون الذين يَحولُون دون انهياره – تكلفةً ماليةً ضخمةً. يتطرق مدير برامج الشبكة فكتور قطان في هذه المقالة إلى الجهات الفاعلة في المشروع والمبالغ التي ينطوي عليها وأسباب تعثره، ويقدم بعض التوصيات بشأن الخيارات المتاحة لكسر الجمود واستئناف العمل.
موردٌ خارج متناول اليد
أبرمت شركة الكهرباء الفلسطينية والشركة المصرية العامة للبترول اتفاقيةً في الآونة الأخيرة لاستيراد الغاز المصري عبر معبر رفح الحدودي. ويمكن لهذه الاتفاقية بعد حين أن تُغيث الغزيّين الذين ما انفكوا يعانون من نقصٍ مزمنٍ في الوقود وانقطاع التيار الكهربائي لفترات تصل إلى 18 ساعة في اليوم، وهو ما تسبب في وقوع وفيات وخسائر في القطاع الزراعي. ويمكن أن يعود الغاز بالنفع أيضًا على الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تستورد الطاقة الكهربائية من إسرائيل بأسعار مرتفعة. ولكن لماذا تحتاج السلطة الفلسطينية أصلًا لشراء الغاز واستيراده من إسرائيل ومصر بكلفة كبيرة في حين أن هناك حقلين للغاز قبالة ساحل غزة لا يزالان بلا تطوير؟
تكمن أهمية السؤال في وجود اتفاقيةٍ مبرمةٍ منذ 13 سنة بين شركة اتحاد المقاولين (Consolidated Contractors Company) وشركة الغاز البريطانية (BG Group) وصندوق الاستثمار الفلسطيني من أجل تطوير حقلي غزة واستغلالهما تجاريًا. وفي العامين 2000 و2002، خلصت الدراسات التطويرية التي أجرتها شركة الغاز البريطانية إلى أن الحقلين مجديان اقتصاديًا. وبعبارة أخرى، بوسع غزة أن تصبح من أغنى بقاع الأرض بعد أن كانت من أفقرها لو أُعطي الضوء الأخضر للبدء في استخراج هذا المورد الطبيعي الثمين القابع قبالة سواحلها واستغلاله تجاريًا.
وعلاوة على ذلك، فإن الغاز سيعود بالنفع على الشعب الفلسطيني بأسره. فيمكن مثلًا لفلسطينيي الضفة الغربية أن يستفيدوا من الغاز المتدفق من حقلي غزة في تشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية في الضفة الغربية، وصولًا إلى الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية، ممّا سيحقق وفورات كبيرة للاقتصاد. ولهذا، أشاد الرئيس الراحل ياسر عرفات في العام 1999 باكتشاف حقلي الغاز قائلًا إنهما “هبة من الله لشعبنا.” غير أنه ومنذ اكتشافهما قبل 13 سنة، لم يُستخرج منهما ولا حتى قدم مكعب واحد من الغاز. فلماذا لا يزال الغاز حبيس الأرض إذن؟ تقتضي الإجابة على هذا السؤال استعراض الاتفاقية واستعراض الفاعلين الرئيسيين المعنيين فيها، ومن ثم اقتراح خيارات على صعيد السياسات بشأن كيفية تطوير الحقلين.
كمية الغاز ومَن سيستخرجها
تضم مياه غزة الإقليمية حقلان رئيسيان للغاز هما حقل غزة البحري (Gaza Marine) وهو الحقل الرئيسي ويقع على عمق 603 أمتار تحت سطح البحر و36 كيلومترا غرب مدينة غزة. أمّا الحقل الحدودي (Border Field) فهو أصغر سعةً ويمتد عبر الحدود الدولية الفاصلة بين المياه الإقليمية لقطاع غزة والمياه الإقليمية لإسرائيل. وتقدِّر شركة الغاز البريطانية بحسب موقعها على شبكة الإنترنت حجم الاحتياطيات في الحقلين بتريليون قدم مكعب، في حين تعتقد شركة اتحاد المقاولين بأن الاحتياطي يبلغ 1.4 تريليون قدم مكعب. ولتقريب الصورة، يبلغ مخزون إيران من الغاز الطبيعي 991.6 تريليون قدم مكعب، أي أن كمية الغاز في الحقلين ليست ضخمة، ولكنها أكثر من كافية لتلبية احتياجات الفلسطينيين على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة وهو الموعد المقدَّر لنضوب مخزون الحقلين من الغاز وفقًا لمستويات الاستهلاك الحالية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
تولَّد الاهتمام في تطوير حقلي الغاز هذين عندما تقدمت شركة اتحاد المقاولين لشراء الغاز المصري من شركة الغاز البريطانية لاستخدامه في محطة الطاقة التي كانت تُشيِّدها مع شركة إنرون في غزة في منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي. وهي محطة الكهرباء الوحيدة في غزة حيث سيُرسل الغاز المصري بموجب الاتفاقية المبرمة مؤخرًا مع مصر. وفي ذلك الوقت، أخبرت شركةُ الغاز البريطانية شركةَ اتحاد المقاولين بأن هناك احتياطيات من الغاز تكمن قبالة سواحل غزة، وأنها كانت تعلم بشأنها بسبب عملياتها في سيناء. (يتركز حضور شركة الغاز البريطانية في الشرق الأوسط في الوقت الحاضر في مصر حيث تُشغِّل حقل غاز رشيد البحري وحقل غاز غرب الدلتا البحرية العميقة.)
يُعتبر الشركاء الثلاثة الذين اجتمعوا لاحقا من أجل تطوير الحقلين قبالة غزة من الرواد في مجالاتهم. فشركة الغاز البريطانية هي إحدى شركات الطاقة العملاقة في العالم، إذ تعمل في 25 بلدا وتُعتبر أكبر مورد للغاز الطبيعي المُسال للولايات المتحدة. وبالنسبة لشركة اتحاد المقاولين، فقد تأسست على يد ثلاثة رجال أعمال فلسطينيين سنة 1952، وهي أضخم شركة إنشاءات في الشرق الأوسط ويقع مقرها في اليونان. وعند إبرام اتفاقية غزة في 1999، كانت شركة اتحاد المقاولين قد شيَّدت جميع المرافق الخاصة بشركة الغاز البريطانية في كازخستان. أمّا صندوق الاستثمار الفلسطيني فقد تأسس سنة 2003 كشركة مساهمة عامة تتخذ من رام الله مقرًا لها وهي تشبه في هيكلها صناديق الثروة السيادية – إلا أنها لا تستثمر الأموال الفائضة في الأسواق الأجنبية وإنما في الموارد الفلسطينية.
منحت السلطة الفلسطينية شركة الغاز البريطانية وشريكيها في العام 1999 رخصة تنقيب تغطي كامل المنطقة البحرية الممتدة قبالة قطاع غزة. تسري صلاحية الرخصة لمدة 25 عامًا وتُعطي لشركة الغاز البريطانية، المُشغِّل، الحق في التنقيب عن حقول الغاز في هذه المنطقة البحرية، وتطوير تلك الحقول، وإقامة البنية الأساسية لخط أنابيب الغاز. وبحسب المعلومات المحدودة المتوفرة على موقع شركة الغاز البريطانية على شبكة الإنترنت، فإن الشركة “تستحوذ على نسبة 90 في المائة من حقوق الرخصة، وستنخفض هذه النسبة إلى 60 في المائة إذا مارست شركة اتحاد المقاولين [شريكها الحالي في الرخصة بنسبة 10 في المائة] وصندوق الاستثمار الفلسطيني خياراتهما عند إقرار التطوير.” وعند إقرار التطوير، اختارت شركة اتحاد المقاولين أن تستملك نسبةً تصل إلى 30 في المائة من المشروع، بحيث تتوزع عائدات بيع الغاز بين شركة الغاز البريطانية (60 في المائة) وشركة اتحاد المقاولين (30 في المائة) وصندوق الاستثمار الوطني (10 في المائة).
ومن الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية لا تمثل سوى العائدات التي سوف يتقاسمها المستثمرون الرئيسيون، حيث إن نسبة 50 في المائة من عائدات الغاز سوف تذهب إلى السلطة الفلسطينية كبدلٍ لحق التنقيب وكضرائب حتى وإنْ لم تستثمر السلطة فلسًا واحدًا في المشروع.[1] وبالإضافة إلى العائدات المباشرة التي سوف تجنيها السلطة الفلسطينية من الاستغلال التجاري لحقلي الغاز، سوف يكون بمقدور الاقتصاد الفلسطيني أن يوفِّر ما يزيد على 8 بلايين دولار من فاتورة الطاقة طِوال مدة المشروع إذا استُخدم الغاز في توليد الكهرباء في غزة والضفة الغربية. وبالطبع، سيكون من الضروري وضع تدابير للمساءلة تضمن استخدام الأموال فيما ينفع الشعب الفلسطيني. ومن المسلَّم به أن العائدات سوف تذهب إلى الخزينة الفلسطينية حيث تذهب ضرائب الاستيراد والتصدير، وحيث تودِع إسرائيل الضرائب التي تجبيها من الفلسطينيين، وحيث تذهب أموال المساعدات الأوروبية والأمريكية. ورغم أن الفلسطينيين وضعوا ضمانات لمكافحة الفساد وتلبية المعايير الدولية، فإنه لا يزال يتعين على الصحافة الفلسطينية وعامة الشعب البقاءَ متيقظين.
أنفق المستثمرون في السنوات القليلة الأولى من عمر المشروع 100 مليون دولار حيث حُفرت الآبار وأجرت شركة الغاز البريطانية دراسات تطويرية في العامين 2000 و2002. وخلصت تلك الدراسات إلى أن تطوير حقلي غزة سيكون “مجديًا اقتصاديًا وتقنيًا،” بل إن شركة اتحاد المقاولين أخبرتني أن مشروع حقل غزة البحري “مُجدٍ للغاية.”
السبب وراء توقف المشروع والثمن الذي يدفعه الفلسطينيون
لا يوجد نزاع على السيادة أو على ملكية الغاز، فهي دون شك تعود للشعب الفلسطيني بموجب القانون الدولي. وحتى إسرائيل لا تطعن في ذلك. ووفقًا لحديثٍ أجراه نبيل شعث، الذي كان وزير التخطيط والتعاون الدولي في السلطة الفلسطينية حين أُبرمت الاتفاقية سنة 1999 مع شركة الغاز البريطانية، مع إذاعة فلسطين: “يعترف الإسرائيليون، بموجب اتفاق غزة – أريحا، بحقنا في السيادة الاقتصادية على رقعة تمتد 20 ميلًا (32 كيلومترًا) داخل البحر، وعلى أي موارد كامنة فيها كالنفط والغاز.” وعندما أُبرِم العقد سنة 1999، كان من المتصوَّر أن إسرائيل ستكون من المشترين الرئيسيين لغاز غزة – وهو ما ظنّه الكثيرون شرطًا إسرائيليًا مُسبقًا للسماح بتطوير الحقلين للمضي قدما في المشروع – وأن “الغاز القادم من غزة سرعان ما سيُدير محطات الطاقة الإسرائيلية وعجلة الصناعة الفلسطينية أيضًا.”[2]
استنادًا إلى المعلومات التي حصلت عليها الشبكة بموجب قانون حرية المعلومات من وزارة التنمية الدولية البريطانية فإن “شركة الغاز البريطانية حفرت بئرين سنة 2000 أثبتا وجود حقلٍ للغاز الطبيعي. ومنذ ذلك الحين، أخذت الشركة تبحث في الخيارات المختلفة المتوفرة لاستغلال هذا المورد تجاريًا، بيد أنها لم تُفلح. وكان من بينها خيارُ بيعِ الغاز لمحطات توليد الطاقة الإسرائيلية الحكومية والخاصة، وتصدير الغاز إلى مصر ومن ثم إلى الأسواق العالمية. وفي عام 2006، تدخلت الحكومة الإسرائيلية لدى حكومة صاحبة الجلالة لإقناع شركة الغاز البريطانية باستئناف المفاوضات مع إسرائيل. غير أن الشركة انسحبت في كانون الأول/ديسمبر 2007 من تلك المفاوضات. ومنذ ذلك الحين، لم يطرأ أي تقدم على صعيد تطوير حقل غزة البحري.”
وما لا تكشفه المعلومات المقدمة من وزارة التنمية الدولية البريطانية هو أن السبب الرئيس وراء فشل المفاوضات يرجع إلى إصرار إسرائيل على شراء الغاز من غزة بأسعار تقل عن قيمته السوقية. فقد أرادت إسرائيل أن تتفاوض على عقدٍ تدفع بموجبه دولارين فقط لكل قدم مكعب وليس 5 إلى 7 دولارات كما هو سعره في السوق. وبحسب ما أعلمني به مصدر مُطلّع في شركة اتحاد المقاولين فإن “أضخم مورد في فلسطين متعثر بسبب الإسرائيليين. وإذا حصل انفراج على هذا الصعيد، فإن من شأنه أن يقلل المعونة التي تحصل عليها السلطة الفلسطينية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.”
ووفقًا لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في صندوق الاستثمار الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، فإن كلفة فاتورة الطاقة المستهلكة في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي كلفة باهظة، حيث تعتبر تكاليف المشتقات النفطية والكهرباء من أكبر نفقات السلطة الفلسطينية لأن 98 في المائة من كهرباء الضفة الغربية تأتي من إسرائيل. وكان الوضع مشابهًا في غزة قبل أن تشيِّد شركة اتحاد المقاولين محطة توليد الكهرباء (استحوذت شركة اتحاد المقاولين على حصة شركة إنرون في المشروع والبالغة 50 في المائة عند إفلاس إنرون). وتشير شركة اتحاد المقاولين إلى أن الجميع يَذكر بأن “نصف غزة كان يعيش بلا كهرباء قبل بناء محطة توليد الطاقة الكهربائية في العام 1999.”
يُكلِّف تطوير حقل غزة البحري 800 مليون دولار كما وضّح الدكتور محمد. وليس هناك أي شركة طاقة ترضى أن تلتزم بهذا المبلغ ما لم تعثر على مشترٍ يوافق على إبرام عقدٍ طويل الأجل يتحدد سعر الغاز فيه بموجب قيمته السوقية، لأنه لا بد من بيع الغاز ونقله لوجهاته النهائية حال استخراجه. أمّا كمية الغاز المخصصة للسوق الفلسطيني فتُنقل عبر الأنابيب إلى محطة توليد الكهرباء القائمة في قطاع وغزة وإلى محطة توليد الكهرباء المزمع إنشاؤها في الضفة الغربية. وأمّا الغاز الفائض المخصص للتصدير، فيُنقل عبر خط أنابيب إلى محطة معالجة برية حيث يخضع للضغط والتبريد إلى أن يتكثف ويصبح غازًا طبيعيًا مُسالًا. وعندما يتحول إلى غازٍ طبيعي مُسال فإنه يُشحن على متن الناقلات إلى الأسواق الأجنبية. ويسترد المستثمرون الأموال التي استثمروها بالأساس بُغية تحقيق الأرباح.
وبحسب شركة اتحاد المقاولين، فإن التدبير الأنسب هو نقل الغاز بالأنابيب إلى العريش في مصر حيث توجد بالفعل محطتان للغاز الطبيعي المسال تملكهما شركة الغاز البريطانية وشركة أجيب الإيطالية وشركة يونيون فينوسا الإسبانية. وهناك يُصار تبريده حتى الإسالة ليُصدَّر بعدها إلى اليابان وكوريا بموجب عقودٍ طويلة الأجل. ولقد أخبرني مصدرٌ في شركة اتحاد المقاولين عن توقعاته بأن عقدًا من هذا القبيل يمكن أن يحقق ريعًا يصل إلى 13 دولارًا للقدم المكعب، وهو ثمنٌ يفوق بكثير ما سيُبدي الإسرائيليون والأوروبيون استعدادًا لدفعه.
ومن المزايا الأخرى لضخ الغاز بالأنابيب إلى العريش هو إمكانية نقله من هناك بكل سهولةٍ ويسر عبر خطٍ قصير من الأنابيب إلى غزة وعبر خط الأنابيب العربي إلى الضفة الغربية. فخط الأنابيب العربي قائمٌ بالفعل وهو ينقل الغاز المصري إلى الأردن. ويمكن استخدامه لنقل الغاز إلى الضفة الغربية، حيث لن يتطلب ذلك سوى إنشاء خط أنابيبٍ قصيرٍ من الأردن إلى الضفة الغربية.
لكن حتى وإنْ وافق مشترٍ مستحقُ الائتمان على توقيع عقد، فسيظل يتعين على المطورين الحصولُ على موافقةٍ أمنيةٍ وسياسيةٍ من إسرائيل من أجل تصدير الغاز، وهو ما رفضته الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ العام 2000. وبذلك تفرض إسرائيل على المطورين خيارين لا ثالث لهما يرقيان إلى درجة الابتزاز: فهم إمّا يوافقون على بيع الغاز لإسرائيل بأقل من سعر السوق أو لا يبيعونه أبدًا. وفي هذا الصدد، صرّح نبيل شعث في حديثه لصحيفة الأيام (7 حزيران/يونيو 2000) بأن “هناك رغبةً لدى الجانب الإسرائيلي في مصادرة غاز الفلسطينيين الكامن في جوف المنطقة الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، ولكننا سنتصدى لتلك المحاولات. فنحن لدينا الدليل القانوني الذي يُثبت حقنا ونحظى بدعم الحكومة البريطانية التي هي شريكنا في مشروع الغاز.” وبالرغم من هذا الدعم المزعوم، فإن المشروع لا يزال متوقفًا.
ظلت إسرائيل لغاية العام 2009 تعتبر حقلي الغاز قبالة غزة أساسيين لضمان أمن الطاقة فيها رغم أنها اكتشفت حقول غاز يام تيثيس بالتزامن تقريبًا مع اكتشاف حقلي غزة، وذلك لأن حقول يام تيثيس كانت تقترب من النضوب. ومنذ العام 2009، اكتشفت إسرائيل وجود كميات ضخمة من الغاز في حقلي تمار وليفياثان، حيث يضم حقل تمار نحو 9 تريليون قدم مكعب من الغاز، وهو حاليًا قيد التطوير ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز بحلول 2013. وسوف يوفر هذا الحقل ما يكفي من الغاز لسد احتياجات إسرائيل على مدى الأعوام الخمسة والعشرين المقبلة. أمّا حقل ليفياثان فيحوي كميات أكبر من الغاز (حوالي 17 تريليون قدم مكعب) ولكنه أكثر بُعدًا من الساحل الإسرائيلي وتكلفة تطويره أكبرُ بكثير مقارنةً بحقل تمار. لذا، ليست هناك خطة واضحة المعالم لتطوير حقل ليفياثان، ولكنه في حال تطويره سوف يحوِّل إسرئيل إلى مُصدِّرٍ صافٍ للغاز. وهكذا، فإن إسرائيل تملك ما يكفيها من الغاز وليست بحاجة لأنْ تطمع في حقلي غزة. فالتفسير الوحيد إذن هو أن إسرائيل ماضيةٌ في الحيلولة دون تطوير حقلي الغاز كجزءٍ من الحصار الذي تفرضه على قطاع غزة.
تدابير مضادة في جعبة منظمة التحرير الفلسطينية/السلطة الفلسطينية
يقول مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية إن السلطة طلبت مرارًا وتكرارًا من رئيس الوزارء البريطاني السابق توني بلير بصفته الممثل الخاص للجنة الرباعية أن يحصل على التزامٍ من إسرائيل يُمكِّن ائتلاف الشركات من تطوير حقلي الغاز في غزة.[3] وفي شباط/فبراير، اقترحت الرباعية سلسلةً من التدابير لتخفيف القيود الإسرائيلية على الفلسطينيين من أجل استئناف محادثات السلام المتوقفة. وعلى ما يبدو أن التدابير تضمنت إعطاء الضوء الأخضر للسلطة الفلسطينية لاستغلال احتياطيات الغاز (تقرير لوكالة معًا الإخبارية، 3 شباط/فبراير 2012).
ومع ذلك، ظلت محادثات السلام متوقفة لتاريخه – مثلما ظل مشروع تطوير حقلي الغاز. وإذا استمرت إسرائيل في إحباط الجهود المبذولة لتطوير حقلي الغاز، فثمة خيارات عديدة قد ترغب منظمة التحرير الفلسطينية/السلطة الفلسطينية في دراستها. فيمكنها مثلًا إثارة قضية الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة في إطار الأمم المتحدة وبيان الأثر الذي يخلفه الحصار على مياه القطاع الإقليمية وعلى الفلسطينيين في غزة، وذلك إذا عادت السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة في سياق استراتيجيتها الساعية للانضمام إلى الأمم المتحدة كدولةٍ عضو. وسيكون الطرح قائمًا على المبدأ الأساسي المتمثل في أحقية كل دولةٍ بممارسة سيادتها على أراضيها ومياهها الإقليمية. وبما أن حقلي الغاز يقعان ضمن المياه الإقليمية الفلسطينية، وهو أمرٌ لا تنازعه إسرائيل، فإن للفلسطينيين الحق في تطويرهما والاستفادة منهما تجاريًا.
ينص القانون الدولي على أحقية كل دولة لها خط ساحلي في امتلاك منطقةٍ اقتصاديةٍ خالصةٍ تمتد حتى 200 ميل بحري انطلاقًا من خط الأساس، بحيث تتمتع الدولة الساحلية بحقوقٍ حصريةٍ في استخدام الموارد الطبيعية المتواجدة في منطقتها الاقتصادية الخالصة.[4] وهكذا، فإن من الإجراءات الفعالة التي يمكن لفلسطين أن تنتهجها، إلى جانب الانضمام إلى منظمات دولية أخرى مثل اليونسكو، أن تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
يمكن لمنظمة التحرير الفلسطينية/السلطة الفلسطينية أيضًا أن تثير القضية في الجمعية العامة للأمم المتحدة على شكل مشروع قرار يدعو إسرائيل إلى التخلي عن سيطرتها على المياه الفلسطينية الإقليمية، ويدعو الدول الأخرى إلى الامتناع عن مساعدة إسرائيل في تطوير حقولها الغازية حتى تحترم إسرائيل الاتفاقات التي أبرمتها مع السلطة الفلسطينية في سنوات أوسلو ومع ائتلاف شركات تطوير حقلي الغاز في العام 1999. ومن شأن ذلكٍ أن يولِّد شيئًا من الزخم الدولي اللازم من أجل الضغط على إسرائيل لتتوقف عن عرقلة تطوير هذين الحقلين. وربما ستنظر الجمعية العامة في اتخاذ تدابير مضادة إذا واصلت إسرائيل حصارها، ولا سيما إذا ما علمنا أن الغاز الطبيعي لا يكون سلعةً مفيدةً إلا إذا كانت هناك دولٌ أخرى مستعدةٌ لشرائه. إن ممارسة الضغط على هذا النحو قد تكون الإجراء الأنسب لمجابهة إسرائيل في سياق السعي من أجل تحقيق المصير ونيل الحرية والعدالة والمساواة، إذا ما أُريد لحقلي الغاز أن يكونا نعمةً للفلسطينيين لا نقمةً عليهم.
[1] تتماشى الاتفاقية مع الاتفاقيات المبرمة مع شركات الطاقة في بقاع أخرى من العالم حيث جرت العادة أن تُقسَم الأرباح المتأتية من استغلال الموارد الطبيعية مناصفةً مع الشريك المضيف.
[2] أفاد تقريرٌ نشرته صحيفة ذي تايمز (“Arafat lights flame for BG gas find” 28 أيلول/سبتمبر، 2000، صفحة 32) بأن شركة الغاز البريطانية قد أبرمت اتفاقات مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
[3] يُفترض بمكتب ممثل اللجنة الرباعية أن “يبني المؤسسات والاقتصاد لدولة فلسطينية مستقبلية،” http://www.quartetrep.org/quartet/pages/about-oqr/. وقد تقدمت بطلبات عديدة لمكتب توني بلير في لندن للاستفسار عن هذه الالتزامات ولكن جاء الرد بأن السيد بلير مشغولٌ جدًا ولا وقت لديه للرد.
[4] أكدت محكمة العدل الدولية في قضية الجرف القاري بين ليبيا ومالطا (1985) أن المنطقة الاقتصادية الخاصة أصبحت جزءًا من القانون الدولي العرفي. انظر
R.R. Churchill and A.V. Lowe, The Law of the Sea (Manchester: Manchester University Press, 1999), pp. 160-161